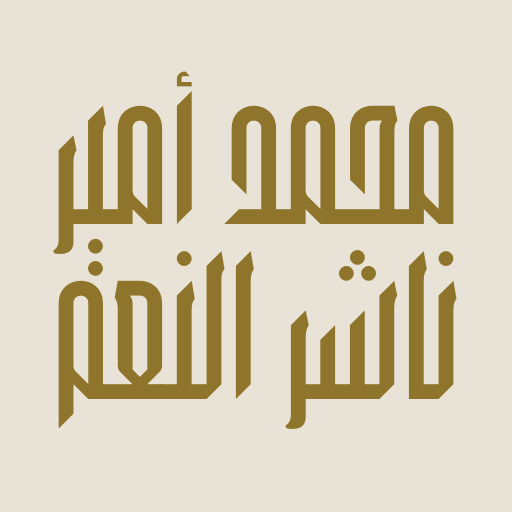الرافعي قمر.
قمر الإنشاء الأدبي الكلاسيكي في لغة العرب في العصر
الحديث.
الحديث.
رآه محبوه بدراً مكتملاً منيراً في كبد سماء البلاغة
العربية والأدب العربي المعاصر، ورآه منتقدوه عرجوناً قديماً. عيناه في خلف رأسه
يرى الماضي ولا يرى الحاضر فضلاً عن المستقبل، ولكن لم يرَ كلاهما (المعجَب
والمنتقد) وجهه الآخر المعتم، وجانبه الثاني المظلم! هذا الجانب الذي سيُكشف عنه لأول مرة، علماً أنّه جانب
مبذول متاح! لا يحتاج اكتشافه إلا لأن يفتح المرء عينه وأذنه وعقله، فلا ينظر بعين
مغضية، ولا يسمع بأذن مجّاجة، ولا يعي بعقل متخرّق.
العربية والأدب العربي المعاصر، ورآه منتقدوه عرجوناً قديماً. عيناه في خلف رأسه
يرى الماضي ولا يرى الحاضر فضلاً عن المستقبل، ولكن لم يرَ كلاهما (المعجَب
والمنتقد) وجهه الآخر المعتم، وجانبه الثاني المظلم! هذا الجانب الذي سيُكشف عنه لأول مرة، علماً أنّه جانب
مبذول متاح! لا يحتاج اكتشافه إلا لأن يفتح المرء عينه وأذنه وعقله، فلا ينظر بعين
مغضية، ولا يسمع بأذن مجّاجة، ولا يعي بعقل متخرّق.
أستطيع أن أزعم أنّني من أكثر الناس درايةً بالرافعي
بسبب العادة التي ألزمت بها نفسي مذ كنتُ طالباً في السنة الجامعية الأولى، وهي
قراءة أعمال الكاتب ــ إذا أعجبني ــ دفعةً واحدة بحيث أحيط بأفكاره وأقطاره،
فأرقب ثباته على وثباته، أو اطراده في ارتقائه، أو ارتكاسه في انتكاسه. وكانت
نتيجة سياحتي في كتبه ومؤلفاته ما كتبته مرةً: “إذا استطعنا تشخيص أمراض مصطفى صادق الرافعي السيكولوجية،
والكشف عن تهوساته، بلا إفراط ولا تفريط، ولا غمطه حقّه، ولا هضمه قيمته فسوف نضع أيدينا
في الوقت ذاته على معظم أمراضنا وتهوّساتنا نحن المتدينين، حيث لم نغرم بالرافعي
إلا للمشاكلة النفسية التي جمعتنا به ووحّدتنا معه”.
بسبب العادة التي ألزمت بها نفسي مذ كنتُ طالباً في السنة الجامعية الأولى، وهي
قراءة أعمال الكاتب ــ إذا أعجبني ــ دفعةً واحدة بحيث أحيط بأفكاره وأقطاره،
فأرقب ثباته على وثباته، أو اطراده في ارتقائه، أو ارتكاسه في انتكاسه. وكانت
نتيجة سياحتي في كتبه ومؤلفاته ما كتبته مرةً: “إذا استطعنا تشخيص أمراض مصطفى صادق الرافعي السيكولوجية،
والكشف عن تهوساته، بلا إفراط ولا تفريط، ولا غمطه حقّه، ولا هضمه قيمته فسوف نضع أيدينا
في الوقت ذاته على معظم أمراضنا وتهوّساتنا نحن المتدينين، حيث لم نغرم بالرافعي
إلا للمشاكلة النفسية التي جمعتنا به ووحّدتنا معه”.
في البدء كان التعاظم:
والتعاظم كان طموحاً مستعجلاً نافد الصبر، وتلهفاً غير
محدود لنيل الاعتراف والإطراء لشابٍّ لم يتخطَّ العشرين يحلم، في لحظته تلك، بالتربّع
في أعلى درج الاستحقاق من دون استحقاق! إذ لم يكن مصطفى صادق الرافعي (1880 ــ 1937) في بداية حبوه الأدبي على بيّنة من جنسه
الأدبي اللائق به، فظنّ نفسه في ناشئة أمره شاعراً، وأنّ رسالته الأدبية في الشعر،
فبدأ ينظمه وهو دون سن العشرين، وكانت محاولاته الأولى غير ذات قيمة أو أثر، فكتب
مسرحية شعرية بعنوان (رواية حسام الدين الأندلسي)، و”هي رواية تشخيصية أدبية
غرامية حماسية ذات ستة فصول”، ولكنها لم تلفت النظر إليها، ولم تنل أي اعتبار
رغم تكرار طبعه لها بين عامي 1896 و1905، ولذلك فقد
طواها النسيان، وباتت من أعماله المجهولة التي لم يعرفها أحد إلى أن كشف عنها سنة 2006 الباحث مصطفى يعقوب عبد النبي في مقال له في مجلة جذور عدد /23/ بعنوان: (مسرحية
مجهولة لمصطفى صادق الرافعي).
محدود لنيل الاعتراف والإطراء لشابٍّ لم يتخطَّ العشرين يحلم، في لحظته تلك، بالتربّع
في أعلى درج الاستحقاق من دون استحقاق! إذ لم يكن مصطفى صادق الرافعي (1880 ــ 1937) في بداية حبوه الأدبي على بيّنة من جنسه
الأدبي اللائق به، فظنّ نفسه في ناشئة أمره شاعراً، وأنّ رسالته الأدبية في الشعر،
فبدأ ينظمه وهو دون سن العشرين، وكانت محاولاته الأولى غير ذات قيمة أو أثر، فكتب
مسرحية شعرية بعنوان (رواية حسام الدين الأندلسي)، و”هي رواية تشخيصية أدبية
غرامية حماسية ذات ستة فصول”، ولكنها لم تلفت النظر إليها، ولم تنل أي اعتبار
رغم تكرار طبعه لها بين عامي 1896 و1905، ولذلك فقد
طواها النسيان، وباتت من أعماله المجهولة التي لم يعرفها أحد إلى أن كشف عنها سنة 2006 الباحث مصطفى يعقوب عبد النبي في مقال له في مجلة جذور عدد /23/ بعنوان: (مسرحية
مجهولة لمصطفى صادق الرافعي).
وبعد هذه المسرحية على مدار سنتين أو ثلاث تجمع لديه عدد
من القصائد التي نظمها، فطبعها سنة 1323 هـ والتي توافق سنة 1906 أو 1907م باسم (ديوان الرافعي) الجزء الأول، ولأنه كان في غاية
الاستعجال لإبراز شاعريته الخلاّقة، وعظمته الأدبية المبدعة، فإنّه لم ينتظر رأي
الجمهور والأدباء والنقّاد، بل بادر لتلقيمهم قيمة هذا الشعر، ومواطن فرادته من
خلال شرح الديوان في الطبعة ذاتها! وبلا معوِّقاتٍ من ضميره نسب الشرح زوراً وكذباً
لأخيه محمد كامل الرافعي، ليتسنى له باسم الشارح أن يكيل المديح لنفسه، من دون أن
يحرج نفسه، ومن دون أن يقيم أدنى اعتبار أخلاقي إلى أن خطوته الأولى في عالم الأدب
هي تعثّره الأول في عالم الأخلاق. يحدثنا خازن أسراره وأمين سيرة حياته محمد سعيد
العريان في كتابه (حياة الرافعي) فيقول: “شرح الرافعي الأجزاء الثلاثة من
ديوانه، ولكنه لسبب ما نسب الشرح إلى أخيه المرحوم محمد كامل الرافعي، وهو من باب
الدعاية التي كان يدعوها لنفسه”. (حياة الرافعي، ص 83). ويذكرنا هذا الانتحال بصنيع الشاعر أبو شادي حين كتب
كتاباً بالإنكليزية عن نفسه يطري ذاته ويمدحها، ونشره باسم إسماعيل أدهم، كما
بيّنا ذلك في مقالنا السابق عن (إسماعيل أدهم).
من القصائد التي نظمها، فطبعها سنة 1323 هـ والتي توافق سنة 1906 أو 1907م باسم (ديوان الرافعي) الجزء الأول، ولأنه كان في غاية
الاستعجال لإبراز شاعريته الخلاّقة، وعظمته الأدبية المبدعة، فإنّه لم ينتظر رأي
الجمهور والأدباء والنقّاد، بل بادر لتلقيمهم قيمة هذا الشعر، ومواطن فرادته من
خلال شرح الديوان في الطبعة ذاتها! وبلا معوِّقاتٍ من ضميره نسب الشرح زوراً وكذباً
لأخيه محمد كامل الرافعي، ليتسنى له باسم الشارح أن يكيل المديح لنفسه، من دون أن
يحرج نفسه، ومن دون أن يقيم أدنى اعتبار أخلاقي إلى أن خطوته الأولى في عالم الأدب
هي تعثّره الأول في عالم الأخلاق. يحدثنا خازن أسراره وأمين سيرة حياته محمد سعيد
العريان في كتابه (حياة الرافعي) فيقول: “شرح الرافعي الأجزاء الثلاثة من
ديوانه، ولكنه لسبب ما نسب الشرح إلى أخيه المرحوم محمد كامل الرافعي، وهو من باب
الدعاية التي كان يدعوها لنفسه”. (حياة الرافعي، ص 83). ويذكرنا هذا الانتحال بصنيع الشاعر أبو شادي حين كتب
كتاباً بالإنكليزية عن نفسه يطري ذاته ويمدحها، ونشره باسم إسماعيل أدهم، كما
بيّنا ذلك في مقالنا السابق عن (إسماعيل أدهم).
ولئن كان من الطبيعي أن يحب الأديب تحقيق الشهرة
لأعماله، وأن يأمل في الثناء عليها، بعد أن يثبت نفسه في ديوان الإبداع بمصداقية
وجدارة، فإنه من المستغرب أن يبتدئ المرء حياته الأدبية، في أول خطواته وهو يرسف
في أغلال تمجيد ذاته، مزهواً بنفسه، مشحوناً بالخيلاء، فهذا هو الداء العياء!
الداء الذي رافق الرافعي في مراحل حياته كلها إلى أن لقي وجه ربه سنة 1937م.
لأعماله، وأن يأمل في الثناء عليها، بعد أن يثبت نفسه في ديوان الإبداع بمصداقية
وجدارة، فإنه من المستغرب أن يبتدئ المرء حياته الأدبية، في أول خطواته وهو يرسف
في أغلال تمجيد ذاته، مزهواً بنفسه، مشحوناً بالخيلاء، فهذا هو الداء العياء!
الداء الذي رافق الرافعي في مراحل حياته كلها إلى أن لقي وجه ربه سنة 1937م.
وفي هذا الشرح سنجد الشارح، من فرط فتنته بشعره، مكبِراً
نفسه، ومندهشاً منها، ثم زاهياً بها، فطروباً ومهتزاً، وسنرى أنه ابتغاء إعلاء شأن
نفسه، سيقترف الشواهد والأقوال بكل استهتار واستخفاف.
نفسه، ومندهشاً منها، ثم زاهياً بها، فطروباً ومهتزاً، وسنرى أنه ابتغاء إعلاء شأن
نفسه، سيقترف الشواهد والأقوال بكل استهتار واستخفاف.
يبتدئ الديوان بعشر قصائد مكتوبة للأطفال، من دون أن يكون
فيها من روح الأطفال، ولا من موسيقى شعر الأطفال شيء! ومع ذلك يرى الشارح أن الناس
قبل هذا الديوان كانوا في حالة تيمّم (أما وقد ظهر هذا الديوان فقد بطل التيمم
عند الماء) (ديوان الرافعي،
ج 1، ص 15)! علماً أنّ أحمد شوقي (1868 ــ 1932) كان قد أصدر ديوان (الشوقيات) في طبعته
الأولى سنة 1898، وكان فيه باب للحكايات والقصص الشعرية
للأطفال لا يمكن أن تدانيها قصائد الرافعي معنى ومبنى على الإطلاق، وعلماً أنّ
محمد عثمان جلال (1828 ــ 1889) كان قد عبّد الطريق لشعر الأطفال بما ترجمه وعرّبه من أساطير لافونتين في
ديوانه (العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ) المنشور سنة 1880وهي
السنة التي ولد فيها الرافعي،
ثم يشرع الشارح الذي هو الناظم نفسه فيمسك بيدنا ويضعها على مواطن التمثيل البديع،
فلا تكاد تخلو صفحة من هذه المواطن (ومثّل لذلك بهذا التمثيل البديع)، و(احتجاج
صاحبنا [يعني نفسه] على أنه واحد الشعراء بهذا البيت من أبدع ما يُسمع)،
(ولم يُسبق شاعرنا إليه فيما نعلم)، (إشارة بديعة)، (هذا البيت مما لم
يُسبق إليه الشاعر)، (وقد أنزل الشاعر هذه الكلمات في أحسن منازلها، واستعملها في
ألطف المعاني وأكملها، فكانت الطرب، أو هي أم الطرب)، و(من حق هذه القصيدة
أن تُكتب ولو بجمرات الرصاص على ألواح الصدور)(ج1، ص71)!! ويقول معلقاً على البيت التالي:
فيها من روح الأطفال، ولا من موسيقى شعر الأطفال شيء! ومع ذلك يرى الشارح أن الناس
قبل هذا الديوان كانوا في حالة تيمّم (أما وقد ظهر هذا الديوان فقد بطل التيمم
عند الماء) (ديوان الرافعي،
ج 1، ص 15)! علماً أنّ أحمد شوقي (1868 ــ 1932) كان قد أصدر ديوان (الشوقيات) في طبعته
الأولى سنة 1898، وكان فيه باب للحكايات والقصص الشعرية
للأطفال لا يمكن أن تدانيها قصائد الرافعي معنى ومبنى على الإطلاق، وعلماً أنّ
محمد عثمان جلال (1828 ــ 1889) كان قد عبّد الطريق لشعر الأطفال بما ترجمه وعرّبه من أساطير لافونتين في
ديوانه (العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ) المنشور سنة 1880وهي
السنة التي ولد فيها الرافعي،
ثم يشرع الشارح الذي هو الناظم نفسه فيمسك بيدنا ويضعها على مواطن التمثيل البديع،
فلا تكاد تخلو صفحة من هذه المواطن (ومثّل لذلك بهذا التمثيل البديع)، و(احتجاج
صاحبنا [يعني نفسه] على أنه واحد الشعراء بهذا البيت من أبدع ما يُسمع)،
(ولم يُسبق شاعرنا إليه فيما نعلم)، (إشارة بديعة)، (هذا البيت مما لم
يُسبق إليه الشاعر)، (وقد أنزل الشاعر هذه الكلمات في أحسن منازلها، واستعملها في
ألطف المعاني وأكملها، فكانت الطرب، أو هي أم الطرب)، و(من حق هذه القصيدة
أن تُكتب ولو بجمرات الرصاص على ألواح الصدور)(ج1، ص71)!! ويقول معلقاً على البيت التالي:
سأفعل فعل
أجدادي فإما كما نالوا، وإما حيث صاروا
أجدادي فإما كما نالوا، وإما حيث صاروا
: (ليت هذه الكلمة تُنقش في أفئدة النشء المصري ولو
بأطراف السكاكين)(ج2، ص 28)، وفعلاً ما
ينقضي عجبي من هذا الذوق في التنويه بأهمية هذه الأبيات، حتى لكأنك تخال قائلها
جلاداً، وليس شاعراً مرهف الحس مرهف النفس!! هلاّ قلعنا أظافر النشء أيضاً ونحن
ننقش هذا البيت في أفئدتهم بأطراف السكاكين أو ونحن نكتب بيتاً آخر بجمرات الرصاص
على ألواح صدور الأطفال!! رحماك يا إلهي!
بأطراف السكاكين)(ج2، ص 28)، وفعلاً ما
ينقضي عجبي من هذا الذوق في التنويه بأهمية هذه الأبيات، حتى لكأنك تخال قائلها
جلاداً، وليس شاعراً مرهف الحس مرهف النفس!! هلاّ قلعنا أظافر النشء أيضاً ونحن
ننقش هذا البيت في أفئدتهم بأطراف السكاكين أو ونحن نكتب بيتاً آخر بجمرات الرصاص
على ألواح صدور الأطفال!! رحماك يا إلهي!
وفي غمرة حجه لنفسه، يصل إلى درك لا يمكن وصفه إلا
باضمحلال الرزانة والاحتشام حين يقول: (لو شئنا أن نشير إلى مبتكرات المعاني في كل
مواضعها من هذا الجزء لما خلت صحيفة من ذلك، ولخفنا ملل القراء، ولكننا نريد على
كل حال أن يتعلم أدباؤنا كيف يكون الابتكار لعل الشعر يطهر ولو من الحدث الأصغر).
باضمحلال الرزانة والاحتشام حين يقول: (لو شئنا أن نشير إلى مبتكرات المعاني في كل
مواضعها من هذا الجزء لما خلت صحيفة من ذلك، ولخفنا ملل القراء، ولكننا نريد على
كل حال أن يتعلم أدباؤنا كيف يكون الابتكار لعل الشعر يطهر ولو من الحدث الأصغر).
كل ما سبق يحكي أعراض الشعور بالعظمة، الذي تسخَّر له كل
الوسائل والسبل للتدليل عليها ولتسويقها وتثبيتها، ولا بأس عندئذ بإنطاق الأحياء
والأموات في تأكيد هذه العظمة وفي كشفها وإبرازها. يقول: (ومن اللطائف أن كاتباً
شهيراً قال لشاعرنا مرة: إن خمسة وتسعين من كل مئة قارئ لا يُفضون إلى هذه
الحقائق! فأجابه الشاعر بهذه الكلمة الحكيمة: أوليس خيراً للناس أن يرتقوا
إليّ من أن أنزل إليهم) (ج2، 12)، ولا شك
عندي في أن هذا الكاتب الشهير هو شاعرنا نفسه، الذي ينطق بالكلمات الحكيمات،
والحكم الخالدات!!
الوسائل والسبل للتدليل عليها ولتسويقها وتثبيتها، ولا بأس عندئذ بإنطاق الأحياء
والأموات في تأكيد هذه العظمة وفي كشفها وإبرازها. يقول: (ومن اللطائف أن كاتباً
شهيراً قال لشاعرنا مرة: إن خمسة وتسعين من كل مئة قارئ لا يُفضون إلى هذه
الحقائق! فأجابه الشاعر بهذه الكلمة الحكيمة: أوليس خيراً للناس أن يرتقوا
إليّ من أن أنزل إليهم) (ج2، 12)، ولا شك
عندي في أن هذا الكاتب الشهير هو شاعرنا نفسه، الذي ينطق بالكلمات الحكيمات،
والحكم الخالدات!!
ويقول أيضاً:
وسيّان البصير
وكل أعمى إذا نظرا إلى شيء بعيد
وكل أعمى إذا نظرا إلى شيء بعيد
ويشرح: (وقد قال بعض كبار الكتّاب العلماء عندما
قرأ هذا البيت: أشهد أن المعري لم يقل أحسن منه في زمنه) (ج2، ص30).
قرأ هذا البيت: أشهد أن المعري لم يقل أحسن منه في زمنه) (ج2، ص30).
ويقول:
وصيغ شبابهم
ذهباً أليست على الدينار زخرفة الشباب
ذهباً أليست على الدينار زخرفة الشباب
ويشرح: (ما ينقضي عجب الناس من هذا البيت ولا ينقضي)
(ج2، ص26). وهكذا نرى إحالات إلى مجهولين مفتونين لا ينقضي عجبهم، من العلماء
تارةً، ومن عامة الناس تارة أخرى.
(ج2، ص26). وهكذا نرى إحالات إلى مجهولين مفتونين لا ينقضي عجبهم، من العلماء
تارةً، ومن عامة الناس تارة أخرى.
وفي الجزء الثاني من الديوان يقول في مقدمته: (طلع ذلك
الجزء على الناس فجاءة، وله تلك المقدمة التي لم يمترِ أحد في أنها فصل الخطاب
في الشعر والشعراء، حتى خاطبه بعض أمراء القلم في هذا الأمر فقال له:
“شاعر الحسن“) (ج2، ص 12)، لكن الله
كبير، فقد نسي الرافعي أنه هو من سوّق لنفسه بأنه “شاعر الحسن“، وظن
أن القارئ سينسى ما كتبه عن نفسه في الجزء الأول من الديوان: (لا بدّ أن يُلقب
صاحبنا بعد اليوم بـ “شاعر الحسن“) (ج1، ص68)، فهو الذي يقترح الألقاب لنفسه، وهو الذي يسوِّقها!! وهو الذي
يفرضها ويعمّمها.
الجزء على الناس فجاءة، وله تلك المقدمة التي لم يمترِ أحد في أنها فصل الخطاب
في الشعر والشعراء، حتى خاطبه بعض أمراء القلم في هذا الأمر فقال له:
“شاعر الحسن“) (ج2، ص 12)، لكن الله
كبير، فقد نسي الرافعي أنه هو من سوّق لنفسه بأنه “شاعر الحسن“، وظن
أن القارئ سينسى ما كتبه عن نفسه في الجزء الأول من الديوان: (لا بدّ أن يُلقب
صاحبنا بعد اليوم بـ “شاعر الحسن“) (ج1، ص68)، فهو الذي يقترح الألقاب لنفسه، وهو الذي يسوِّقها!! وهو الذي
يفرضها ويعمّمها.
ولكي يقنعنا الرافعي أن غرض الشارح معرفي بحت، وليس مجرد
إبهارنا بمبتكراته البديعة، وتفرداته التي لم يُسبق إليها، فقد قام بشرح بعض
المفردات الواردة في أشعاره، وكشفت اختياراته في انتقاء المفردات التي شرحها عن
عبثية استعراضية مدهشة لم يعهد الأدب العربي في تاريخه من نظير لها! وهذا أنموذج
من هذا الشرح، ومن تلك المفردات:
إبهارنا بمبتكراته البديعة، وتفرداته التي لم يُسبق إليها، فقد قام بشرح بعض
المفردات الواردة في أشعاره، وكشفت اختياراته في انتقاء المفردات التي شرحها عن
عبثية استعراضية مدهشة لم يعهد الأدب العربي في تاريخه من نظير لها! وهذا أنموذج
من هذا الشرح، ومن تلك المفردات:
ــ لندن: عاصمة البلاد الإنكليزية.
ــ الأجواء: جمع جو.
ــ الإفك: الكذب.
ــ نيسان: من الشهور الرومية.
ــ الناصعة: شديدة البياض.
ــ الفجر: عند العلماء فجران كاذب وصادق.
ــ انفتل عن موضعه: انحرف.
ــ تصعلك: صار صعلوكاً.
ــ الناسك: الزاهد.
الدِّلاء: جمع دلو.
ــ المرّيخ: أحد الكواكب.
ــ النيل: نهر مصر.
ــ ابن السبيل: ابن الطريق. إلخ… إلخ… إلخ.
وحقيقة لو جرّدنا تاريخ الأدب العربي كله فلن نجد فهاهة
كهذه الفهاهة، أو تكلفاً يضاهي هذا التكلف الذي يضرب معلناً عن نفسه بالطبل
والمزمار.
كهذه الفهاهة، أو تكلفاً يضاهي هذا التكلف الذي يضرب معلناً عن نفسه بالطبل
والمزمار.
أخيراً لنستمع إليه يصف نفسه: (ومن عادته أنه متى تكلّف
شيئاً لا يظهر فيه التكلف مطلقاً) (ج2، ص 58)، ولله در هذا الشاب الذي يصف نفسه بكل هذه
الثقة، فيحدّثنا عن عادته التي توطدت وتأكدت بحكم التتابع والاستمرار، وكأنّه يسطّر
مذكراته في خاتمة مطاف مسيرته! ويشير كل ذلك إلى أنّ الرافعي في تلك السن لم يكن (واحد
الشعراء المفلقين)، وإنما واحد المتكلّفين المنتحلين الملفّقين! فهل تاب وأناب في
قادم أيامه؟ الجواب في الجزء القادم.
شيئاً لا يظهر فيه التكلف مطلقاً) (ج2، ص 58)، ولله در هذا الشاب الذي يصف نفسه بكل هذه
الثقة، فيحدّثنا عن عادته التي توطدت وتأكدت بحكم التتابع والاستمرار، وكأنّه يسطّر
مذكراته في خاتمة مطاف مسيرته! ويشير كل ذلك إلى أنّ الرافعي في تلك السن لم يكن (واحد
الشعراء المفلقين)، وإنما واحد المتكلّفين المنتحلين الملفّقين! فهل تاب وأناب في
قادم أيامه؟ الجواب في الجزء القادم.
وإنّ الجزء الثاني لناظره قريب.
(يتبع)
محمد أمير ناشر النعم
المصدر: https://www.syria.tv/content/الجانب-الآخر-لمصطفى-صادق-الرافعي-0