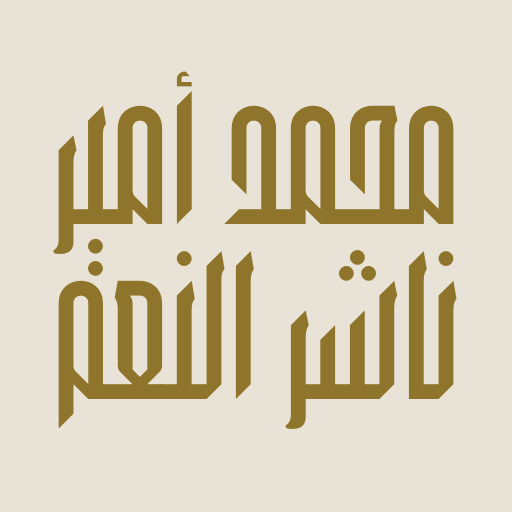كما أنّنا نعاني من ويلات خلط السياسة
كما أنّنا نعاني من ويلات خلط السياسةبالدين، فإنّنا نعاني كذلك من خلط الأدب بالدين، وكما أنّ نقد السياسي الذي يتوسل
الدين يغدو لدى الطغمة نقداً للدين نفسه، فكذلك يغدو نقد الأديب الناطق باسم الدين
والمنافح عنه انتهاكاً وتحطيماً وانتقاصاً للدين ذاته، فلا نجرؤ على نقده في فكرةٍ بلا مؤاخذة، ولا على تناوله في موقفٍ بلا تأثّم، في حين نتناول معظم الأدباء
العاديين من خلق الله في تاريخهم الشخصي أو الأدبي أو الفكري بلا تثريب.
ومن أجل كمّ الأفواه والعقول تُخترع الحجج
الداعية للإمساك عن تناوله اختراعاً، وتُقتنص اقتناصاً، ولا سيما إذا كان من
الأموات، عندئذ تُستنزل جميع حرمات الموت وتُرمى في وجه الناقد أو المتتبِّع،
وكأنها الحجة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها! ولكن صاحب الفكر
الحر، والنفس الأبية لا يخضع لهذا الترهيب الساذج، ولا ينصاع لهذه الحجة الفارغة
الواهية.
الداعية للإمساك عن تناوله اختراعاً، وتُقتنص اقتناصاً، ولا سيما إذا كان من
الأموات، عندئذ تُستنزل جميع حرمات الموت وتُرمى في وجه الناقد أو المتتبِّع،
وكأنها الحجة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها! ولكن صاحب الفكر
الحر، والنفس الأبية لا يخضع لهذا الترهيب الساذج، ولا ينصاع لهذه الحجة الفارغة
الواهية.
وهذا ما كان من سيد قطب (1906
ــ 1966) حين خصّص عدة مقالات نشرها في مجلة الرسالة بعد سنة من وفاة
الرافعي رحمه الله، فنقد شعره ونثره، وبيّن صادم رأيه فيه.
ــ 1966) حين خصّص عدة مقالات نشرها في مجلة الرسالة بعد سنة من وفاة
الرافعي رحمه الله، فنقد شعره ونثره، وبيّن صادم رأيه فيه.
ورغم مكانة الرافعي وأهميته وسطوته الأدبية
فإنّ سيد لم يمتنع من أن ينقده نقداً فاق جميع النقّاد شراسةً وشكاسة، فأعلن، من
دون تهيّب، على الملأ في أول مقالة من سلسلة مقالاته (بين العقاد والرافعي):
“إني قرأت له أول ما قرأت كتابه (حديث القمر) فأحسست بالبغضاء له. أجل
البغضاء. فهي أصدق كلمة تعبّر عن ذلك الإحساس الذي خالجني آنذاك. […] وكنتُ
أُكره نفسي بعد ذلك على مطالعة الرافعي فتزداد كراهيةً لهذا اللون من الأدب”. (الرسالة، عدد:
251،
تاريخ: 25/أبريل/
1938)، وأعلن في
المقال نفسه: “كنتُ أشكّ في (إنسانية) هذا الرجل قبل أن أشك في قيمة أدبه،
وكنت أزعم لبعض إخواني في معرض المناقشة أنّه خواءٌ من (النفس)، وأنّ ذلك سبب
كراهيتي له، ولو أني لم أره مرةً واحدة، ولم أجلس إليه”، ولكنّه يحدثنا بعد
ذلك عن تغيّر طفيف في نظرته للرافعي: “لقد عدّلت حكمي قليلاً، وخفّت حدّته،
ولم أعد أستشعر البغض والكراهية للرجل وأدبه، ولكن بقي الأساس سليماً. كنتُ أنكر
عليه (الإنسانية) فأصبحت أنكر عليه (الطبع)، وكنت لا أجد عنده (الأدب الفني)،
فأصبحت لا أجد عنده (الأدب النفسي)”.
فإنّ سيد لم يمتنع من أن ينقده نقداً فاق جميع النقّاد شراسةً وشكاسة، فأعلن، من
دون تهيّب، على الملأ في أول مقالة من سلسلة مقالاته (بين العقاد والرافعي):
“إني قرأت له أول ما قرأت كتابه (حديث القمر) فأحسست بالبغضاء له. أجل
البغضاء. فهي أصدق كلمة تعبّر عن ذلك الإحساس الذي خالجني آنذاك. […] وكنتُ
أُكره نفسي بعد ذلك على مطالعة الرافعي فتزداد كراهيةً لهذا اللون من الأدب”. (الرسالة، عدد:
251،
تاريخ: 25/أبريل/
1938)، وأعلن في
المقال نفسه: “كنتُ أشكّ في (إنسانية) هذا الرجل قبل أن أشك في قيمة أدبه،
وكنت أزعم لبعض إخواني في معرض المناقشة أنّه خواءٌ من (النفس)، وأنّ ذلك سبب
كراهيتي له، ولو أني لم أره مرةً واحدة، ولم أجلس إليه”، ولكنّه يحدثنا بعد
ذلك عن تغيّر طفيف في نظرته للرافعي: “لقد عدّلت حكمي قليلاً، وخفّت حدّته،
ولم أعد أستشعر البغض والكراهية للرجل وأدبه، ولكن بقي الأساس سليماً. كنتُ أنكر
عليه (الإنسانية) فأصبحت أنكر عليه (الطبع)، وكنت لا أجد عنده (الأدب الفني)،
فأصبحت لا أجد عنده (الأدب النفسي)”.
وكتب سيد قطب أنّ الرافعي (أديب الذهن) لا
(أديب الطبع)، وأنّه ينقصه (القلب) المهيّأ للحب، وأنّه لا يعنيه إلا أن يصوّر
الحقائق الوقتية الصغيرة في صورة خلاّبة، فأنكر عليه هذا القول سعيد العريان،
ومحمود شاكر، فردّ عليهما سيد وأمعن في هجومه أكثر: “الرافعي أديب الذهن،
ولكنه الذهن الملتوي المعاظل المداحل الذي لا يستطيع أن يسلك أقرب طريق إلى ما
يريد، بل يتخذ الدروب والمنحنيات، ويلتف حول نفسه، ويعصر نفسه، مرة ومرة”.
(الرسالة، عدد: 255، تاريخ: 23/ مايو/ 1938). وهنا يتفق سيد قطب مع طه حسين الذي قال في كتابه (حديث
الأربعاء) عن كتاب الرافعي (رسائل الأحزان): “إنَّ كل جملة من جمل هذا
الكتاب تبعث في نفسي شعوراً قوياً مؤلماً بأن الكاتب يلدها وِلاَدَةً، وهو يقاسي في
هذه الولادة ما تقاسيه الأم من آلام الوضع“. ولكم أُعجبنا وزهونا بردّ
الرافعي الذي قال له: “هأنذا أتحداك أن تأتي بمثلها [رسائل
الأحزان] أو بفصل من مثلها.
وإن لم يكن الأمر عندك في هذا الأسلوب الشاق عليك إلا ولادة
وآلاماً من آلام الوضع كما تقول، فعليَّ نفقات القابلة والطبيبة متى وَلَدْتَ
بسلامة الله“.
لكن ما لم نعرفه ونقرأه أن رأي سيد قطب في (رسائل الأحزان) كان أشد من رأي طه حسين،
فقد كتب سيّد: “والرافعي في رسائل أحزانه يتراءى كأنّما يتمطّى في أغلال، أو
يتنزّى في وثاق، يحاول أن يتفلت من هذا وتلك، وهو يُنغض رأسه ويضرب بقدميه،
ويضرِّس أنيابه في حركات عصبية، ليخلق اللفظة بعد اللفظة، والجملة بعد الجملة،
والخاطرة بعد الخاطرة في جهد وعناء، وإنّك لتسأل بعد قراءتها: أهذه رسائل حب؟ أو
ذكرى حب؟ وأنت خليق أن تفقد فيها الإنسان قبل الفنان”. (الرسالة، عدد: 254،
تاريخ: 16/
مايو/ 1938)،
ثم يشبّهه في مقال آخر بالبهلوان فيقول: “وما زلت كلما عدت إلى قراءة شيء من
كتابة الرافعي يمتدّ بي الخيال إلى (البهلوان) الذي (يتقصّع) في مشيته، ويضع يده
في خاصرته، ويأبى أن يسير في الطريق بخطوات سهلة كما خلقه الله”. (الرسالة،
عدد: 280،
تاريخ: 14/
نوفمبر/ 1938).
(أديب الطبع)، وأنّه ينقصه (القلب) المهيّأ للحب، وأنّه لا يعنيه إلا أن يصوّر
الحقائق الوقتية الصغيرة في صورة خلاّبة، فأنكر عليه هذا القول سعيد العريان،
ومحمود شاكر، فردّ عليهما سيد وأمعن في هجومه أكثر: “الرافعي أديب الذهن،
ولكنه الذهن الملتوي المعاظل المداحل الذي لا يستطيع أن يسلك أقرب طريق إلى ما
يريد، بل يتخذ الدروب والمنحنيات، ويلتف حول نفسه، ويعصر نفسه، مرة ومرة”.
(الرسالة، عدد: 255، تاريخ: 23/ مايو/ 1938). وهنا يتفق سيد قطب مع طه حسين الذي قال في كتابه (حديث
الأربعاء) عن كتاب الرافعي (رسائل الأحزان): “إنَّ كل جملة من جمل هذا
الكتاب تبعث في نفسي شعوراً قوياً مؤلماً بأن الكاتب يلدها وِلاَدَةً، وهو يقاسي في
هذه الولادة ما تقاسيه الأم من آلام الوضع“. ولكم أُعجبنا وزهونا بردّ
الرافعي الذي قال له: “هأنذا أتحداك أن تأتي بمثلها [رسائل
الأحزان] أو بفصل من مثلها.
وإن لم يكن الأمر عندك في هذا الأسلوب الشاق عليك إلا ولادة
وآلاماً من آلام الوضع كما تقول، فعليَّ نفقات القابلة والطبيبة متى وَلَدْتَ
بسلامة الله“.
لكن ما لم نعرفه ونقرأه أن رأي سيد قطب في (رسائل الأحزان) كان أشد من رأي طه حسين،
فقد كتب سيّد: “والرافعي في رسائل أحزانه يتراءى كأنّما يتمطّى في أغلال، أو
يتنزّى في وثاق، يحاول أن يتفلت من هذا وتلك، وهو يُنغض رأسه ويضرب بقدميه،
ويضرِّس أنيابه في حركات عصبية، ليخلق اللفظة بعد اللفظة، والجملة بعد الجملة،
والخاطرة بعد الخاطرة في جهد وعناء، وإنّك لتسأل بعد قراءتها: أهذه رسائل حب؟ أو
ذكرى حب؟ وأنت خليق أن تفقد فيها الإنسان قبل الفنان”. (الرسالة، عدد: 254،
تاريخ: 16/
مايو/ 1938)،
ثم يشبّهه في مقال آخر بالبهلوان فيقول: “وما زلت كلما عدت إلى قراءة شيء من
كتابة الرافعي يمتدّ بي الخيال إلى (البهلوان) الذي (يتقصّع) في مشيته، ويضع يده
في خاصرته، ويأبى أن يسير في الطريق بخطوات سهلة كما خلقه الله”. (الرسالة،
عدد: 280،
تاريخ: 14/
نوفمبر/ 1938).
لقد نقم سيد قطب على الرافعي طريقته في نقد
خصومه، والتي تقوم على أربعة أركان:
خصومه، والتي تقوم على أربعة أركان:
1 ــ الشتائم والسباب.
2 ــ التلاعب بالصور الذهنية.
3 ــ التلاعب بالألفاظ اللغوية والوقوف بها
دون ما تشعّه في الخيال من صور طريفة.
دون ما تشعّه في الخيال من صور طريفة.
4 ــ الهروب من مواجهة النقد الصحيح إلى
المراوغة وكسب الموقف ــ في رأيه ــ بنكتة أو تهكم أو شتيمة. (الرسالة، عدد: 252، تاريخ: 2/ مايو/ 1938).
المراوغة وكسب الموقف ــ في رأيه ــ بنكتة أو تهكم أو شتيمة. (الرسالة، عدد: 252، تاريخ: 2/ مايو/ 1938).
وقد ورّث الرافعي تلامذته هذه الأركان
فرأيناها مجتمعة في نتاج بعضهم، ومتفرقة لدى آخرين، وكانت بالقياس إلى متذوقيه
مثار إعجاب ومحط إكبار، ولنا وقفات مع هذه الأركان في مقالات قادمة.
فرأيناها مجتمعة في نتاج بعضهم، ومتفرقة لدى آخرين، وكانت بالقياس إلى متذوقيه
مثار إعجاب ومحط إكبار، ولنا وقفات مع هذه الأركان في مقالات قادمة.
الرافعيون وسيد قطب:
لم يسكت أخلص تلامذة الرافعي عن سيد بل
ندبوا أنفسهم للرد عليه، وإيقافه عند حدّه، فردّ عليه الأساتذة: محمود شاكر (1909
ــ 1997)، وعلي الطنطاوي (1909 ــ 1999) وسعيد العريان ( 1905ــ 1964)
ومحمد أحمد الغمراوي ( 1893ــ 1971)،
ولا يهمني ههنا أن أعرض لكل تفنيداتهم التي يقترب بعضها من المماحكات، كأن يدافعوا
عن شعر الرافعي بالهجوم على شعر العقاد، على طريقة من انتقص أبانا انتقصنا أباه،
لكن سأستل من ردود كل واحد منهم رداً يستأهل الوقوف عنده لما فيه من ركاكة أو
تجنٍّ أو استكبار وتعالٍ لا يليق بحامله ولا مدعيه.
ندبوا أنفسهم للرد عليه، وإيقافه عند حدّه، فردّ عليه الأساتذة: محمود شاكر (1909
ــ 1997)، وعلي الطنطاوي (1909 ــ 1999) وسعيد العريان ( 1905ــ 1964)
ومحمد أحمد الغمراوي ( 1893ــ 1971)،
ولا يهمني ههنا أن أعرض لكل تفنيداتهم التي يقترب بعضها من المماحكات، كأن يدافعوا
عن شعر الرافعي بالهجوم على شعر العقاد، على طريقة من انتقص أبانا انتقصنا أباه،
لكن سأستل من ردود كل واحد منهم رداً يستأهل الوقوف عنده لما فيه من ركاكة أو
تجنٍّ أو استكبار وتعالٍ لا يليق بحامله ولا مدعيه.
أما الأستاذ شاكر فرمى سيد بحجته البالغة
(إنك لا تقيم وزناً لحرمة الموت والميّت). وكرّر هذا المعنى عدة مرات، (انظر: الرسالة،
عدد: 251)، ولكن سيد قطب لم يكن بالرجل الرعديد فأعلن منذ البداية:
“لا يصحّ أن يكون الموت معطّلاً للنقد، ولهذا سأتكلم عنه [يقصد الرافعي] كما
لو كان حياً، لأنّ الذي يعنيني منه هو إنتاجه الأدبي وما يبدو من نفسه خلال هذا
الإنتاج”، غير أنّ الأستاذ شاكر لجّ في تكرار هذه الحجة فأجابه سيد:
“أخذ [يقصد شاكر] يردّد نغمة العوام في الموتى والأحياء […]، فخرافة الموتى
والأحياء لا يردّدها هؤلاء إلا كما يردّدها الأميون العوام” (الرسالة، عدد 280،
تاريخ: 14/ نوفمبر/ (1938.
(إنك لا تقيم وزناً لحرمة الموت والميّت). وكرّر هذا المعنى عدة مرات، (انظر: الرسالة،
عدد: 251)، ولكن سيد قطب لم يكن بالرجل الرعديد فأعلن منذ البداية:
“لا يصحّ أن يكون الموت معطّلاً للنقد، ولهذا سأتكلم عنه [يقصد الرافعي] كما
لو كان حياً، لأنّ الذي يعنيني منه هو إنتاجه الأدبي وما يبدو من نفسه خلال هذا
الإنتاج”، غير أنّ الأستاذ شاكر لجّ في تكرار هذه الحجة فأجابه سيد:
“أخذ [يقصد شاكر] يردّد نغمة العوام في الموتى والأحياء […]، فخرافة الموتى
والأحياء لا يردّدها هؤلاء إلا كما يردّدها الأميون العوام” (الرسالة، عدد 280،
تاريخ: 14/ نوفمبر/ (1938.
وأما الغمراوي فكان ردّه أشد هولاً وخطراً فخلط
بين الدين والأدب على طريقة الخلط بين الدين والسياسية، وجعل المسألة صراعاً بين
(الدين) و(اللادين) وبين أهل الجنة وأهل النار، وأجابه سيد بكلام طويل آخره:
“الدين الدين! هذه صيحة الواهن الضعيف يحتمي بها كلما جرفه التيار”
(الرسالة، عدد: 263، تاريخ: 18/ يوليو: 1938)، وفي موطن آخر يقول سيد: “وحكاية الأدب والدين التي لجّ
فيها وجعلها محور الحديث، وقد تهكّمت عليها من قبل، لأنها لا تناقش بغير التهكم
فأريد أن أفهم إذا نحن سرنا على هذه القاعدة العجيبة وأسقطنا من حسابنا الأدب غير
الديني في الأدب العربي كله، فماذا يبقى لنا بعد ذلك من هذا التراث الضخم؟ اللهم
إلا قصيدة البردة، وبانت سعاد، وبعض الأدعية والأوراد”. (الرسالة، عدد: 257،
تاريخ: 6/يونيو/ 1938).
بين الدين والأدب على طريقة الخلط بين الدين والسياسية، وجعل المسألة صراعاً بين
(الدين) و(اللادين) وبين أهل الجنة وأهل النار، وأجابه سيد بكلام طويل آخره:
“الدين الدين! هذه صيحة الواهن الضعيف يحتمي بها كلما جرفه التيار”
(الرسالة، عدد: 263، تاريخ: 18/ يوليو: 1938)، وفي موطن آخر يقول سيد: “وحكاية الأدب والدين التي لجّ
فيها وجعلها محور الحديث، وقد تهكّمت عليها من قبل، لأنها لا تناقش بغير التهكم
فأريد أن أفهم إذا نحن سرنا على هذه القاعدة العجيبة وأسقطنا من حسابنا الأدب غير
الديني في الأدب العربي كله، فماذا يبقى لنا بعد ذلك من هذا التراث الضخم؟ اللهم
إلا قصيدة البردة، وبانت سعاد، وبعض الأدعية والأوراد”. (الرسالة، عدد: 257،
تاريخ: 6/يونيو/ 1938).
وأما الشيخ علي الطنطاوي فيرتكب ثلاث موبقات
في نقده:
في نقده:
أولاً: يعمد إلى تسخيف سيد بطريقة عجيبة غريبة.
فيدعي أنّه لم يسمع باسمه ولم يعرفه قبل سلسلة مقالاته عن (العقاد والرافعي)، وأنّه
يعرف فقط الرافعي ومحمود شاكر! (انظر: الرسالة، عدد: 258، تاريخ: 13/ يونيو/ 1938).
فيدعي أنّه لم يسمع باسمه ولم يعرفه قبل سلسلة مقالاته عن (العقاد والرافعي)، وأنّه
يعرف فقط الرافعي ومحمود شاكر! (انظر: الرسالة، عدد: 258، تاريخ: 13/ يونيو/ 1938).
على الرغم من كونه كان زميلاً لسيد قطب في
المدرسة نفسها (دار العلوم العليا)، وعلى الرغم من أن سيد كان ينشر المقالات
الأدبية والفكرية والنقدية في شتى المجلات المصرية كأبولو، والآداب، والأديب،
والثقافة، والرسالة منذ سنة 1932، وقد عددت له منذ بداية كتابته في ذلك العام حتى نهاية عام 1938اثنين وستين
مقالاً منشوراً، وربما كان العدد أكثر من ذلك، فهب أنّه لم يلتقِ به في مدرسته أفلم
يقرأ له مقالاً واحداً طوال هذه السنوات، بل الأنكى من ذلك أنني وجدت لهما مقالات
في مجلة الرسالة منشورة في العدد نفسه عدة مرات، كالأعداد 69، و71، و229، حيث نرى اسميهما في صفحة واحدة هي صفحة
الفهرس، ثم يتكرران في موضع المقالة مرة أخرى!
المدرسة نفسها (دار العلوم العليا)، وعلى الرغم من أن سيد كان ينشر المقالات
الأدبية والفكرية والنقدية في شتى المجلات المصرية كأبولو، والآداب، والأديب،
والثقافة، والرسالة منذ سنة 1932، وقد عددت له منذ بداية كتابته في ذلك العام حتى نهاية عام 1938اثنين وستين
مقالاً منشوراً، وربما كان العدد أكثر من ذلك، فهب أنّه لم يلتقِ به في مدرسته أفلم
يقرأ له مقالاً واحداً طوال هذه السنوات، بل الأنكى من ذلك أنني وجدت لهما مقالات
في مجلة الرسالة منشورة في العدد نفسه عدة مرات، كالأعداد 69، و71، و229، حيث نرى اسميهما في صفحة واحدة هي صفحة
الفهرس، ثم يتكرران في موضع المقالة مرة أخرى!
أما إصرار الشيخ الطنطاوي على هذا الادعاء
فلا أعرف له وجهاً سوى محاولة الحط من قيمة سيد وأنه غير معروف ولا مشهور شهرة
الرافعي أو محمود شاكر، علماً أن اسم محمود شاكر حتى تلك الآونة لم يتكرر بالضبط
في المجلات إلا نصف تكرار اسم سيد فيها.
فلا أعرف له وجهاً سوى محاولة الحط من قيمة سيد وأنه غير معروف ولا مشهور شهرة
الرافعي أو محمود شاكر، علماً أن اسم محمود شاكر حتى تلك الآونة لم يتكرر بالضبط
في المجلات إلا نصف تكرار اسم سيد فيها.
ثانياً: استخدم أسلوب التهديد والتخويف، وهو
أسلوب مستهجن، وكأننا أمام (زكرت) أدبي، وليس أمام (ناقد) أدبي. يقول الشيخ
مهدّداً متوعداً: “واعلم أني إن حططت عليك ساخراً ومعرّضاً لم أدعك حتى
تلتصق بالأرض، وأنا من أقدر الناس على ذلك، ولكن ذلك شيء يأباه الخلق الكريم،
وتأباه الرسالة، ولقد كانت لي في هذا الميدان جولات صرعت فيها كثيراً من الكتاب
المدعين المستكبرين، ثم أقلعت عنها واستغفرت الله، وأرجو ألا يضطرني أحد إلى
مثلها”. فالشيخ تاب عن صرع الكتّاب وعن إلصاقهم بالأرض، ولكنه مستعد للرجوع
عن توبته، ومستعد للأوبة للخُلق الذميم إن استمر سيد في ردوده ونقوده. ياللهول!
أسلوب مستهجن، وكأننا أمام (زكرت) أدبي، وليس أمام (ناقد) أدبي. يقول الشيخ
مهدّداً متوعداً: “واعلم أني إن حططت عليك ساخراً ومعرّضاً لم أدعك حتى
تلتصق بالأرض، وأنا من أقدر الناس على ذلك، ولكن ذلك شيء يأباه الخلق الكريم،
وتأباه الرسالة، ولقد كانت لي في هذا الميدان جولات صرعت فيها كثيراً من الكتاب
المدعين المستكبرين، ثم أقلعت عنها واستغفرت الله، وأرجو ألا يضطرني أحد إلى
مثلها”. فالشيخ تاب عن صرع الكتّاب وعن إلصاقهم بالأرض، ولكنه مستعد للرجوع
عن توبته، ومستعد للأوبة للخُلق الذميم إن استمر سيد في ردوده ونقوده. ياللهول!
ثالثاً: لم يوفّر الشيخ الطنطاوي التجييش
الديني لأذية سيد وتحطيمه كما فعل الغمراوي بالضبط. وادعى ــ متجنياً ــ
أنّ سيد ينزل بالحب إلى ما يخالف الدين والأخلاق، وأنّه يرى المحب لا يستطيع أن
يحتفظ بخلق ولا دين (انظر: الرسالة، عدد: 257).
الديني لأذية سيد وتحطيمه كما فعل الغمراوي بالضبط. وادعى ــ متجنياً ــ
أنّ سيد ينزل بالحب إلى ما يخالف الدين والأخلاق، وأنّه يرى المحب لا يستطيع أن
يحتفظ بخلق ولا دين (انظر: الرسالة، عدد: 257).
وقد ردّ على هذا النقد كاتب عراقي اسمه عبد
الوهاب الأمين في مجلة الرسالة نفسها فقال: “إنّ الأستاذ علي الطنطاوي لا
يتجنى على العقاد وسيد قطب فحسب، بل هو يتبنّى سابقة غير محمودة في النقد، فليس من
المروءة تأليب الطبقة المحافظة على كل أديب مجدد، وليس الدين مدار البحث في أدب
الرافعي وشعر العقاد” (الرسالة، عدد: 260، تاريخ: 27/يونيو/ 1938).
الوهاب الأمين في مجلة الرسالة نفسها فقال: “إنّ الأستاذ علي الطنطاوي لا
يتجنى على العقاد وسيد قطب فحسب، بل هو يتبنّى سابقة غير محمودة في النقد، فليس من
المروءة تأليب الطبقة المحافظة على كل أديب مجدد، وليس الدين مدار البحث في أدب
الرافعي وشعر العقاد” (الرسالة، عدد: 260، تاريخ: 27/يونيو/ 1938).
وفصل الختام في هذا المقال ما أورده سيد قطب
عن الرافعيين:
عن الرافعيين:
“أما شأن الرافعيين معي فشأن الرافعي
مع العقاد سواء بسواء، كنتُ أعرض لهم الحياة المائجة الهائجة فيعرضون النصوص
والألفاظ، وكنت أحاول أن أفتح أبصارهم وأفتق إحساسهم وأفهمهم أنّ في الدنيا شيئاً
غير التعبير المزوّق، وغير اللفتات الذهنية القريبة، والمعاني اللولبية، والجمل
المتثنية المتراقصة، فيأبوا إلا أن يعودوا إلى هذا العبث العابث في لفّ
ودوران”. (الرسالة، عدد: 280). وقد ظل سيد قطب ثابتاً على هذا الرأي لم يغيّره ولم يتراجع عنه
حتى استشهاده.
مع العقاد سواء بسواء، كنتُ أعرض لهم الحياة المائجة الهائجة فيعرضون النصوص
والألفاظ، وكنت أحاول أن أفتح أبصارهم وأفتق إحساسهم وأفهمهم أنّ في الدنيا شيئاً
غير التعبير المزوّق، وغير اللفتات الذهنية القريبة، والمعاني اللولبية، والجمل
المتثنية المتراقصة، فيأبوا إلا أن يعودوا إلى هذا العبث العابث في لفّ
ودوران”. (الرسالة، عدد: 280). وقد ظل سيد قطب ثابتاً على هذا الرأي لم يغيّره ولم يتراجع عنه
حتى استشهاده.
محمد أمير ناشر النعم
المصدر: https://www.syria.tv/content/الجانب-الآخر-لمصطفى-صادق-الرافعي-الجزء-الثاني