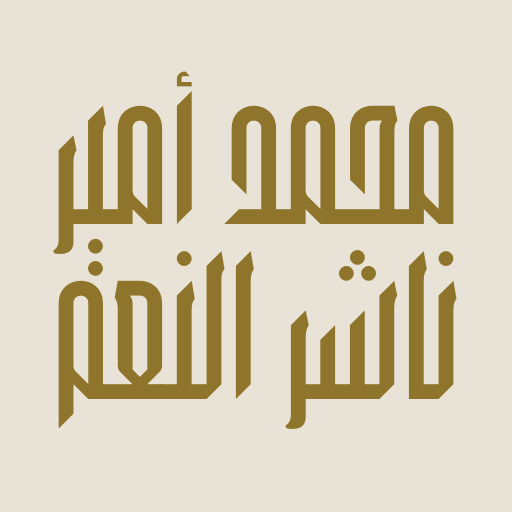انتسبت إلى كلية الشريعة/جامعة دمشق في السنة الدراسية 1988/ 1989، وسكنت في السنة
انتسبت إلى كلية الشريعة/جامعة دمشق في السنة الدراسية 1988/ 1989، وسكنت في السنةالأولى في منطقة السيدة زينب التي كانت تعجّ بالحوزات العلمية، ورجال الدين الشيعة
من جميع الجنسيات. وكم كانت دهشتي كبيرة من هذا العالم الموّار الفوّار الذي لم
أسمع عنه، من قبل، سوى شذرات لا ترسم لوحةً، ولا تشكِّل صورةً، فإذا أنا في قاموسه
ولجَّته!
استطعت في فترة وجيزة، لا تتجاوز السنة، أن أرسم اتجاهات هذا
العالم وتياراته، بعد أن قرأت معظم مؤلفات محمد باقر الصدر، وجميع ما تُرجم من مؤلفات مرتضى مطهري، وعلي شريعتي، ومحمد حسين الطباطبائي،
ما خلا تفسيره الضخم “الميزان” الذي كنت أرجع إليه حيناً بعد حين. ثم
بدأتُ إلى جانب دراستي الجامعية بدراسة الكتب التي يدرسونها في المقدمات والسطوح
والخارج، ولا سيما في المنطق والأصول. بدأت بكتب الشيخ محمد رضا المظفّر المنطقية
والأصولية، ثم بكتب محمد باقر الصدر الأصولية، ثم يمّمتُ نحو “كفاية”
الآخوند الخراساني وشروحها، ثم نحو كتب تقريرات دروس بحث الخارج لكبار المراجع من
أمثال: العراقي بقلم البروجردي، والنائيني بقلم الخوئي، والبروجردي بقلم المنتظري،
ومما زاد في تذوّقي لهذه الكتب قراءتي لأطروحة الشاعر العلاّمة مصطفى جمال الدين
المعنونة بــ “البحث النحوي عند الأصوليين”، وكنت أتتبع في تلك الآونة
كتب الفلسفة والعرفان فأشتريها، ولا سيما تحقيقات مهدي محقق، وجلال آشتياني،
وكوّنت مكتبة ممتازة من كتب الفلسفة والمنطق والأصول والعرفان.
العالم وتياراته، بعد أن قرأت معظم مؤلفات محمد باقر الصدر، وجميع ما تُرجم من مؤلفات مرتضى مطهري، وعلي شريعتي، ومحمد حسين الطباطبائي،
ما خلا تفسيره الضخم “الميزان” الذي كنت أرجع إليه حيناً بعد حين. ثم
بدأتُ إلى جانب دراستي الجامعية بدراسة الكتب التي يدرسونها في المقدمات والسطوح
والخارج، ولا سيما في المنطق والأصول. بدأت بكتب الشيخ محمد رضا المظفّر المنطقية
والأصولية، ثم بكتب محمد باقر الصدر الأصولية، ثم يمّمتُ نحو “كفاية”
الآخوند الخراساني وشروحها، ثم نحو كتب تقريرات دروس بحث الخارج لكبار المراجع من
أمثال: العراقي بقلم البروجردي، والنائيني بقلم الخوئي، والبروجردي بقلم المنتظري،
ومما زاد في تذوّقي لهذه الكتب قراءتي لأطروحة الشاعر العلاّمة مصطفى جمال الدين
المعنونة بــ “البحث النحوي عند الأصوليين”، وكنت أتتبع في تلك الآونة
كتب الفلسفة والعرفان فأشتريها، ولا سيما تحقيقات مهدي محقق، وجلال آشتياني،
وكوّنت مكتبة ممتازة من كتب الفلسفة والمنطق والأصول والعرفان.
لم تكن كل تلك الشخصيات والكتب هي المفاجأة الحقيقية
بالقياس إليّ، وإنّما كانت مفاجأتي في اطلاعي على كتب الإمام الخميني، واقتنائها
وقراءتها!
بالقياس إليّ، وإنّما كانت مفاجأتي في اطلاعي على كتب الإمام الخميني، واقتنائها
وقراءتها!
عرفت الإمام الخميني وعمري تسع سنوات في يوم وصوله إلى
طهران، من خلال سماعي اسمه الغريب يردِّده كبار رجال عائلتي. يشيدون به، ويكبرون
بطولته، وسيبدأ ذكره يتكرّر مصحوباً بالشتائم واللعنات من قبل الرجال أنفسهم، بعد
سنة ونيف، غداة بدء الحرب مع العراق، وسأظل لمدة ثماني سنوات أسمع اسمه في نشرات
الأخبار في إذاعتي لندن ومونتي كارلو إبَّان الحديث عن تلك الحرب التي لم تكن
لتنتهي، وستغدو الصورة النمطية له كالتالي: رجلٌ وقع عليه اختيار المخابرات
البريطانية، وربما الأمريكية أيضاً. ألبسوه الجبة والعمامة، وجاؤوا به من فرنسا،
وسلّموه قيادة الدولة الإيرانية، ليشنّ حربه الشعواء على العراق خدمةً لأسياده ومشغّليه.
طهران، من خلال سماعي اسمه الغريب يردِّده كبار رجال عائلتي. يشيدون به، ويكبرون
بطولته، وسيبدأ ذكره يتكرّر مصحوباً بالشتائم واللعنات من قبل الرجال أنفسهم، بعد
سنة ونيف، غداة بدء الحرب مع العراق، وسأظل لمدة ثماني سنوات أسمع اسمه في نشرات
الأخبار في إذاعتي لندن ومونتي كارلو إبَّان الحديث عن تلك الحرب التي لم تكن
لتنتهي، وستغدو الصورة النمطية له كالتالي: رجلٌ وقع عليه اختيار المخابرات
البريطانية، وربما الأمريكية أيضاً. ألبسوه الجبة والعمامة، وجاؤوا به من فرنسا،
وسلّموه قيادة الدولة الإيرانية، ليشنّ حربه الشعواء على العراق خدمةً لأسياده ومشغّليه.
وفي المرحلة الثانوية التي قضيتها في الثانوية الشرعية (الخسروية)
في حلب سيعمِّم أحد الطلاب الأشقياء في صفي اسمَي القذافي والخميني، الأول رمزاً
للعضو الذكري، والثاني للعضو الأنثوي، وسيظل اسماهما يتكرران في الصف فيدغدغان
الطلاب، من دون أن يدرك الأساتذة المشايخ سبب انفجارنا بالضحك عندما يقحمهما أحد
الطلاب المناكيد، في المناقشات، لإخراج الدرس من حالة رتابته، أو إخراج الطلاب من
سكينتهم وهدوئهم إذا طال أمدهما، لكن من دون أن يحمل ذلك أدنى شحنة طائفية مذهبية،
لأن التشيع لم يكن هاجسنا، في تلك الآونة، ولأن همومنا كانت مستغرقة ببقايا
المعارك التي نشبت بين الصوفية والوهابية حصراً.
في حلب سيعمِّم أحد الطلاب الأشقياء في صفي اسمَي القذافي والخميني، الأول رمزاً
للعضو الذكري، والثاني للعضو الأنثوي، وسيظل اسماهما يتكرران في الصف فيدغدغان
الطلاب، من دون أن يدرك الأساتذة المشايخ سبب انفجارنا بالضحك عندما يقحمهما أحد
الطلاب المناكيد، في المناقشات، لإخراج الدرس من حالة رتابته، أو إخراج الطلاب من
سكينتهم وهدوئهم إذا طال أمدهما، لكن من دون أن يحمل ذلك أدنى شحنة طائفية مذهبية،
لأن التشيع لم يكن هاجسنا، في تلك الآونة، ولأن همومنا كانت مستغرقة ببقايا
المعارك التي نشبت بين الصوفية والوهابية حصراً.
اشتريت من مكتبات (السيدة زينب) كتب الخميني التالية:
ــ تهذيب الأصول: تقرير بحث الخارج بمجلداته الثلاثة،
بقلم تلميذه جعفر سبحاني.
بقلم تلميذه جعفر سبحاني.
ــ سرّ الصلاة، أو صلاة العارفين.
ــ شرح الأربعين حديثاً.
ــ الآداب المعنوية للصلاة
ــ البيع بمجلداته الخمسة.
ــ تحرير الوسيلة (الرسالة العملية).
وبدأت رحلة اكتشافي الخميني عرفانياً، أصولياً، فقيهاً،
قبل اكتشافي إياه سياسياً مناضلاً، ثورياً.
قبل اكتشافي إياه سياسياً مناضلاً، ثورياً.
أثار انتباهي في درسه الأصولي تحرّره من ربقة أساطين
الأصوليين الشيعة، إذ لم يكن يهاب مناقشة أحد منهم، ولا سيما المقدَّم بينهم
الآخوند الخراساني، وجمّعت مناقشاته المختلفة تمهيداً لبحث قد أكتبه مستقبلاً مثل:
مناقشته الأشاعرة في رأيهم المشهور بأن واضع اللغة هو الله الذي ألهمها لأنبيائه
وأصفيائه، واعتراضه على دليلهم بلزوم العلاقة بين الألفاظ ومعانيها دفعاً للترجيح
بلا مرجّح، أو مناقشته كون (حروف المعاني) إخطارية موضوعة للأعراض النسبية التي
يعبّر عنها وعن غيرها من سائر الأعراض بــ (الوجودات الرابطية)، وأنّ مداليل
الهيئات هي الوجود الرابط، أي: ربط العرض بموضوعه، أو شرحه لقولهم: “إنّ
للماهية نشأتين: نشأة خارجية هي نشأة الكثرة المحضة، ونشأة عقلية هي نشأة الوحدة
النوعية”. إلخ.
الأصوليين الشيعة، إذ لم يكن يهاب مناقشة أحد منهم، ولا سيما المقدَّم بينهم
الآخوند الخراساني، وجمّعت مناقشاته المختلفة تمهيداً لبحث قد أكتبه مستقبلاً مثل:
مناقشته الأشاعرة في رأيهم المشهور بأن واضع اللغة هو الله الذي ألهمها لأنبيائه
وأصفيائه، واعتراضه على دليلهم بلزوم العلاقة بين الألفاظ ومعانيها دفعاً للترجيح
بلا مرجّح، أو مناقشته كون (حروف المعاني) إخطارية موضوعة للأعراض النسبية التي
يعبّر عنها وعن غيرها من سائر الأعراض بــ (الوجودات الرابطية)، وأنّ مداليل
الهيئات هي الوجود الرابط، أي: ربط العرض بموضوعه، أو شرحه لقولهم: “إنّ
للماهية نشأتين: نشأة خارجية هي نشأة الكثرة المحضة، ونشأة عقلية هي نشأة الوحدة
النوعية”. إلخ.
وفي تلك السنة كتبتُ ونشرت بحثي الأول (اللغة بين علمي
المنطق والأصول)، وكتبت بحثي الثاني حول (المصطلحات الفلسفية في كتب أصول الفقه)،
وكان كتاب الإمام الخميني من أوائل مراجعي، وقد لفت نظري يومها، إضافةً إلى توسّعه
في استخدام المصطلحات المنطقية والفلسفية، أن الحالة العرفانية والصوفية التي
يعيشها كانت تنعكس على اختياره مفرداته في مواطن يبعد استخدامها فيه، ككلمة
(البركة) التي ترد عنده في السياق التالي، على سبيل المثال لا الحصر: “حصول
الربط في الكلام ببركة الحروف والأدوات أمرٌ مسلّم إلا أنّ شأنها ليس منحصراً
فيه”.
المنطق والأصول)، وكتبت بحثي الثاني حول (المصطلحات الفلسفية في كتب أصول الفقه)،
وكان كتاب الإمام الخميني من أوائل مراجعي، وقد لفت نظري يومها، إضافةً إلى توسّعه
في استخدام المصطلحات المنطقية والفلسفية، أن الحالة العرفانية والصوفية التي
يعيشها كانت تنعكس على اختياره مفرداته في مواطن يبعد استخدامها فيه، ككلمة
(البركة) التي ترد عنده في السياق التالي، على سبيل المثال لا الحصر: “حصول
الربط في الكلام ببركة الحروف والأدوات أمرٌ مسلّم إلا أنّ شأنها ليس منحصراً
فيه”.
وهذا ما قادني لقراءة كتبه العرفانية التي أدهشتني لغتها
المفرطة في كلاسيكيتها، والتي ولّدت لدي انطباعاً أنه قرأ وتمثّل معظم التراث
الصوفي العرفاني، ثم أعاد إنتاجه متدفِّقاً بلا تعمُّل، فلم تكن كلماته مجرّد (القال)
الذي ينقله من كتب السابقين، ويقتبسها عنهم، ولكنها كانت في تقديري (الحال) الذي
يعايشه، ويستلهم فيه روحانية النبي الكريم، وآل بيته الأطهار، وأعلام التصوف
والعرفان، من أمثال السهروردي المقتول، والشيخ الأكبر، والشاعرَين الشيرازيَّين
سعدي وحافظ، وأعلام مدرسة أصفهان بدءاً بالمعلم الثالث المير داماد والملا صدرا
ومروراً بالنراقيَّين، وانتهاءً بشيخه الذي يسبغ عليه كل صفات التبجيل والتقديس،
ويفديه بروحه شاه آبادي.
المفرطة في كلاسيكيتها، والتي ولّدت لدي انطباعاً أنه قرأ وتمثّل معظم التراث
الصوفي العرفاني، ثم أعاد إنتاجه متدفِّقاً بلا تعمُّل، فلم تكن كلماته مجرّد (القال)
الذي ينقله من كتب السابقين، ويقتبسها عنهم، ولكنها كانت في تقديري (الحال) الذي
يعايشه، ويستلهم فيه روحانية النبي الكريم، وآل بيته الأطهار، وأعلام التصوف
والعرفان، من أمثال السهروردي المقتول، والشيخ الأكبر، والشاعرَين الشيرازيَّين
سعدي وحافظ، وأعلام مدرسة أصفهان بدءاً بالمعلم الثالث المير داماد والملا صدرا
ومروراً بالنراقيَّين، وانتهاءً بشيخه الذي يسبغ عليه كل صفات التبجيل والتقديس،
ويفديه بروحه شاه آبادي.
قرأت دعاءه في مقدمة كتابه “سرّ الصلاة”:
“وارفع عن بصائرنا حجب الأنانية الظلمانية،
والإنية النورانية، حتى نصل إلى المعراج الحقيقي الصلاتي للمصلين المتضرعين،
ونكبّر التكبيرات الأربع إلى الجهات الأربع للمُلك والملكوت، وافتح لنا أبواب
الأسرار الغيبية، واكشف عن ضمائرنا أستار الأحدية لننال مناجاة أهل الولاية، ونفوز
بحلاوة ذكر أرباب الهداية“.
والإنية النورانية، حتى نصل إلى المعراج الحقيقي الصلاتي للمصلين المتضرعين،
ونكبّر التكبيرات الأربع إلى الجهات الأربع للمُلك والملكوت، وافتح لنا أبواب
الأسرار الغيبية، واكشف عن ضمائرنا أستار الأحدية لننال مناجاة أهل الولاية، ونفوز
بحلاوة ذكر أرباب الهداية“.
فأعجبني أنّه صلى على الكون كله صلاة الميت، وكبّر عليه
أربع تكبيرات، ولم يعد يشاهد سوى الحي القيوم، وأثّر فيَّ ذلك الانخطاف الروحي المعبّر
عنه بكلماته الحارة المتَّقدة، وبشعره الذي جارى فيه كبار العاشقين المدلَّهين
المطرَّحين، فارتاد مثلهم “الحانة الحانية على العشّاق“، وباح
مثلما باحوا: “زادت عينها السكرى سكري“، و”رأيت عينك
المريضة فمرضت“، و”فرغتُ من ذاتي وقرعت طبل (أنا الحق)،
وكالحلاّج صرتُ شارياً للمشنقة“.
أربع تكبيرات، ولم يعد يشاهد سوى الحي القيوم، وأثّر فيَّ ذلك الانخطاف الروحي المعبّر
عنه بكلماته الحارة المتَّقدة، وبشعره الذي جارى فيه كبار العاشقين المدلَّهين
المطرَّحين، فارتاد مثلهم “الحانة الحانية على العشّاق“، وباح
مثلما باحوا: “زادت عينها السكرى سكري“، و”رأيت عينك
المريضة فمرضت“، و”فرغتُ من ذاتي وقرعت طبل (أنا الحق)،
وكالحلاّج صرتُ شارياً للمشنقة“.
“وجملة الأسرار مختبئة في شفتي الحبيب
فافتح شفتيك، وأمط اللثام عن مشكلنا
وإمّا أن تقتلني، أو تنفذني من قفصي الضيّق
إنْ لم نكن جديرين بالطواف حول حريمك
لِمَ مَزجتَ محبتك بطينتنا“؟
…
“فقل للشيخ إنّك تبطل طريقي
وباطلي يسخر من حقّك
إنْ سار سالكه منازلاً
فإنّ مسلك الفناء هو بذاته منزلنا
عقدتْ مئة قافلة للفؤاد رحالها إلى مقصودها
غير أنّ قلبنا الغافل لبث في مكانه
وإنْ نجا نوح من الغرق، واهتدى إلى الساحل
فإنّ الغرق في الماء هو بذاته ساحلنا“.
وكنتُ في كل أسبوع أصلي الجمعة، في الأعم الأغلب، في
المسجد السني الصغير في السيدة زينب، ثم أخرج مسرعاً إلى مصلّى الشيعة الواسع
الفسيح المكتظ رجالاً ونساءً، لأتابع أجواء صلاة الجمعة ضمن الحشود الغفيرة،
مستحضراً أجواء الثورة، ومنفعلاً بها، ومتفاعلاً معها، وبعد الصلاة كان الهتاف
يرجّ أركان المكان:
المسجد السني الصغير في السيدة زينب، ثم أخرج مسرعاً إلى مصلّى الشيعة الواسع
الفسيح المكتظ رجالاً ونساءً، لأتابع أجواء صلاة الجمعة ضمن الحشود الغفيرة،
مستحضراً أجواء الثورة، ومنفعلاً بها، ومتفاعلاً معها، وبعد الصلاة كان الهتاف
يرجّ أركان المكان:
الله أكبر.
خميني رهبر.
النصر للإسلام.
الموت لصدام.
ثم كان في كل مرة ينطلق صوتٌ رفيعٌ منادياً: (إلهي!
إلهي! حتى ظهور المهدي احفظ لنا الخميني). ثم بصوت مدفعي يأتي الطلب المحفّز: (صلوات
على محمد وآل محمد).
إلهي! حتى ظهور المهدي احفظ لنا الخميني). ثم بصوت مدفعي يأتي الطلب المحفّز: (صلوات
على محمد وآل محمد).
وكما زوّدتني مكتبات (السيدة زينب) بكتب الإمام الفقهية
والأصولية والعرفانية، فقد زودتني مكتبة المستشارية الثقافية الإيرانية في حي
المرجة بدمشق بكل الكتب والمقالات التي كانت تحكي قصة جهاده ومواقفه:
والأصولية والعرفانية، فقد زودتني مكتبة المستشارية الثقافية الإيرانية في حي
المرجة بدمشق بكل الكتب والمقالات التي كانت تحكي قصة جهاده ومواقفه:
ــ إشعاله لـ (انتفاضة 15خرداد 1963)، اعتراضاً
على (الثورة البيضاء) التي دعا الشاه إليها، وإرساله البرقيات العديدة للشاه، ورئيس
الوزراء، والتي جاء في إحداها: “إنني أنصحك مرة أخرى بالعودة لطاعة الله،
والخضوع للدستور، والخوف من العواقب الوخيمة للتنكر لأحكام القرآن، وأحكام علماء
الأمة وزعماء المسلمين، والحياد عن الدستور، فلا تلقِ بالبلاد في الخطر متعمّداً،
ومن دون سبب، وإلا فلن يتجنب علماء الإسلام إبداء آرائهم فيك“، واعتقاله
بعد ذلك، ثم الإفراج عنه.
على (الثورة البيضاء) التي دعا الشاه إليها، وإرساله البرقيات العديدة للشاه، ورئيس
الوزراء، والتي جاء في إحداها: “إنني أنصحك مرة أخرى بالعودة لطاعة الله،
والخضوع للدستور، والخوف من العواقب الوخيمة للتنكر لأحكام القرآن، وأحكام علماء
الأمة وزعماء المسلمين، والحياد عن الدستور، فلا تلقِ بالبلاد في الخطر متعمّداً،
ومن دون سبب، وإلا فلن يتجنب علماء الإسلام إبداء آرائهم فيك“، واعتقاله
بعد ذلك، ثم الإفراج عنه.
ــ كلمته التاريخية النارية ضد لائحة (الكوبيتولاسيون= الحصانة القضائية الممنوحة للمستشارين والموظفين
الأمريكان في إيران) في نهاية سنة 1964.
الأمريكان في إيران) في نهاية سنة 1964.
ــ اعتقاله مرة أخرى، ثم نفيه إلى تركيا.
ــ انتقاله إلى العراق، وقتل نجله الأكبر السيد مصطفى.
ــ وصوله إلى باريس في 6/ 10/1978، ومجيء مسؤولين في قصر الإليزيه، وإبلاغه قرار رئيس الجمهورية
الفرنسي بضرورة تحاشيه أي نشاط سياسي في فرنسا، وردّه عليهم بحزم بأن
هذا يتنافى ومزاعم الديمقراطية، وأنه إذا اضطر للسفر من مطار إلى مطار ومن بلد إلى
بلد، فإنه لن يكف عن جهاده لتحقيق أهدافه.
الفرنسي بضرورة تحاشيه أي نشاط سياسي في فرنسا، وردّه عليهم بحزم بأن
هذا يتنافى ومزاعم الديمقراطية، وأنه إذا اضطر للسفر من مطار إلى مطار ومن بلد إلى
بلد، فإنه لن يكف عن جهاده لتحقيق أهدافه.
ــ عودته إلى طهران في 1/ 2/1979 بطلاً
شعبياً، وقائداً ثورياً ملحمياً، وإماماً ربّانياً.
شعبياً، وقائداً ثورياً ملحمياً، وإماماً ربّانياً.
وستتفق جميع هذه
الكتب والدراسات على رسم صورة له، تجعله في مرتبة تداني مرتبة الأئمة أنفسهم،
بسلطتهم التي تتجاوز السلطة التشريعية إلى السلطة التكوينية.
الكتب والدراسات على رسم صورة له، تجعله في مرتبة تداني مرتبة الأئمة أنفسهم،
بسلطتهم التي تتجاوز السلطة التشريعية إلى السلطة التكوينية.
وباجتماع صورتي (الفقيه
المتصوف) و(السياسي القائد) الذي تحتشد الملايين لاستقباله في المطار، ثم يحتشد
مثلها في كل مناسبة لتمرَّ من تحت شرفته، وتحظى بطلَّته! سينقدح في ذهني أنَّني أعاصر
ظاهرة نبوية تشابه تلك الظواهر النبوية التي حدثنا التاريخ عنها! بل سأتذوق معنى
هذه الظاهرة من خلال هذا الرجل الفريد الاستثنائي، الذي لا يلين، ولا يستكين، ولا
يتراجع، ولا يتفجّع، وسأرى بأمّ عيني كيف أن الثقة الهائلة بالنفس تصنع من الرجل قائداً، وأن الزهد والعلم والصبر والمثابرة
والإصرار والتلاميذ والأتباع والمحبون تجعل منه إماماً، وأنّ كل ذلك يجعله أحد
رجال القرن العشرين المعدودين على الأصابع.
المتصوف) و(السياسي القائد) الذي تحتشد الملايين لاستقباله في المطار، ثم يحتشد
مثلها في كل مناسبة لتمرَّ من تحت شرفته، وتحظى بطلَّته! سينقدح في ذهني أنَّني أعاصر
ظاهرة نبوية تشابه تلك الظواهر النبوية التي حدثنا التاريخ عنها! بل سأتذوق معنى
هذه الظاهرة من خلال هذا الرجل الفريد الاستثنائي، الذي لا يلين، ولا يستكين، ولا
يتراجع، ولا يتفجّع، وسأرى بأمّ عيني كيف أن الثقة الهائلة بالنفس تصنع من الرجل قائداً، وأن الزهد والعلم والصبر والمثابرة
والإصرار والتلاميذ والأتباع والمحبون تجعل منه إماماً، وأنّ كل ذلك يجعله أحد
رجال القرن العشرين المعدودين على الأصابع.
ولأنني كنت متشبعاً بقراءة تولتسوي، وغاندي فقد أعجبني كونه
طيلة كفاحه الطويل لم يلجأ أبداً إلى الجهاد المسلّح، رغم الإجراءات العدائية
لنظام الشاه، حتى في أحلك مراحل حالة الطوارئ، وأشد مراحل الثورة، ولم يصدر عنه
سوى (التهديد بالجهاد) محاولةً لردع النظام عن أعماله الوحشية.
طيلة كفاحه الطويل لم يلجأ أبداً إلى الجهاد المسلّح، رغم الإجراءات العدائية
لنظام الشاه، حتى في أحلك مراحل حالة الطوارئ، وأشد مراحل الثورة، ولم يصدر عنه
سوى (التهديد بالجهاد) محاولةً لردع النظام عن أعماله الوحشية.
وسأقرأ أعمال أولئك الكتّاب ذوي الأسماء المستعارة من صنيعة
المخابرات العراقية والسعودية والأردنية ممن سيبيحون لأنفسهم، بدافع الطائفية
الموتورة، أو حالة الاسترزاق المأجورة، تعمّد إساءة فهم كل أقوال الإمام وأفكاره،
وتلفيق كل تفصيل وحبكة يتحملها جسمه، وسأرى الافتراء عارياً مكشوفاً بكامل سوآته،
وبانعدام أخلاقه، فيزداد تعاطفي معه، واقتناعي به، ناهيكم عن قراءتي تلك المقتطفات
التبجيلية، في المجلات والجرائد العربية الصادرة في إيران أو لبنان، من مقالاتٍ
وشهاداتٍ لكبار المفكرين في العالم ممن لم أسمع بهم سابقاً من الهند وجنوب
إفريقيا، ونيجيريا، إلخ، أو ممن أعرفهم معرفة جيدة، كميشيل فوكو في تصريحاته
المحتفية بهذه الثورة وقائدها، أو أدونيس الذي كتب مقال “بين الثبات والتحول:
خواطر حول الثورة الإسلامية في إيران”، أو هيكل مؤلف كتاب “مدافع آية
الله”، أو حافظ الجمالي الذي كتب مقال “مفاجآت إيرانية”، ورأى أنّ
“الخميني بدا وكأنه صاعقة نزلت من السماء فجأة، من غيوم لم تكد أن تكون
ظاهرة”، وفي المقال نفسه فضّل الثورة الإسلامية الإيرانية على كلا الثورتين
الفرنسية والشيوعية، وقدّم لذلك الأدلة الداعمة المبرهنة!
المخابرات العراقية والسعودية والأردنية ممن سيبيحون لأنفسهم، بدافع الطائفية
الموتورة، أو حالة الاسترزاق المأجورة، تعمّد إساءة فهم كل أقوال الإمام وأفكاره،
وتلفيق كل تفصيل وحبكة يتحملها جسمه، وسأرى الافتراء عارياً مكشوفاً بكامل سوآته،
وبانعدام أخلاقه، فيزداد تعاطفي معه، واقتناعي به، ناهيكم عن قراءتي تلك المقتطفات
التبجيلية، في المجلات والجرائد العربية الصادرة في إيران أو لبنان، من مقالاتٍ
وشهاداتٍ لكبار المفكرين في العالم ممن لم أسمع بهم سابقاً من الهند وجنوب
إفريقيا، ونيجيريا، إلخ، أو ممن أعرفهم معرفة جيدة، كميشيل فوكو في تصريحاته
المحتفية بهذه الثورة وقائدها، أو أدونيس الذي كتب مقال “بين الثبات والتحول:
خواطر حول الثورة الإسلامية في إيران”، أو هيكل مؤلف كتاب “مدافع آية
الله”، أو حافظ الجمالي الذي كتب مقال “مفاجآت إيرانية”، ورأى أنّ
“الخميني بدا وكأنه صاعقة نزلت من السماء فجأة، من غيوم لم تكد أن تكون
ظاهرة”، وفي المقال نفسه فضّل الثورة الإسلامية الإيرانية على كلا الثورتين
الفرنسية والشيوعية، وقدّم لذلك الأدلة الداعمة المبرهنة!
وفي سنة 2000 سألتقي في حلب نائب رئيس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية حجة
الإسلام مير آقاي، وسيوّجه لي في السنة التالية الشيخ محمد علي التسخيري الدعوة
إلى طهران لحضور المؤتمر الرابع عشر للوحدة الإسلامية، وسيتاح لي زيارة بيت الإمام
وضريحه في طهران، وغرفته المتواضعة في المدرسة الفيضيَّة، في مدينة قم.
الإسلام مير آقاي، وسيوّجه لي في السنة التالية الشيخ محمد علي التسخيري الدعوة
إلى طهران لحضور المؤتمر الرابع عشر للوحدة الإسلامية، وسيتاح لي زيارة بيت الإمام
وضريحه في طهران، وغرفته المتواضعة في المدرسة الفيضيَّة، في مدينة قم.
وسأُدعى فيما بعد من جهات إيرانية
مختلفة، لكنني سأعتذر، وسألبي فقط دعوة أخرى لمجمع التقريب بين المذاهب في عام 2006، وسأزور
طهران وأصفهان، وسألحظ الفرق الهائل خلال خمس سنوات، في هيئات الشباب الإيراني، وأزيائهم،
ونزوعهم نحو الموضة الغربية التي لم ألحظها قبل ذلك، فقد رأيت قصات وتسريحات غريبة
عجيبة تذكّر المرء بأتباع النازية الجدد، ورأيت غرات البنات النافرة من تحت الحجاب
بألوانها الفاقعة أو الغريبة كالأخضر والليلكي والبرتقالي المائل للحمرة.
مختلفة، لكنني سأعتذر، وسألبي فقط دعوة أخرى لمجمع التقريب بين المذاهب في عام 2006، وسأزور
طهران وأصفهان، وسألحظ الفرق الهائل خلال خمس سنوات، في هيئات الشباب الإيراني، وأزيائهم،
ونزوعهم نحو الموضة الغربية التي لم ألحظها قبل ذلك، فقد رأيت قصات وتسريحات غريبة
عجيبة تذكّر المرء بأتباع النازية الجدد، ورأيت غرات البنات النافرة من تحت الحجاب
بألوانها الفاقعة أو الغريبة كالأخضر والليلكي والبرتقالي المائل للحمرة.
طوال تلك السنوات كنت كمن يصعد جبلاً متمهِّلاً حتى يبلغ
ذروته، فيكون أشمل في الرؤية، وأوسع في الأفق، ولا غرو، فمسألة جلاء الرؤية هي
مسألة لا يمكن التكهُّن بها، ولا تسريع وتيرتها! وفي 2008 ستتضح رؤيتي التي كانت تنضج ببطء شديد على نار قراءة واسعة متنوعة مختلفة الاتجاهات والتيارات،
وسأعيد تأويل معظم معارفي
ومعلوماتي، وسيغدو موقفي منها مختلفاً، بما في ذلك موقفي من الإمام الخميني نفسه،
فبعد أن كانت عين الرضا تغضي عن كل ما يمتّ بصلة لحقوق الإنسان، والحريات العامة،
وشرور السلطة المطلقة للثيوقراطية البيورتيانية، سأنظر لكل حادثة، وكل واقعة، وكل
فكرة من خلال ما كنت أغضّ الطرف عنه، وسأجد أمامي كارثة! وما عددته من فضائل في
هذا الرجل ستغدو فجائع، وسوف تقفز إلى ذهني عبارات ومواقف لا مجال لحصرها، وحسبي،
ههنا، أن أشير إلى بعضها إشارات عابرة، علماً أنّ كل واحدة منها تستأهل مقالاً
خاصاً، أو بحثاً مستقلاً.
ذروته، فيكون أشمل في الرؤية، وأوسع في الأفق، ولا غرو، فمسألة جلاء الرؤية هي
مسألة لا يمكن التكهُّن بها، ولا تسريع وتيرتها! وفي 2008 ستتضح رؤيتي التي كانت تنضج ببطء شديد على نار قراءة واسعة متنوعة مختلفة الاتجاهات والتيارات،
وسأعيد تأويل معظم معارفي
ومعلوماتي، وسيغدو موقفي منها مختلفاً، بما في ذلك موقفي من الإمام الخميني نفسه،
فبعد أن كانت عين الرضا تغضي عن كل ما يمتّ بصلة لحقوق الإنسان، والحريات العامة،
وشرور السلطة المطلقة للثيوقراطية البيورتيانية، سأنظر لكل حادثة، وكل واقعة، وكل
فكرة من خلال ما كنت أغضّ الطرف عنه، وسأجد أمامي كارثة! وما عددته من فضائل في
هذا الرجل ستغدو فجائع، وسوف تقفز إلى ذهني عبارات ومواقف لا مجال لحصرها، وحسبي،
ههنا، أن أشير إلى بعضها إشارات عابرة، علماً أنّ كل واحدة منها تستأهل مقالاً
خاصاً، أو بحثاً مستقلاً.
سأبدأ أولاً بإعادة النظر في تقييم الشخصيات الإيرانية، وسأعيد
اكتشافها بعيداً عن الماكينة الإعلامية للثورة الخمينية، كالمراجع الذين لم يؤمنوا
بنظرية (ولاية الفقيه)، ولم يسلّموا للخميني بها، كالخوئي وشريعتمداري وكلبايكاني،
ممن كنت أزدريهم، في داخلي، وأحطّ من شأنهم، أو كالمفكرين الذين سلقهم تيار
الثورة بألسنةٍ حِدَاد، كأحمد
كسروي، أو علي أكبر حكمي زاده، أو حيدر علي قلمداران، أو أبو الحسن بني صدر!
وإعادة النظر ستكون بوابة لتقييم مجمل الأداء، ولفهم مسار الأحداث برؤية أكثر
شمولاً وأوسع بانوراميةً، بل وربما أكثر موضوعية أيضاً.
اكتشافها بعيداً عن الماكينة الإعلامية للثورة الخمينية، كالمراجع الذين لم يؤمنوا
بنظرية (ولاية الفقيه)، ولم يسلّموا للخميني بها، كالخوئي وشريعتمداري وكلبايكاني،
ممن كنت أزدريهم، في داخلي، وأحطّ من شأنهم، أو كالمفكرين الذين سلقهم تيار
الثورة بألسنةٍ حِدَاد، كأحمد
كسروي، أو علي أكبر حكمي زاده، أو حيدر علي قلمداران، أو أبو الحسن بني صدر!
وإعادة النظر ستكون بوابة لتقييم مجمل الأداء، ولفهم مسار الأحداث برؤية أكثر
شمولاً وأوسع بانوراميةً، بل وربما أكثر موضوعية أيضاً.
ـــ وأما وقفته ضد (الثورة البيضاء) التي سمّاها (الثورة السوداء)، فسأعيد
قراءتها، لأجد نفسي أمام رجل دين مهتاج، يضرب ذات اليمين وذات الشمال، ويحرّض
الناس ضدَّ كلّ حركة تهدف للاتساق مع حقوق الإنسان، ولا سيما حق المرأة في
التصويت، وحق غير المسلم في الترشح للمناصب بالانتخاب، وهو وإن كان محقاً في
انتقاده الشاه كونه مرتهناً للأمريكان، فإنه كان متسربلاً بالخطأ حين عاند خطواتٍ
كان لا بدّ منها عاجلاً أم آجلاً في التطور الإنساني العام الذي لا يعانده معاند
إلا وكان الخسران ضجيعه.
قراءتها، لأجد نفسي أمام رجل دين مهتاج، يضرب ذات اليمين وذات الشمال، ويحرّض
الناس ضدَّ كلّ حركة تهدف للاتساق مع حقوق الإنسان، ولا سيما حق المرأة في
التصويت، وحق غير المسلم في الترشح للمناصب بالانتخاب، وهو وإن كان محقاً في
انتقاده الشاه كونه مرتهناً للأمريكان، فإنه كان متسربلاً بالخطأ حين عاند خطواتٍ
كان لا بدّ منها عاجلاً أم آجلاً في التطور الإنساني العام الذي لا يعانده معاند
إلا وكان الخسران ضجيعه.
ـــ وأمّا ذلكما المضي والإصرار اللذان تحلَّى بهما، فسيتجليان لي على
حقيقتيهما: عناداً يولّد عنفاً لا يتراجع أمام شيء، وقسوةً تستهزئ بالإنسانية
بوصفها ضعفاً وفسولة، وتتنكر لقيمتها الممحوقة والمتلاشية أمام المقدس الكبير
الهائل، وستنطلق فتاويه ومكافآته لقتل كلّ من تسوِّل له نفسه مسّ كرامة الدين أو
النيل من رموزه!!
حقيقتيهما: عناداً يولّد عنفاً لا يتراجع أمام شيء، وقسوةً تستهزئ بالإنسانية
بوصفها ضعفاً وفسولة، وتتنكر لقيمتها الممحوقة والمتلاشية أمام المقدس الكبير
الهائل، وستنطلق فتاويه ومكافآته لقتل كلّ من تسوِّل له نفسه مسّ كرامة الدين أو
النيل من رموزه!!
ـــ وسيتجلّى (الإمام) أمام ناظريّ زاهداً عنيداً متعصباً، وقديساً صلباً
قاسياً، يتدفق حِكَماً ومواعظ في المسجد والحسينية، وينهمر دموعاً وآهات في خلوات
السَّحر، ثم لا يرى حرجاً في أوامره بتنفيذ آلاف الأحكام القاتلة، ما دام يشعر
بأنه يحظى بتغطيةٍ داخلية من أفكاره ونظرياته ونظامه.
قاسياً، يتدفق حِكَماً ومواعظ في المسجد والحسينية، وينهمر دموعاً وآهات في خلوات
السَّحر، ثم لا يرى حرجاً في أوامره بتنفيذ آلاف الأحكام القاتلة، ما دام يشعر
بأنه يحظى بتغطيةٍ داخلية من أفكاره ونظرياته ونظامه.
وسأعيد النظر في فتواه بإهدار دم سلمان رشدي لكتابته رواية (آيات شيطانية)،
وسأراها، كما كتب صادق جلال العظم منذ اللحظات الأولى في كتابه (ذهنية التحريم) أنها
جاءت في خضم “الصراع المحتدم بين آية الله الخميني وخادم الحرمين على التحكم
بــ (الأممية الإسلامية) عبر البحر، والسيطرة عليها وتوظيفها”.
وسأراها، كما كتب صادق جلال العظم منذ اللحظات الأولى في كتابه (ذهنية التحريم) أنها
جاءت في خضم “الصراع المحتدم بين آية الله الخميني وخادم الحرمين على التحكم
بــ (الأممية الإسلامية) عبر البحر، والسيطرة عليها وتوظيفها”.
وحقيقةً كان الإمام الخميني في فتواه يمتح من التراث نفسه الذي أمدَّ فقهاء
المملكة العربية السعودية بالرأي ذاته حول سلمان رشدي، فأحد أهم كتب شيخ الإسلام ابن
تيمية ـــ الرجل الأثير عندهم ـــ عنوانه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول). وفي
حين كان يمكن لرجل الثورة وقائدها أن يغمد سيفه، ويتمتّع بالحد الأدنى من المنطقية
والعقلانية والأخلاقية والإنسانية في تعاطيه مع الفقه الإسلامي، فيبيّن أنَّ سلَّ
ذلك الصارم كان حكماً تاريخياً، من باب السياسة الشرعية التي لا يجب تعميمها، ولا
استدعاؤها، ولا سيما أنه يملك من الكاريزما والتأثير ما يخوّله أن يكون مساعداً
أساسياً في فكّ تلك الأنشوطة الفقهية الملتفة على رقاب المسلمين برضاهم وموافقتهم،
ولكنه جاء بكل ثقله فزاد في إحكامها وشدّها وعقدها.
المملكة العربية السعودية بالرأي ذاته حول سلمان رشدي، فأحد أهم كتب شيخ الإسلام ابن
تيمية ـــ الرجل الأثير عندهم ـــ عنوانه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول). وفي
حين كان يمكن لرجل الثورة وقائدها أن يغمد سيفه، ويتمتّع بالحد الأدنى من المنطقية
والعقلانية والأخلاقية والإنسانية في تعاطيه مع الفقه الإسلامي، فيبيّن أنَّ سلَّ
ذلك الصارم كان حكماً تاريخياً، من باب السياسة الشرعية التي لا يجب تعميمها، ولا
استدعاؤها، ولا سيما أنه يملك من الكاريزما والتأثير ما يخوّله أن يكون مساعداً
أساسياً في فكّ تلك الأنشوطة الفقهية الملتفة على رقاب المسلمين برضاهم وموافقتهم،
ولكنه جاء بكل ثقله فزاد في إحكامها وشدّها وعقدها.
هل أذكر، أيضاً، بعض فتاويه التي يخجل المرء من ذكرها وتناولها والحديث
عنها! تلك الفتاوى المتعارضة مع المقاصد الشرعية نفسها، والمجافية للعقل والأخلاق
والإنسانية، مثل إباحته أخذ الربا من الكتابي الحربي!!! وهل هذا إلا براغماتية
قاتلة قائمة على التمييز الديني، والعنصرية العقدية؟! وهذا ما سنراه، بعدئذٍ، في
ذلك التعامل الشائن المجحف المرعب للنظام الإيراني مع أتباع الطائفة البهائية،
بدءاً من أحكام الإعدام إلى السجن والنفي والطرد من الوظائف والجامعات، وصولاً إلى
التشفي بتدمير المقابر وتلويثها وانتهاك حرمتها!
عنها! تلك الفتاوى المتعارضة مع المقاصد الشرعية نفسها، والمجافية للعقل والأخلاق
والإنسانية، مثل إباحته أخذ الربا من الكتابي الحربي!!! وهل هذا إلا براغماتية
قاتلة قائمة على التمييز الديني، والعنصرية العقدية؟! وهذا ما سنراه، بعدئذٍ، في
ذلك التعامل الشائن المجحف المرعب للنظام الإيراني مع أتباع الطائفة البهائية،
بدءاً من أحكام الإعدام إلى السجن والنفي والطرد من الوظائف والجامعات، وصولاً إلى
التشفي بتدمير المقابر وتلويثها وانتهاك حرمتها!
وهذا بالضبط ما سيرجعني إلى ذلك النقاش الذي حصل قبل مئة سنة تقريباً بين
المستشرقَين (كارّادي فو) و(جولد تسيهر) حول التشيّع، فقد رأى الأول أن التشيع
يمثّل ردة فعل الروح الحرة لمقاومة جمود العقلية السامية وتحجّرها، ونزاعاً بين
فكر حرٍّ طليق، وسنة ضيقة جامدة، في حين رأى جولد تسيهر أنه لا يأخذ بهذا الرأي أو
يعوِّل على صحته واحدٌ ممن يعرفون الأحكام الفقهية في التشيع التي لا تقلّ في شدّتها
عن مثيلتها في فقه أهل السنة، بل حكم جولد تسيهر بأنّ النظرية الفقهية التي تحدِّد
علاقة الشيعة بأصحاب الديانات الأخرى تبدو لنا باعتبار وثائقها الشرعية أقسى وأشد
من النظرية المماثلة لها التي يقرّها أهل السنة.
المستشرقَين (كارّادي فو) و(جولد تسيهر) حول التشيّع، فقد رأى الأول أن التشيع
يمثّل ردة فعل الروح الحرة لمقاومة جمود العقلية السامية وتحجّرها، ونزاعاً بين
فكر حرٍّ طليق، وسنة ضيقة جامدة، في حين رأى جولد تسيهر أنه لا يأخذ بهذا الرأي أو
يعوِّل على صحته واحدٌ ممن يعرفون الأحكام الفقهية في التشيع التي لا تقلّ في شدّتها
عن مثيلتها في فقه أهل السنة، بل حكم جولد تسيهر بأنّ النظرية الفقهية التي تحدِّد
علاقة الشيعة بأصحاب الديانات الأخرى تبدو لنا باعتبار وثائقها الشرعية أقسى وأشد
من النظرية المماثلة لها التي يقرّها أهل السنة.
أما إباحته الاستمتاع بالزوجة الرضيعة، فوضعتنا أمام طامتين:
الأولى: إباحة هذا الاستمتاع نفسه، من دون أن يخطر في باله أنه اعتداء صارخ
على حرم الطفولة، بل، يا للعار، الاعتداء على حرم ما قبل الطفولة.
على حرم الطفولة، بل، يا للعار، الاعتداء على حرم ما قبل الطفولة.
والثانية: قبول هذا الزواج، واعتباره، والاعتراف به. وهو اعتداء آخر لا يقل
فداحةً عن الاعتداء الأول!
فداحةً عن الاعتداء الأول!
ومردّ هذه الفتاوى إلى استحكام المنطق الصوري بتمثيله وأشكاله ولوازمه في
آليات استنباط الأحكام الشرعية حيث ينتج بعضها عن بعض، فينصاع الفقيه إليها، ويغمض
عينيه وعقله وقلبه ويسير وراءها إلى هاوية سحيقة مرعبة من دون أن يحكّم المقاصد
العليا للشرع نفسه التي لا تحتمل كل هذا العنت، ولا تقبل كل هذا السفه، ولا تعترف
بكل هذه اللوازم والنتائج المخالفة لها، فالمقدمات الصحيحة، هذا إذا كانت كذلك
فعلاً، لا تنتج قطعاً نتائج صحيحة. وفي هذا الإطار نفسه وباستحكام ذلك المنطق
الفقهي الصوري الأجوف نراه يبيح التمتع ببائعات الهوى:
آليات استنباط الأحكام الشرعية حيث ينتج بعضها عن بعض، فينصاع الفقيه إليها، ويغمض
عينيه وعقله وقلبه ويسير وراءها إلى هاوية سحيقة مرعبة من دون أن يحكّم المقاصد
العليا للشرع نفسه التي لا تحتمل كل هذا العنت، ولا تقبل كل هذا السفه، ولا تعترف
بكل هذه اللوازم والنتائج المخالفة لها، فالمقدمات الصحيحة، هذا إذا كانت كذلك
فعلاً، لا تنتج قطعاً نتائج صحيحة. وفي هذا الإطار نفسه وباستحكام ذلك المنطق
الفقهي الصوري الأجوف نراه يبيح التمتع ببائعات الهوى:
“يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصاً لو كانت من العواهر
والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور“.
والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور“.
وستغدو هذه الفتوى مستنداً أثيراً لارتياد بيوت الدعارة وغشيانها!
على أنني لا أخصّ الإمام الخميني ههنا بهذا النقد، بل إنّ استجرار الفقهاء
سنةً وشيعة لهذا التراث الفقهي التقليدي، من دون تمحيصه وإعادة النظر فيه هو من
عموم البلوى، وهو لم يأتِ بهذه الأحكام من بنات أفكاره، بل كان وفياً لتراثه،
أميناً له! لا يرى حاجةً لإعادة النظر فيه، ولا لتخليصه من شوائبه وروائبه التي
تزري بنا، وتضعنا في مآزق لا حدّ لها ولا حصر!
سنةً وشيعة لهذا التراث الفقهي التقليدي، من دون تمحيصه وإعادة النظر فيه هو من
عموم البلوى، وهو لم يأتِ بهذه الأحكام من بنات أفكاره، بل كان وفياً لتراثه،
أميناً له! لا يرى حاجةً لإعادة النظر فيه، ولا لتخليصه من شوائبه وروائبه التي
تزري بنا، وتضعنا في مآزق لا حدّ لها ولا حصر!
لقد كان من المؤمّل أن يساعدنا الإمام الخميني في اجتياز هذه العقبة، فلطالما
وصفه محبوه بالمجددِّ والمصلح، ولكننا لم نرَ مصداق ذلك في تناوله الفقهي بتاتاً
سوى في تطويره مسألة (ولاية الفقيه) التي أطاح بها إلى خارج مداها إطاحةً أفقدتها
كل معناها، كما سنشير إلى ذلك في آخر المقال.
وصفه محبوه بالمجددِّ والمصلح، ولكننا لم نرَ مصداق ذلك في تناوله الفقهي بتاتاً
سوى في تطويره مسألة (ولاية الفقيه) التي أطاح بها إلى خارج مداها إطاحةً أفقدتها
كل معناها، كما سنشير إلى ذلك في آخر المقال.
وبالعودة إلى وصيته التي نُشرت بعد وفاته مباشرة سنقرأ فيها التأكيد على
الحوزات العلمية أن تستمر في تدريس الفقه بالطريقة ذاتها، بالكتب نفسها، باتباعها
بحذافيرها، بالتمسك بها، بعدم الانجرار إلى دعوات التطوير والتجديد فيها.
الحوزات العلمية أن تستمر في تدريس الفقه بالطريقة ذاتها، بالكتب نفسها، باتباعها
بحذافيرها، بالتمسك بها، بعدم الانجرار إلى دعوات التطوير والتجديد فيها.
“من اللازم ألّا يسمح العلماء والمدرسون المحترمون بانحراف الدراسة
في مجال الفقاهة والحوزات الفقهية والأصولية عن طريقة المشايخ العظام التي هي
الطريق الوحيد لحفظ الفقه الإسلامي، وليعملوا على زيادة نسبة التدققات والأبحاث
والنظريات والابتكارات والتحقيقات كل يوم، وليحرصوا على حفظ الفقه التقليدي الذي
هو إرث السلف الصالح، والانحراف عنه إضعافٌ لأركان التحقيق والتدقيق“.
في مجال الفقاهة والحوزات الفقهية والأصولية عن طريقة المشايخ العظام التي هي
الطريق الوحيد لحفظ الفقه الإسلامي، وليعملوا على زيادة نسبة التدققات والأبحاث
والنظريات والابتكارات والتحقيقات كل يوم، وليحرصوا على حفظ الفقه التقليدي الذي
هو إرث السلف الصالح، والانحراف عنه إضعافٌ لأركان التحقيق والتدقيق“.
وسأتوقف ملياً عند شعار (سياستنا عين ديننا)، هذا الشعار الذي قاله المرجع
حسن المدرّس إبّان الثورة الدستورية، ثم تبنَّته الثورة وقائدها وأزلامها،
وسأقلّبه على وجوهه كلها، ولن أجد فيه إلا المغالاة والكبرياء والاستهتار وخلط
المصطلحات والأنساق! شعار إذا ناقشتَه وجدتَ أنه مستحيل، لأنه لا يُعقل أن يكون الدين
المحكوم بالأخلاق هو نفسه السياسة المحكومة بالمصلحة، ولا يستقيم (للدين) الذي
يأخذ دور الموجِّه أن يكون هو عينه (السياسة) التي تأخذ دور الموجَّه! وإذا سلّمتَ
بهذا القول وقبلتَه فستكون النتيجة: أنَّ هذا الدين الذي هو عين السياسة بائسٌ
ساقطٌ انتهازيٌّ مكّارٌ متلوِّنٌ مقتنِصٌ مراوغٌ متناقضٌ مزوِّر!
حسن المدرّس إبّان الثورة الدستورية، ثم تبنَّته الثورة وقائدها وأزلامها،
وسأقلّبه على وجوهه كلها، ولن أجد فيه إلا المغالاة والكبرياء والاستهتار وخلط
المصطلحات والأنساق! شعار إذا ناقشتَه وجدتَ أنه مستحيل، لأنه لا يُعقل أن يكون الدين
المحكوم بالأخلاق هو نفسه السياسة المحكومة بالمصلحة، ولا يستقيم (للدين) الذي
يأخذ دور الموجِّه أن يكون هو عينه (السياسة) التي تأخذ دور الموجَّه! وإذا سلّمتَ
بهذا القول وقبلتَه فستكون النتيجة: أنَّ هذا الدين الذي هو عين السياسة بائسٌ
ساقطٌ انتهازيٌّ مكّارٌ متلوِّنٌ مقتنِصٌ مراوغٌ متناقضٌ مزوِّر!
وهذا ما شهدناه في ممارسة الخميني السياسية، وتحديداً في إدارته للحرب
العراقية الإيرانية، هذه الحرب التي وضعنا اللوم فيها على رئيس العراق صدام حسين
ونظامه البعثي الذي ابتدأ الهجوم والتوغل في الأراضي الإيرانية من دون سابق إنذار،
لتشهد المنطقة حرباً من أطول الحروب خلال القرن المنصرم.
العراقية الإيرانية، هذه الحرب التي وضعنا اللوم فيها على رئيس العراق صدام حسين
ونظامه البعثي الذي ابتدأ الهجوم والتوغل في الأراضي الإيرانية من دون سابق إنذار،
لتشهد المنطقة حرباً من أطول الحروب خلال القرن المنصرم.
ولكن بعد موت الخميني ونضوج رؤية بعض أصحابه والمقربين الملازمين له،
ومراجعتهم لسير أحداث هذه الحرب غدت الصورة أكثر وضوحاً لنا، وعرفنا مقدار مسؤولية
الخميني والثورة الإسلامية في إشعال هذه الحرب وإذكائها. (انظر مقالنا: في انتظار
المؤرخين الجدد الإيرانيين).
ومراجعتهم لسير أحداث هذه الحرب غدت الصورة أكثر وضوحاً لنا، وعرفنا مقدار مسؤولية
الخميني والثورة الإسلامية في إشعال هذه الحرب وإذكائها. (انظر مقالنا: في انتظار
المؤرخين الجدد الإيرانيين).
وبدلاً من أن يتوجّه إلى دولته بالتحديد فيجعلها أنموذجاً في الحريات
العامة، وحقوق الإنسان، والرفاهية والازدهار في المعايير المادية والروحية والفنية،
دعم منظمة العمل الإسلامي في العراق لتقويض الحكم فيه، ومارس سياسة المكائد
والدسائس والاغتيال.
العامة، وحقوق الإنسان، والرفاهية والازدهار في المعايير المادية والروحية والفنية،
دعم منظمة العمل الإسلامي في العراق لتقويض الحكم فيه، ومارس سياسة المكائد
والدسائس والاغتيال.
ونشبت (قادسية صدام) في شهر أيلول/سبتمر من عام 1980 وغدا اسمها في إيران (الدفاع المقدس)، ولا غرو فكل شيء في إيران
منذ استلام الملالي غدا مقدساً، باعتبار أنّ (سياستنا عين ديننا)، وفي
حزيران/يونيو 1982 استعادت
إيران كامل أراضيها، وأسرت أحد عشر ألف جندي عراقي، فعرضت الحكومة العراقية في
الشهر ذاته مبادرة لوقف إطلاق النار، واللجوء إلى التحكيم والتفاوض، للوصول إلى
حلِّ النزاع بين البلدين، ومباشرةً قدّم العقلاء من المحيطين بالخميني من أمثال:
مهدي بازركان، وحسين علي منتظري، وعلي أكبر رفسنجاني، النصيحةَ بقبول هذه
المبادرة، واللجوء إلى المفاوضات، لكن الخميني بعد يومين ظهر على التلفاز وقال:
جاءني بعضهم ليقنعني أن أوقف القتال، ونقعد على طاولة المفاوضات، بحجة أنّ الوطن
تحرَّر! وقد أجبتهم: “أيّهما أهمّ الوطن أم الإسلام؟ إذا تحررت الأرض فما
زال الإسلام أسيراً في قبضة النظام البعثي الجائر“!
منذ استلام الملالي غدا مقدساً، باعتبار أنّ (سياستنا عين ديننا)، وفي
حزيران/يونيو 1982 استعادت
إيران كامل أراضيها، وأسرت أحد عشر ألف جندي عراقي، فعرضت الحكومة العراقية في
الشهر ذاته مبادرة لوقف إطلاق النار، واللجوء إلى التحكيم والتفاوض، للوصول إلى
حلِّ النزاع بين البلدين، ومباشرةً قدّم العقلاء من المحيطين بالخميني من أمثال:
مهدي بازركان، وحسين علي منتظري، وعلي أكبر رفسنجاني، النصيحةَ بقبول هذه
المبادرة، واللجوء إلى المفاوضات، لكن الخميني بعد يومين ظهر على التلفاز وقال:
جاءني بعضهم ليقنعني أن أوقف القتال، ونقعد على طاولة المفاوضات، بحجة أنّ الوطن
تحرَّر! وقد أجبتهم: “أيّهما أهمّ الوطن أم الإسلام؟ إذا تحررت الأرض فما
زال الإسلام أسيراً في قبضة النظام البعثي الجائر“!
وهكذا استمر إرسال أبناء إيران اليافعين ليلقوا حتفهم في حرب الخنادق
واجتياز حقول الألغام بالأجساد! تلك الحرب التي تمّ تشبيهها حرفياً بالحرب
العالمية الأولى في وسائلها، وتكتيكاتها، وسبل مواجهاتها.
واجتياز حقول الألغام بالأجساد! تلك الحرب التي تمّ تشبيهها حرفياً بالحرب
العالمية الأولى في وسائلها، وتكتيكاتها، وسبل مواجهاتها.
وبعد ست سنوات من هذا العبث ستنتهي الحرب بقرار من مجلس الأمن، وسيقبله
الطرفان، وسيظهر الإمام الخميني في خطاب إذاعي ليقول: “ويلٌ لي لأني ما زلت
على قيد الحياة لأتجرَّع كأس السمّ بموافقتي على اتفاقية وقف إطلاق النار“.
الطرفان، وسيظهر الإمام الخميني في خطاب إذاعي ليقول: “ويلٌ لي لأني ما زلت
على قيد الحياة لأتجرَّع كأس السمّ بموافقتي على اتفاقية وقف إطلاق النار“.
وبعد فترة وجيزة سينُقل عن خليفة الخميني الشيخ حسين علي المنتظري أنه دعا
إلى تقديم اعتذار أمام الشعب لإطالة هذه الحرب التي كان يمكن اختصار ست سنوات من
أمدها، وتجنيب الشعب الإيراني مئات آلاف الضحايا، ولكن الخميني رفض ذلك، وكانت هذه
إحدى أهم الضربات في إسفين العلاقة بينهما، وانتهت بقرار الإمام الخميني بإلغاء
خلافته. وكان من أهم هذه الضربات كذلك اعتراض المنتظري الشديد على الإسراف في
الإعدامات التي لم تكن تروي ظمأ القيادة الإيرانية، ولا تبلُّ غُلّتها.
إلى تقديم اعتذار أمام الشعب لإطالة هذه الحرب التي كان يمكن اختصار ست سنوات من
أمدها، وتجنيب الشعب الإيراني مئات آلاف الضحايا، ولكن الخميني رفض ذلك، وكانت هذه
إحدى أهم الضربات في إسفين العلاقة بينهما، وانتهت بقرار الإمام الخميني بإلغاء
خلافته. وكان من أهم هذه الضربات كذلك اعتراض المنتظري الشديد على الإسراف في
الإعدامات التي لم تكن تروي ظمأ القيادة الإيرانية، ولا تبلُّ غُلّتها.
وسترنّ في خاطري
عندئذٍ قضية هذه الإعدامات الجائرة التي قامت بها الثورة، ولا سيما إعدام آلاف الشباب المسجونين بتهمة الانتماء
لمنظمة خلق بفتوى سرية من الخميني التي جاء فيها أنهم مرتدون عن الإسلام ويحاربون
الله ورسوله ويجب إعدامهم، لمجرد انتمائهم لهذه المنظمة، ولو لم يفعلوا ما يوجب الإعدام، وسأعيد
قراءة إعدام حسن بكروان رئيس السافاك. هذا الجنرال الذي عُرف باسم (الجنرال الفيلسوف)، لأنه كان
يكره العنف والتصفية الجسدية لخصوم الشاه، وعندما أُلقي القبض على الخميني وجيء به إلى طهران لمحاكمته، كان
له الفضل الأكبر بعد المراجع العظام الذين اجتمعوا وكتبوا رسالة للشاه أعلنوا فيها
رفع درجة الخميني من (حجة الإسلام) إلى (آية الله)، واعترفوا به مرجعاً لقطع
الطريق على الشاه إذا فكّر بإعدامه، بحسب الدستور الإيراني الذي يمنع ذلك، فحمل
الجنرال بكروان هذه الرسالة للشاه، ورجاه وقبّل يده لكي يعتمدها، وينقذ الخميني من المحاكمة التي قد تصل
نتيجتها للإعدام. فقبل الشاه، وأبعد الخميني لتركيا، ويحدثنا إحسان نراغي في مذكراته “من بلاط
الشاه إلى سجون الثورة” عن بكروان فيقول: “إنّ تعيين بكروان رئيساً
للسافاك في عام 1961 خلق مفاجأة كبرى في طهران، لأنه اشتهر
برهافته وتسامحه، ولم تكن شخصيته تتوافق مع الصورة الرهيبة التي يرسمها الشعب
للبوليس السري، في الوقت نفسه لم يكن أحد يجهل أنّ الشاه كان يفتش عن كسب ودِّ جون
كيندي الذي وصل لتوه إلى البيت الأبيض، والذي كان يطالب بتطبيق حرية أكثر في
البلدان التي يُقال عنها إنها حليفة”، ثم استقال بكروان من منصبه، وذهب سفيراً لباريس، ثم
استقال أيضاً، وعاد إلى إيران قبل أيام من عودة الخميني لإيران. ورغم هذه اليد البيضاء لهذا الجنرال فقد
كان من أوائل من أُعدم. أما آية الله شريعتمداري فلن يعدمه الخميني، ولكنه سيحاصره
في بيته، وهو يعاين سكرات الموت بسبب الفشل الكلوي، وسيمنع عنه العلاج إلى أن يموت
متسمماً ببوله، وقد جاوز عمره الثمانين عاماً ليكون جزاؤه بعد أن أنقذ الخميني قبل
حوالي العشرين عاماً من حبل المشنقة، كجزاء سنمّار.
عندئذٍ قضية هذه الإعدامات الجائرة التي قامت بها الثورة، ولا سيما إعدام آلاف الشباب المسجونين بتهمة الانتماء
لمنظمة خلق بفتوى سرية من الخميني التي جاء فيها أنهم مرتدون عن الإسلام ويحاربون
الله ورسوله ويجب إعدامهم، لمجرد انتمائهم لهذه المنظمة، ولو لم يفعلوا ما يوجب الإعدام، وسأعيد
قراءة إعدام حسن بكروان رئيس السافاك. هذا الجنرال الذي عُرف باسم (الجنرال الفيلسوف)، لأنه كان
يكره العنف والتصفية الجسدية لخصوم الشاه، وعندما أُلقي القبض على الخميني وجيء به إلى طهران لمحاكمته، كان
له الفضل الأكبر بعد المراجع العظام الذين اجتمعوا وكتبوا رسالة للشاه أعلنوا فيها
رفع درجة الخميني من (حجة الإسلام) إلى (آية الله)، واعترفوا به مرجعاً لقطع
الطريق على الشاه إذا فكّر بإعدامه، بحسب الدستور الإيراني الذي يمنع ذلك، فحمل
الجنرال بكروان هذه الرسالة للشاه، ورجاه وقبّل يده لكي يعتمدها، وينقذ الخميني من المحاكمة التي قد تصل
نتيجتها للإعدام. فقبل الشاه، وأبعد الخميني لتركيا، ويحدثنا إحسان نراغي في مذكراته “من بلاط
الشاه إلى سجون الثورة” عن بكروان فيقول: “إنّ تعيين بكروان رئيساً
للسافاك في عام 1961 خلق مفاجأة كبرى في طهران، لأنه اشتهر
برهافته وتسامحه، ولم تكن شخصيته تتوافق مع الصورة الرهيبة التي يرسمها الشعب
للبوليس السري، في الوقت نفسه لم يكن أحد يجهل أنّ الشاه كان يفتش عن كسب ودِّ جون
كيندي الذي وصل لتوه إلى البيت الأبيض، والذي كان يطالب بتطبيق حرية أكثر في
البلدان التي يُقال عنها إنها حليفة”، ثم استقال بكروان من منصبه، وذهب سفيراً لباريس، ثم
استقال أيضاً، وعاد إلى إيران قبل أيام من عودة الخميني لإيران. ورغم هذه اليد البيضاء لهذا الجنرال فقد
كان من أوائل من أُعدم. أما آية الله شريعتمداري فلن يعدمه الخميني، ولكنه سيحاصره
في بيته، وهو يعاين سكرات الموت بسبب الفشل الكلوي، وسيمنع عنه العلاج إلى أن يموت
متسمماً ببوله، وقد جاوز عمره الثمانين عاماً ليكون جزاؤه بعد أن أنقذ الخميني قبل
حوالي العشرين عاماً من حبل المشنقة، كجزاء سنمّار.
أما
تراخي الخميني في نصرة محمد باقر الصدر، وقد وقف وحيداً، وهو يبحلق في الساطور
الذي يقترب منه ليحز رأسه، فذلك مما يحزّ في النفس، ويبعث على الأسى، وعندما نقرأ
الرسالة التي أرسلها الصدر للإمام الخميني يصف له فيها حاله ومآله، وردّ الخميني
عليه الذي لم يحرك ساكناً، بل انقلب فجأة لرجل مستكين عاجز مستسلم لا حيلة له ولا
حول، ولا يملك سوى الدعاء والحسبلة والحوقلة، فسنصاب بالكمد والإحباط، وسنضرب
أخماساً لأسداس في أسباب هذا التقاعس ودواعيه
تراخي الخميني في نصرة محمد باقر الصدر، وقد وقف وحيداً، وهو يبحلق في الساطور
الذي يقترب منه ليحز رأسه، فذلك مما يحزّ في النفس، ويبعث على الأسى، وعندما نقرأ
الرسالة التي أرسلها الصدر للإمام الخميني يصف له فيها حاله ومآله، وردّ الخميني
عليه الذي لم يحرك ساكناً، بل انقلب فجأة لرجل مستكين عاجز مستسلم لا حيلة له ولا
حول، ولا يملك سوى الدعاء والحسبلة والحوقلة، فسنصاب بالكمد والإحباط، وسنضرب
أخماساً لأسداس في أسباب هذا التقاعس ودواعيه
أخيراً: لن أستطيع ردع خاطري
عن إجراء أخطر مقارنة في أجواء هذا العالم المعقَّد، بين نظريتي (ولاية الفقيه)
و(الصهيونية)، هذه المقارنة الكفيلة بإبراز أوجه الشبه الرهيبة بينهما إلى درجة لا
تُصدّق! فمنذ القدم استقر التقليد اليهودي على انتظار المسيح الموعود الذي سيظهر،
ويحقق أملهم في إنشاء الدولة الجامعة التي ستنعم بالقوة والمجد والعظمة والاقتدار،
لكن فجأة ظهر هرتزل ودعا لإنشاء وطن قومي لليهود، وإقامة دولة تظلّهم، بغض النظر
عن مجيء المنتظر الموعود، وقد لاقت هذه الدعوة منذ انبثاقها وحتى هذه اللحظة
الراهنة تأييداً كبيراً من اليهود، وفي اللحظة ذاتها معارضة كبيرة من اليهود
التقليديين ممن رأوا فيها اعتداءً وتجاوزاً لحقٍّ لا يملكه سوى المسيح المنتظر
نفسه.
عن إجراء أخطر مقارنة في أجواء هذا العالم المعقَّد، بين نظريتي (ولاية الفقيه)
و(الصهيونية)، هذه المقارنة الكفيلة بإبراز أوجه الشبه الرهيبة بينهما إلى درجة لا
تُصدّق! فمنذ القدم استقر التقليد اليهودي على انتظار المسيح الموعود الذي سيظهر،
ويحقق أملهم في إنشاء الدولة الجامعة التي ستنعم بالقوة والمجد والعظمة والاقتدار،
لكن فجأة ظهر هرتزل ودعا لإنشاء وطن قومي لليهود، وإقامة دولة تظلّهم، بغض النظر
عن مجيء المنتظر الموعود، وقد لاقت هذه الدعوة منذ انبثاقها وحتى هذه اللحظة
الراهنة تأييداً كبيراً من اليهود، وفي اللحظة ذاتها معارضة كبيرة من اليهود
التقليديين ممن رأوا فيها اعتداءً وتجاوزاً لحقٍّ لا يملكه سوى المسيح المنتظر
نفسه.
أليست
هذه هي الصورة عينها في نظرية (ولاية الفقيه) التي أطلقها الإمام الخميني، وطوّر
فيها ما أسّسه المحقِّق الكركي وأحمد النراقي، من كون الشارع قد منح الولاية
العامة إلى الأنبياء ثم الأوصياء، ثم الفقهاء، فأنشأ دولة بناءً عليها، على خلاف
اعتقاد الشيعة، لأكثر من ألف سنة، بأنّ المسؤول عن إقامتها حصراً هو الإمام
المنتظر، فهو صاحب الحق وحده في إنشائها وإرساء قواعدها ودعائمها. وستلقى هذه
النظرية اعتراض العديد من المراجع والتيارات الشيعية للأسباب نفسها التي اعترض فيها
اليهود على الحركة الصهيونية، وحتى الشيخيين اللبنانيين البارزين محمد جواد مغنية،
ومحمد مهدي شمس الدين سيقفان في وجهها! أما الأول فسيحصر، مثل معظم مراجع التقليد،
(ولاية الفقيه) في القضاء والفتيا، وأما الثاني فسيقول بــ (ولاية الأمة) على
نفسها بدلاً من (ولاية الفقيه) على الأمة.
هذه هي الصورة عينها في نظرية (ولاية الفقيه) التي أطلقها الإمام الخميني، وطوّر
فيها ما أسّسه المحقِّق الكركي وأحمد النراقي، من كون الشارع قد منح الولاية
العامة إلى الأنبياء ثم الأوصياء، ثم الفقهاء، فأنشأ دولة بناءً عليها، على خلاف
اعتقاد الشيعة، لأكثر من ألف سنة، بأنّ المسؤول عن إقامتها حصراً هو الإمام
المنتظر، فهو صاحب الحق وحده في إنشائها وإرساء قواعدها ودعائمها. وستلقى هذه
النظرية اعتراض العديد من المراجع والتيارات الشيعية للأسباب نفسها التي اعترض فيها
اليهود على الحركة الصهيونية، وحتى الشيخيين اللبنانيين البارزين محمد جواد مغنية،
ومحمد مهدي شمس الدين سيقفان في وجهها! أما الأول فسيحصر، مثل معظم مراجع التقليد،
(ولاية الفقيه) في القضاء والفتيا، وأما الثاني فسيقول بــ (ولاية الأمة) على
نفسها بدلاً من (ولاية الفقيه) على الأمة.
ويبقى
السؤال الأهم ههنا هو عندما تُربط (ولاية الفقيه) بقومية معيّنة، وبدستور دولة محدّدة،
كيف يكون موقف الشيعة الذين لا ينتمون إلى هذه القومية، ولا إلى هذه الدولة؟ لن
تكون (ولاية الفقيه) عندئذ عامة، بحكم الواقع، إذ لا سلطة للولي الفقيه على بقية
البلدان، وهكذا سيعود الولي الفقيه، مرة أخرى، مجرّد سلطان في بلده تحديداً، لا
يختلف قيد أنملة عن السلطان الصفوي أو القاجاري أو البهلوي، ولن تكون نيابته عن
الإمام نيابة عامة، بل محصورة ومقيدة، على خلاف معنى (ولاية الفقيه) التي يُفترض
فيها العموم والشمول، والتي تفوق أهميتها، بحسب الإمام الخميني
نفسه،
أهمية العبادات مجتمعة. ولنا عودة لهذه المسألة ببحث مستقل يستوفي جميع الإشارات
المكثّفة الموجزة المرسلة ههنا.
السؤال الأهم ههنا هو عندما تُربط (ولاية الفقيه) بقومية معيّنة، وبدستور دولة محدّدة،
كيف يكون موقف الشيعة الذين لا ينتمون إلى هذه القومية، ولا إلى هذه الدولة؟ لن
تكون (ولاية الفقيه) عندئذ عامة، بحكم الواقع، إذ لا سلطة للولي الفقيه على بقية
البلدان، وهكذا سيعود الولي الفقيه، مرة أخرى، مجرّد سلطان في بلده تحديداً، لا
يختلف قيد أنملة عن السلطان الصفوي أو القاجاري أو البهلوي، ولن تكون نيابته عن
الإمام نيابة عامة، بل محصورة ومقيدة، على خلاف معنى (ولاية الفقيه) التي يُفترض
فيها العموم والشمول، والتي تفوق أهميتها، بحسب الإمام الخميني
نفسه،
أهمية العبادات مجتمعة. ولنا عودة لهذه المسألة ببحث مستقل يستوفي جميع الإشارات
المكثّفة الموجزة المرسلة ههنا.
الخلاصة:
بعد
تسنم الإمام الحكم مدة عشر سنوات، واستلام خليفته الحكم قرابة الثلاثين سنة لا
يوفرّ الشباب الإيراني اليوم فرصةً لمغادرة البلاد هرباً من الجبّ الذي يخنق
آمالهم، ويُحكم تطويق طموحاتهم.
تسنم الإمام الحكم مدة عشر سنوات، واستلام خليفته الحكم قرابة الثلاثين سنة لا
يوفرّ الشباب الإيراني اليوم فرصةً لمغادرة البلاد هرباً من الجبّ الذي يخنق
آمالهم، ويُحكم تطويق طموحاتهم.
وها
أنذا الآن في ألمانيا، وجميع أصدقائي من الإيرانيين الطيبين يدّعون أنهم مسيحيون،
ويبرزون الصلبان على صدورهم بطريقة استعراضية، وأسماؤهم: رضا، ومهدي، وحسن، وعلي
أنذا الآن في ألمانيا، وجميع أصدقائي من الإيرانيين الطيبين يدّعون أنهم مسيحيون،
ويبرزون الصلبان على صدورهم بطريقة استعراضية، وأسماؤهم: رضا، ومهدي، وحسن، وعلي
أتجاذب
معهم أطراف الحديث بودٍّ. فنتكلم عن ضريح شاه عبد العظيم في طهران، وضريح
المعصومة، وعن مقام الإمام الرضا، عليه السلام، في مشهد، وعن طقوسهم في صيام شهر
رمضان، وفي مراسم عاشوراء، وينسون لوهلة ادعاءهم أنهم مسيحيون!! وينسابون في حديث
ذكرياتهم، ويسترسلون فيه! أما أنا فأفكّر في هذا النظام المتعنّت الذي اضطرهم إلى
ترك بلادهم، والمجيء إلى ألمانيا، والادعاء بأنهم مسيحيون مضطهدون، ليحصلوا على حق
اللجوء! ولا غروَ! فالعنت يُخرج المرءَ من دينه بل من جلده!
معهم أطراف الحديث بودٍّ. فنتكلم عن ضريح شاه عبد العظيم في طهران، وضريح
المعصومة، وعن مقام الإمام الرضا، عليه السلام، في مشهد، وعن طقوسهم في صيام شهر
رمضان، وفي مراسم عاشوراء، وينسون لوهلة ادعاءهم أنهم مسيحيون!! وينسابون في حديث
ذكرياتهم، ويسترسلون فيه! أما أنا فأفكّر في هذا النظام المتعنّت الذي اضطرهم إلى
ترك بلادهم، والمجيء إلى ألمانيا، والادعاء بأنهم مسيحيون مضطهدون، ليحصلوا على حق
اللجوء! ولا غروَ! فالعنت يُخرج المرءَ من دينه بل من جلده!
لقد
استطاع الإمام الخميني لأول مرة بعد العصور الوسطى أن يقيم ديكتاتورية جديدة، لا
علاقة لها بديكتاتورية البروليتاريا، ولا ديكتاتورية المافيا أو العائلة، ولكنها
ديكتاتورية رجل الدين بسلطته القهرية المـُخضِعة، وبتسلّطه الفهلوي المتحذلق، ولكن
هيهات لها أن تدوم، فلكي يستمر شيء يجب أن يكون صحيحاً، ويجب أن يكون نافعاً.
استطاع الإمام الخميني لأول مرة بعد العصور الوسطى أن يقيم ديكتاتورية جديدة، لا
علاقة لها بديكتاتورية البروليتاريا، ولا ديكتاتورية المافيا أو العائلة، ولكنها
ديكتاتورية رجل الدين بسلطته القهرية المـُخضِعة، وبتسلّطه الفهلوي المتحذلق، ولكن
هيهات لها أن تدوم، فلكي يستمر شيء يجب أن يكون صحيحاً، ويجب أن يكون نافعاً.
ألمانيا
ــ إزرلون
ــ إزرلون
محمد أمير ناشر النعم
عن موقع درج