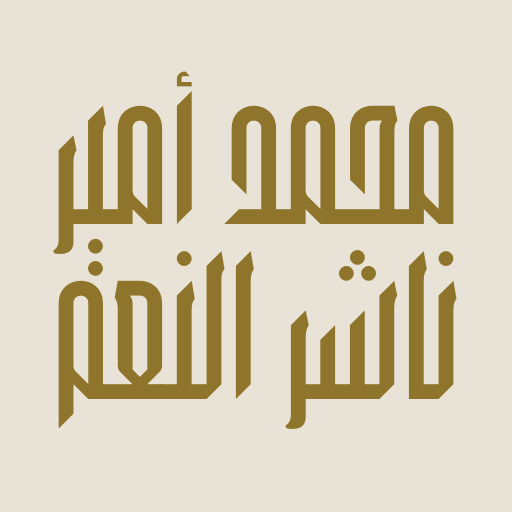كان
كانرأي العائلة قد استقر على استغلال أيام عيد الأضحى 2012 من أجل قطاف زيتون أرضنا.
كم استبشرنا بإعلان قبول الهدنة بين الأطراف المتنازعة، واستبشرنا كذلك بموسم
ممتاز، فالأمطار التي انهمرت روّت الأشجار وأنعشتها. ذهبنا في اليوم الأول من أيام
العيد فوجدنا الأرض موحلة يصعب المشي فيها، فقلنا: بعد يومين أوثلاث تصبح صالحة
لذلك.
في
اليوم الرابع من أيام العيد أفطرنا في البيت، ثم تنادى أفراد الأسرة من أجل الذهاب
إلى الأرض.كانت الساعة نحو التاسعة.
اليوم الرابع من أيام العيد أفطرنا في البيت، ثم تنادى أفراد الأسرة من أجل الذهاب
إلى الأرض.كانت الساعة نحو التاسعة.
لاح
بخيالي طيف جدة زوجتي البالغة من العمر أربعة وثمانين عاماً التي قتلت في اليوم
الثالث من أيام عيد (الفطر السعيد) الذي مررنا عليه تواً. كانت في بيتها في الحارة
الشرقية تسقي الزريعات، فاستهدفها قناص من الجيش، وعيّدها بأكثر من خمس عشرة
رصاصة، استقر منها ثلاث في صدرها، وتذكرت القتلى بين هذين العيدين من أقرباء
زوجتي: ابن خالها منهل سبلو البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً، الذي أصابته قذيفة
فقتلته وهو في شرفة منزله، وابن عمها وائل عريان الذي أصابته طلقة قناص وهو يشتري
الطعام لعائلته، ومن أصحابي: محمد باكير، بائع البن الذي يصغرني بثلاث سنوات. كنت
أزوره في كل أسبوع مرة، وأستأنس بالجلوس في دكانه، وبتجاذب أطراف الحديث معه،
وبمعابثته بشتى أنواع المعابثات، ذلك أنه كان لا يؤمن بالثورة، ولا يهضم الثوار.
قبل عدة أيام، وفي الساعة السابعة والنصف صباحاً كنت في دكانه أشتري ربع كيلو من
البن. سألني عن حكم شرعي فأجبته، ثم سألته عمّا أشيع من كون الثوار أخذوه للتحقيق
معه؟ أخبرني أن شلة من مسلحيهم كانت تقف أمام دكانه، وأنه في تلك الأثناء اتصل
بزوجته، وتحدث معها ووجهه إليهم، فظن أولئك أنه (فسفوس) يخبر عنهم، وبعد دقائق
كبسوا عليه، واقتادوه خارج الدكان، وأجروا معه تحقيقاً، انتهى برؤيتهم لرقم هاتف
منزله من خلال ذاكرة التليفون، وعندها قدّموا له اعتذاراً مختوماً بقولهم: (ولكن
لا تعد لمثلها مرة أخرى)!! في اليوم نفسه وقبيل المغرب سمعت المؤذّن ينعاه بعد أن
استقرت في صدره رصاصة قناص انطلقت من حاجز الجيش عند التل، وهذا ما جرى أيضاً
لصديقي الأستاذ محمد خير تريسي، وكان قد أخذ الإذن من نفس الحاجز للمرور لملء سلة
تين من أرضه، وفي اليوم الثاني أرسل جنود الحاجز لأسرته وأخبروهم أن المسلحين
قتلوه.. جاء أبناؤه ووجدوه مختبئاً في حفرة ونازفاً حتى الموت، كان جسده مازال
دافئاً مما يعني أنه ظل ينزف يومه وليلته، وقدّروا أنه ما كان يستطيع أن يمد رأسه
خارج تلك الحفرة خوفاً من أن يُقنص مرة أخرى، وكان جندي انشق عن ذلك الحاجز أخبرنا
بعد ذلك أن الضابط هو من أطلق عليه الرصاصة، وأنه ظل ينتظر أن يخرج هذا الرجل من
حفرته حتى يرديه، وبعد خمس ساعات من الانتظار قال لجنوده يبدو أنه مات ..
بخيالي طيف جدة زوجتي البالغة من العمر أربعة وثمانين عاماً التي قتلت في اليوم
الثالث من أيام عيد (الفطر السعيد) الذي مررنا عليه تواً. كانت في بيتها في الحارة
الشرقية تسقي الزريعات، فاستهدفها قناص من الجيش، وعيّدها بأكثر من خمس عشرة
رصاصة، استقر منها ثلاث في صدرها، وتذكرت القتلى بين هذين العيدين من أقرباء
زوجتي: ابن خالها منهل سبلو البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً، الذي أصابته قذيفة
فقتلته وهو في شرفة منزله، وابن عمها وائل عريان الذي أصابته طلقة قناص وهو يشتري
الطعام لعائلته، ومن أصحابي: محمد باكير، بائع البن الذي يصغرني بثلاث سنوات. كنت
أزوره في كل أسبوع مرة، وأستأنس بالجلوس في دكانه، وبتجاذب أطراف الحديث معه،
وبمعابثته بشتى أنواع المعابثات، ذلك أنه كان لا يؤمن بالثورة، ولا يهضم الثوار.
قبل عدة أيام، وفي الساعة السابعة والنصف صباحاً كنت في دكانه أشتري ربع كيلو من
البن. سألني عن حكم شرعي فأجبته، ثم سألته عمّا أشيع من كون الثوار أخذوه للتحقيق
معه؟ أخبرني أن شلة من مسلحيهم كانت تقف أمام دكانه، وأنه في تلك الأثناء اتصل
بزوجته، وتحدث معها ووجهه إليهم، فظن أولئك أنه (فسفوس) يخبر عنهم، وبعد دقائق
كبسوا عليه، واقتادوه خارج الدكان، وأجروا معه تحقيقاً، انتهى برؤيتهم لرقم هاتف
منزله من خلال ذاكرة التليفون، وعندها قدّموا له اعتذاراً مختوماً بقولهم: (ولكن
لا تعد لمثلها مرة أخرى)!! في اليوم نفسه وقبيل المغرب سمعت المؤذّن ينعاه بعد أن
استقرت في صدره رصاصة قناص انطلقت من حاجز الجيش عند التل، وهذا ما جرى أيضاً
لصديقي الأستاذ محمد خير تريسي، وكان قد أخذ الإذن من نفس الحاجز للمرور لملء سلة
تين من أرضه، وفي اليوم الثاني أرسل جنود الحاجز لأسرته وأخبروهم أن المسلحين
قتلوه.. جاء أبناؤه ووجدوه مختبئاً في حفرة ونازفاً حتى الموت، كان جسده مازال
دافئاً مما يعني أنه ظل ينزف يومه وليلته، وقدّروا أنه ما كان يستطيع أن يمد رأسه
خارج تلك الحفرة خوفاً من أن يُقنص مرة أخرى، وكان جندي انشق عن ذلك الحاجز أخبرنا
بعد ذلك أن الضابط هو من أطلق عليه الرصاصة، وأنه ظل ينتظر أن يخرج هذا الرجل من
حفرته حتى يرديه، وبعد خمس ساعات من الانتظار قال لجنوده يبدو أنه مات ..
تذكرت
هؤلاء الأحباء فقلت لنفسي: “الوضع غير آمن فلنبقَ في البيت”، ولكنني من
الشرفة رأيت أصحاب الأراضي والفَعَلة يتجهون إلى أرزاقهم، ومعهم السلالم و(القلوع)
لتحويش الزيتون وقطفه، فقلت مرة أخرى: يجب ألا نفقد أملنا! يجب أن يرى هؤلاء أننا
لا نخاف ولا نهاب.
هؤلاء الأحباء فقلت لنفسي: “الوضع غير آمن فلنبقَ في البيت”، ولكنني من
الشرفة رأيت أصحاب الأراضي والفَعَلة يتجهون إلى أرزاقهم، ومعهم السلالم و(القلوع)
لتحويش الزيتون وقطفه، فقلت مرة أخرى: يجب ألا نفقد أملنا! يجب أن يرى هؤلاء أننا
لا نخاف ولا نهاب.
ناديت
الأولاد: هيا إلى الأرض يا شباب.
الأولاد: هيا إلى الأرض يا شباب.
في
الطريق رأينا أكثر من عائلة تحوّش زيتونها، فزادنا ذلك اطمئناناً، وبرغم ذلك تساءل
صغيري عابد: هل يمكن أن يرشّونا؟ أجبته: لا يا روحي. الجيش لا يرش المدنيين.
أجابني: فكيف إذن قُتلت جدتنا ونائل ومنهل؟ أجبته: بالخطأ يا حبيبي بالخطأ…
فتبسم الولد في وجهي ابتسامة تسفيه لهذا الكلام.
الطريق رأينا أكثر من عائلة تحوّش زيتونها، فزادنا ذلك اطمئناناً، وبرغم ذلك تساءل
صغيري عابد: هل يمكن أن يرشّونا؟ أجبته: لا يا روحي. الجيش لا يرش المدنيين.
أجابني: فكيف إذن قُتلت جدتنا ونائل ومنهل؟ أجبته: بالخطأ يا حبيبي بالخطأ…
فتبسم الولد في وجهي ابتسامة تسفيه لهذا الكلام.
وصلنا
إلى أرضنا، وتجاوزنا سيارة جيراننا (البيك أب) الواقفة على حافة الطريق، وصففنا
سيارتنا بعدها بعشرة أمتار. استأنسنا وفرحنا لوجودهم بجانبنا. أنزل الأولاد العدة
بفرح وابتهاج، وعدَوْا صوب الأرض في طريق ترابي ندي رطب، لا تتجاوز مسافته ثمانين
متراً. سطعت الشمس من بين الغيوم فأرسلت أشعة متوهجة أنارت المكان كالفلاش، لكن
ظلت النسمات عليلة ومنعشة. بدأت العائلة بمد القلوع تحت أول شجرة، أما أنا فتناولت
القدوم، وبدأت أزيل فروع الأغضان النابتة في أسفل شجر التين. عندما أنهيت الشجرة
الأولى بدأنا نسمع صوت رصاص ينطلق قريباً منّا! تساءلنا: هل هم الثوار يطلقون
النار على حاجز (الكرّوم)؟ وقف الجميع متحفظاً مراقباً علّه يفهم ما يجري، لكن
تواتر إطلاق الرصاص غدا أكثر، وكان الصوت أقرب، عندها نادانا راشد: فلينبطح
الجميع! فتجمعنا وانبطحنا غير مدركين ما يجري، لكن حانت مني التفاتة فشاهدت رصاصة
تضرب إحدى الشجرات بجانبي.
إلى أرضنا، وتجاوزنا سيارة جيراننا (البيك أب) الواقفة على حافة الطريق، وصففنا
سيارتنا بعدها بعشرة أمتار. استأنسنا وفرحنا لوجودهم بجانبنا. أنزل الأولاد العدة
بفرح وابتهاج، وعدَوْا صوب الأرض في طريق ترابي ندي رطب، لا تتجاوز مسافته ثمانين
متراً. سطعت الشمس من بين الغيوم فأرسلت أشعة متوهجة أنارت المكان كالفلاش، لكن
ظلت النسمات عليلة ومنعشة. بدأت العائلة بمد القلوع تحت أول شجرة، أما أنا فتناولت
القدوم، وبدأت أزيل فروع الأغضان النابتة في أسفل شجر التين. عندما أنهيت الشجرة
الأولى بدأنا نسمع صوت رصاص ينطلق قريباً منّا! تساءلنا: هل هم الثوار يطلقون
النار على حاجز (الكرّوم)؟ وقف الجميع متحفظاً مراقباً علّه يفهم ما يجري، لكن
تواتر إطلاق الرصاص غدا أكثر، وكان الصوت أقرب، عندها نادانا راشد: فلينبطح
الجميع! فتجمعنا وانبطحنا غير مدركين ما يجري، لكن حانت مني التفاتة فشاهدت رصاصة
تضرب إحدى الشجرات بجانبي.
همست
قائلاً: إنهم يضربون علينا!
قائلاً: إنهم يضربون علينا!
قالت
زوجتي: غير معقول! ماذا فعلنا حتى يضربونا! هذا غير منطقي. لا مصلحة للثوار ولا
للجيش في أن يضربونا.
زوجتي: غير معقول! ماذا فعلنا حتى يضربونا! هذا غير منطقي. لا مصلحة للثوار ولا
للجيش في أن يضربونا.
بقينا
على هذه الحالة عشرة دقائق، كنا ننظر في وجوه بعضنا بعضاً مخبولين مذهولين. وانعقد
جنين الذعر فينا، فتشنجت ملامحنا، وماتت ابتساماتنا.
على هذه الحالة عشرة دقائق، كنا ننظر في وجوه بعضنا بعضاً مخبولين مذهولين. وانعقد
جنين الذعر فينا، فتشنجت ملامحنا، وماتت ابتساماتنا.
أمرت
الأولاد بالتفرق وبالاحتماء بشجر الزيتون، وكنت أول المتفرقين والراكضين إلى أقرب
شجرة. لاحقني الرصاص، ولكني نجوت وربصت خلف الشجرة محاولاً فهم ما يجري. كانت
عيناي معلقتين على أفراد العائلة، وعلى محاولة معرفة مصدر الرصاص. بعد خمس دقائق
أخرى توقف الأزيز، فناديت الجميع بأن نترك كل الأغراض، وأن نركض مفرقين باتجاه
السيارة. ركضنا نصف المسافة، ثم أوقفتنا رشات من الرصاص أحدقت بنا من كل جانب،
وبات صوت إطلاقها أقرب. شاهدت سيارة جيراننا تتلقى بضعة رصاصات، وسمعنا إحدى
الجارات تنادي أبناءها: انبطحوا انبطحوا. توقف الرصاص مرة أخرى، فهرعنا صوب
سيارتنا، وعلى مسافة عشرة أمتار منها انطلقت جحافل الرصاص من جديد، كانت زوجتي
وطفلي عبد الرحمن وراءنا فاستطاعا الاحتماء بجذع شجرة زيتون، أما أنا وبقية
أطفالي: راشد ومحمود وعلي فكنّا مكشوفين، فركضنا جميعاً بأقصى سرعتنا، وانبطحنا خلف دولاب السيارة الخلفي، ومباشرة
بدأ إطلاق النار على السيارة فتهشم زجاجها. عندها اكتمل نمو الذعر فينا، ومع كل
طلقة كان يمد الذعر رأسه، ويولد من عيوننا، وقسمات وجوهنا. صاحت زوجتي المختبئة
وراءنا على مسافة عشرين متر تقريباً بصوت٧ مرتجف: إنهم يطلقون الرصاص علينا! ويبدو
أنها لم تكن تدرك حتى الآن ما كنّا نتعرض له إلى أن رأتنا مختبئين وراء السيارة،
ورأت زجاجها يشظيه الرصاص.
الأولاد بالتفرق وبالاحتماء بشجر الزيتون، وكنت أول المتفرقين والراكضين إلى أقرب
شجرة. لاحقني الرصاص، ولكني نجوت وربصت خلف الشجرة محاولاً فهم ما يجري. كانت
عيناي معلقتين على أفراد العائلة، وعلى محاولة معرفة مصدر الرصاص. بعد خمس دقائق
أخرى توقف الأزيز، فناديت الجميع بأن نترك كل الأغراض، وأن نركض مفرقين باتجاه
السيارة. ركضنا نصف المسافة، ثم أوقفتنا رشات من الرصاص أحدقت بنا من كل جانب،
وبات صوت إطلاقها أقرب. شاهدت سيارة جيراننا تتلقى بضعة رصاصات، وسمعنا إحدى
الجارات تنادي أبناءها: انبطحوا انبطحوا. توقف الرصاص مرة أخرى، فهرعنا صوب
سيارتنا، وعلى مسافة عشرة أمتار منها انطلقت جحافل الرصاص من جديد، كانت زوجتي
وطفلي عبد الرحمن وراءنا فاستطاعا الاحتماء بجذع شجرة زيتون، أما أنا وبقية
أطفالي: راشد ومحمود وعلي فكنّا مكشوفين، فركضنا جميعاً بأقصى سرعتنا، وانبطحنا خلف دولاب السيارة الخلفي، ومباشرة
بدأ إطلاق النار على السيارة فتهشم زجاجها. عندها اكتمل نمو الذعر فينا، ومع كل
طلقة كان يمد الذعر رأسه، ويولد من عيوننا، وقسمات وجوهنا. صاحت زوجتي المختبئة
وراءنا على مسافة عشرين متر تقريباً بصوت٧ مرتجف: إنهم يطلقون الرصاص علينا! ويبدو
أنها لم تكن تدرك حتى الآن ما كنّا نتعرض له إلى أن رأتنا مختبئين وراء السيارة،
ورأت زجاجها يشظيه الرصاص.
كان
رأس محمود يطل من الجانب الخلفي للسيارة، وسمعت أزيز الرصاص يمر بقربه، فلففت رأسه
بيدي وضممته باتجاهي.
رأس محمود يطل من الجانب الخلفي للسيارة، وسمعت أزيز الرصاص يمر بقربه، فلففت رأسه
بيدي وضممته باتجاهي.
قال
لي: إنني أرتجف، لكنني غير خائف!
لي: إنني أرتجف، لكنني غير خائف!
فأمسكت
بيده وشددت عليها، ونظرت في عينيه مشجعاً، وحاولت أن أبتسم زيادة في طمأنته، لكن
عضلات وجهي لم تستجب لي.
بيده وشددت عليها، ونظرت في عينيه مشجعاً، وحاولت أن أبتسم زيادة في طمأنته، لكن
عضلات وجهي لم تستجب لي.
ضممت
علياً بين رجليّ، وحضنته مائلاً عليه، وقرفص راشد على يميني، ومحمود على يساري.
كان الرصاص يمر من فوق رؤوسنا، أما ما دون ذلك فكانت السيارة تتكفل بصده عنّا، إلى
أن مرّت زخة من الرصاصات من تحت السيارة. أدركت أن الرصاصات تلامس الأرض وتتشخط
بها، وتضرب فخذيَّ علي. صاح الولد باكياً: بابا لقد أصبت. فأجبته مباشرة: لا لم
تصب لقد مرت الرصاصات بجانبنا فقط. نظرت إلى بنطاله وقد فتحت فيه فتحتان، وغطّت
الدماء حضه.
علياً بين رجليّ، وحضنته مائلاً عليه، وقرفص راشد على يميني، ومحمود على يساري.
كان الرصاص يمر من فوق رؤوسنا، أما ما دون ذلك فكانت السيارة تتكفل بصده عنّا، إلى
أن مرّت زخة من الرصاصات من تحت السيارة. أدركت أن الرصاصات تلامس الأرض وتتشخط
بها، وتضرب فخذيَّ علي. صاح الولد باكياً: بابا لقد أصبت. فأجبته مباشرة: لا لم
تصب لقد مرت الرصاصات بجانبنا فقط. نظرت إلى بنطاله وقد فتحت فيه فتحتان، وغطّت
الدماء حضه.
صاحت
زوجتي: هل أصيب؟
زوجتي: هل أصيب؟
أجبتها:
لا أدري ربما.
لا أدري ربما.
أنصتُّ
إلى صوت إطلاق الرصاص فبدأت أسمع صوت الفوارغ وهي ترتطم بالأرض، فأدركت أن الموت
الزاحف يتجه صوبنا. ناديت زوجتي: سوف أتسلل إلى داخل السيارة، حتى إذا صرت خلف
المقود، اركضي مع عابد إليها.
إلى صوت إطلاق الرصاص فبدأت أسمع صوت الفوارغ وهي ترتطم بالأرض، فأدركت أن الموت
الزاحف يتجه صوبنا. ناديت زوجتي: سوف أتسلل إلى داخل السيارة، حتى إذا صرت خلف
المقود، اركضي مع عابد إليها.
وقلت
لراشد ومحمود: عندما أشغلها اركبوا فيها وانبطحوا.
لراشد ومحمود: عندما أشغلها اركبوا فيها وانبطحوا.
لم
أنهِ جملتي حتى نادتني زوجتي: دعني أركض إلى السيارة، وحين أشغلها اركبوا جميعاً،
لأنهم إذا رأوني فسوف يوقفون إطلاق النار.
أنهِ جملتي حتى نادتني زوجتي: دعني أركض إلى السيارة، وحين أشغلها اركبوا جميعاً،
لأنهم إذا رأوني فسوف يوقفون إطلاق النار.
فصرخت:
بل إذا رأوك سيقتلونك. ابقي في مكانك، ولا تتحركي.
بل إذا رأوك سيقتلونك. ابقي في مكانك، ولا تتحركي.
استجمعت
أنفاسي وناديت بصوت مبحوح: أيها الشباب! لا تطلقوا النار. نحن عائلة مكونة من
أولاد. وقد أصيب ولد منّا. لا تطلقوا النار.
أنفاسي وناديت بصوت مبحوح: أيها الشباب! لا تطلقوا النار. نحن عائلة مكونة من
أولاد. وقد أصيب ولد منّا. لا تطلقوا النار.
ونادى
راشد بصوت أعلى من صوتي، وكرر الكلام نفسه، لكن وتيرة إطلاق الرصاص ازدادت.
راشد بصوت أعلى من صوتي، وكرر الكلام نفسه، لكن وتيرة إطلاق الرصاص ازدادت.
بقينا
في وضعيتنا نفسها، وكنت أشير
بكفي إلى زوجتي أن تلازم مكانها، وفي هذه الأثناء ظل الرصاص يتسلل بيننا، فيضرب
السيارة مرة، والأرض أخرى، وجذوع الأشجار مرة ثالثة. شاهدت على بعد ثلاثمة متر خلف
السيارة عربة (ب. إم. ب) توجّه فوهة مدفعها باتجاهنا، ففكرت أنها إذا أطلقت قذيفة
على السيارة فسنقتل جميعاً، وستستأصل أسرتي كلها، فقلت للأولاد: يجب أن نفرّ إلى
داخل الأرض، ثم نتجه شمالاً إلى أن نصل إلى طريق الضيعة، وقلت لمحمود: فلتتبعني
أولاً، ثم راشد ثانياً، وناديت زوجتي بصوت خفيض، وطلبت منها أن تتبعنا.
في وضعيتنا نفسها، وكنت أشير
بكفي إلى زوجتي أن تلازم مكانها، وفي هذه الأثناء ظل الرصاص يتسلل بيننا، فيضرب
السيارة مرة، والأرض أخرى، وجذوع الأشجار مرة ثالثة. شاهدت على بعد ثلاثمة متر خلف
السيارة عربة (ب. إم. ب) توجّه فوهة مدفعها باتجاهنا، ففكرت أنها إذا أطلقت قذيفة
على السيارة فسنقتل جميعاً، وستستأصل أسرتي كلها، فقلت للأولاد: يجب أن نفرّ إلى
داخل الأرض، ثم نتجه شمالاً إلى أن نصل إلى طريق الضيعة، وقلت لمحمود: فلتتبعني
أولاً، ثم راشد ثانياً، وناديت زوجتي بصوت خفيض، وطلبت منها أن تتبعنا.
استجمعت
قواي، وتنفست نفساً عميقاً، ثم حملت علياً بين ذراعي، فصرخ وتأوّه، وانطلقت
والرصاصَ بأقصى سرعة مسافة ثلاثين متراً، ومرّ محمود بجانبي وتجاوزني، وظل مخترقاً
الأرض إلى أن غاب عن نظري، التفتُّ إلى زوجتي فرأيتها تهرول متعثرة مع صغيري عبد
الرحمن، وشاهدت بأم عيني الرصاص يلفهما كالزوبعة من كل جانب، فصرخت: أسرعي أسرعي.
قواي، وتنفست نفساً عميقاً، ثم حملت علياً بين ذراعي، فصرخ وتأوّه، وانطلقت
والرصاصَ بأقصى سرعة مسافة ثلاثين متراً، ومرّ محمود بجانبي وتجاوزني، وظل مخترقاً
الأرض إلى أن غاب عن نظري، التفتُّ إلى زوجتي فرأيتها تهرول متعثرة مع صغيري عبد
الرحمن، وشاهدت بأم عيني الرصاص يلفهما كالزوبعة من كل جانب، فصرخت: أسرعي أسرعي.
كان
الرصاص يلاحقني أيضاً، فجمّعت طاقتي كلها وتابعت ركضي، ولكنني لم أتجاوز العشرين
متراً حتى فقدت كل الطاقة في جسدي، فانهرت وارتميت على الأرض، غير أني جهدت ألا
أقع فوق علي.
الرصاص يلاحقني أيضاً، فجمّعت طاقتي كلها وتابعت ركضي، ولكنني لم أتجاوز العشرين
متراً حتى فقدت كل الطاقة في جسدي، فانهرت وارتميت على الأرض، غير أني جهدت ألا
أقع فوق علي.
صرخت
زوجتي بصوت مجروح مخنوق: أمير… هل أصبت؟
زوجتي بصوت مجروح مخنوق: أمير… هل أصبت؟
ناديتها
ونظرت في عيونها: لا… ولكن تعثرت.. لا تخافي تابعي الجري.
ونظرت في عيونها: لا… ولكن تعثرت.. لا تخافي تابعي الجري.
صرختْ
مرة أخرى: محمود! أين أنت يا محمود!
مرة أخرى: محمود! أين أنت يا محمود!
لم
يجب محمود.
يجب محمود.
نادتني:
لقد قتل محمود. لقد قتل محمود.
لقد قتل محمود. لقد قتل محمود.
صرخت:
لم يُقتل، ولكنه ابتعد، وما عاد يسمع صوتنا.
لم يُقتل، ولكنه ابتعد، وما عاد يسمع صوتنا.
أخذتُ
عدة أنفاس ثم نهضت حاملاً علياً وتابعت ركضي، شعرت أن المسافة تطوى تحت قدمي،
وغابت الأصوات. كنا نركض صعوداً. شاهدت راشد ورائي، ولمحت هناء وعابد خلفه في
ركضهما المتعثر. لم يبقّ بيننا وبين الشارع سوى مئة متر، نقطعها في منحدر خفيف،
وإذا وصلنا إليه فإننا نكون قد غبنا عن أعين القتلة بالتأكيد.
عدة أنفاس ثم نهضت حاملاً علياً وتابعت ركضي، شعرت أن المسافة تطوى تحت قدمي،
وغابت الأصوات. كنا نركض صعوداً. شاهدت راشد ورائي، ولمحت هناء وعابد خلفه في
ركضهما المتعثر. لم يبقّ بيننا وبين الشارع سوى مئة متر، نقطعها في منحدر خفيف،
وإذا وصلنا إليه فإننا نكون قد غبنا عن أعين القتلة بالتأكيد.
وصلت
أولاً مع علي، ثم تلانا راشد، ثم هناء وعابد، وبعد قليل ظهر محمود أمامنا. نظرت
إلى الخلف وقدّرت أن الخطر ما زال قائماً. كان الجميع قد وضع يده على خاصرته وهو
يلهث، نظرت أمامي فوجدت الطريق ينحدر ثم يرتفع ثم ينحدر، فصرخت: يجب أن نسرع إلى
المنحدر الثاني حتى نغيب تماماً عن أعين القناصة وعن رصاصهم.
أولاً مع علي، ثم تلانا راشد، ثم هناء وعابد، وبعد قليل ظهر محمود أمامنا. نظرت
إلى الخلف وقدّرت أن الخطر ما زال قائماً. كان الجميع قد وضع يده على خاصرته وهو
يلهث، نظرت أمامي فوجدت الطريق ينحدر ثم يرتفع ثم ينحدر، فصرخت: يجب أن نسرع إلى
المنحدر الثاني حتى نغيب تماماً عن أعين القناصة وعن رصاصهم.
وقبل
أن أركض أنزلت علياً على الأرض، وملأت رئتاي هواءً، ثم أمسكت يديه فرفعتهما، وطوقت
بهما عنقي، وحملته على ظهري، وبدأت بالجري، بذلت أقصى وسعي، لأنني كنت لا أزال
أشعر بالخطر المحدق بنا، أما العائلة فأصبحت ورائي، وغدت المسافة الفاصلة بيننا
حوالي الخمسين متراً. التفتُّ وناديتهم من أجل ألا يتباطؤوا، وهنا شعرت أن قواي قد
خارت تماماً، فطلبت من راشد أن يأتي إلي ويحمل عني علياً، فحمله بالطريقة نفسها
التي كنت أحمله بها، وأمرته أن يركض أمامي، وانتظرت إلى أن وصل بقية أفراد الأسرة،
ثم شددت من عزيمتهم، وأمسكت بيد عابد وتابعنا الركض إلى أن بدأنا ننحدر في الطريق
وغابت عنا أرضنا تماماً، وبدأنا نرى أفواج الفلاحين الذين سمعوا جميعاً أصوات
الرصاص فطفقوا يلملمون أغراضهم هرباً.
أن أركض أنزلت علياً على الأرض، وملأت رئتاي هواءً، ثم أمسكت يديه فرفعتهما، وطوقت
بهما عنقي، وحملته على ظهري، وبدأت بالجري، بذلت أقصى وسعي، لأنني كنت لا أزال
أشعر بالخطر المحدق بنا، أما العائلة فأصبحت ورائي، وغدت المسافة الفاصلة بيننا
حوالي الخمسين متراً. التفتُّ وناديتهم من أجل ألا يتباطؤوا، وهنا شعرت أن قواي قد
خارت تماماً، فطلبت من راشد أن يأتي إلي ويحمل عني علياً، فحمله بالطريقة نفسها
التي كنت أحمله بها، وأمرته أن يركض أمامي، وانتظرت إلى أن وصل بقية أفراد الأسرة،
ثم شددت من عزيمتهم، وأمسكت بيد عابد وتابعنا الركض إلى أن بدأنا ننحدر في الطريق
وغابت عنا أرضنا تماماً، وبدأنا نرى أفواج الفلاحين الذين سمعوا جميعاً أصوات
الرصاص فطفقوا يلملمون أغراضهم هرباً.
استقبلني
فلاح في الخمسين من العمر، وسألني: أرجو ألا تكون إصابة الصغير خطيرة؟
فلاح في الخمسين من العمر، وسألني: أرجو ألا تكون إصابة الصغير خطيرة؟
فأجبته
لاهثاً: إنها في فخذيه.
لاهثاً: إنها في فخذيه.
واساني
وطمأن خاطري، وركض معي إلى أن وصلنا إلى شاحنة صغيرة، لونها أبيض مغبر، كأنها أتان
عتيقة واقفة على جانب الطريق، فأشار إليّ أن أضع الصبي فيها. صعدت زوجتي إلى
الصندوق، ثم ناولتها علياً فوضعته في حضنها، ثم شرعنا نبحث عن صاحب السيارة. كانت
النساء والأولاد يخرجن من الأراضي ويسألننا عما جرى معنا، وكنّا نجيب باختصار
لاهث، ثم نطلب منهن أن يبحثن معنا عن صاحب السيارة، وخلال دقائق ظهر صاحب السيارة،
كان شاباً دون سن العشرين.
وطمأن خاطري، وركض معي إلى أن وصلنا إلى شاحنة صغيرة، لونها أبيض مغبر، كأنها أتان
عتيقة واقفة على جانب الطريق، فأشار إليّ أن أضع الصبي فيها. صعدت زوجتي إلى
الصندوق، ثم ناولتها علياً فوضعته في حضنها، ثم شرعنا نبحث عن صاحب السيارة. كانت
النساء والأولاد يخرجن من الأراضي ويسألننا عما جرى معنا، وكنّا نجيب باختصار
لاهث، ثم نطلب منهن أن يبحثن معنا عن صاحب السيارة، وخلال دقائق ظهر صاحب السيارة،
كان شاباً دون سن العشرين.
قال
له الفلاح الخمسيني: خذهم إلى الضيعة، وذكر مكاناً فيها لم أتبينه.
له الفلاح الخمسيني: خذهم إلى الضيعة، وذكر مكاناً فيها لم أتبينه.
صعدنا
نحن الستة في صندوق الشاحنة، وبدأت السيارة تخب فينا، وكنا نشاهد على طول الطريق
أفواج المزارعين وأهاليهم، وهم يغذون السير باتجاه الضيعة بعد سماعهم أصوات الرصاص
الذي كان ينهمر علينا.
نحن الستة في صندوق الشاحنة، وبدأت السيارة تخب فينا، وكنا نشاهد على طول الطريق
أفواج المزارعين وأهاليهم، وهم يغذون السير باتجاه الضيعة بعد سماعهم أصوات الرصاص
الذي كان ينهمر علينا.
وفي
فترة وجيزة كنّا في الضيعة التي لم تكن تبعد سوى بضعة دقائق. اخترقت السيارة
حاراتها إلى أن وصلنا إلى حارة ضيقة ومغلقة. ترجلنا من السيارة فبادرتنا نسوة
الحارة وشبابها، وكانوا كأنهم على علم بما جرى معنا.
فترة وجيزة كنّا في الضيعة التي لم تكن تبعد سوى بضعة دقائق. اخترقت السيارة
حاراتها إلى أن وصلنا إلى حارة ضيقة ومغلقة. ترجلنا من السيارة فبادرتنا نسوة
الحارة وشبابها، وكانوا كأنهم على علم بما جرى معنا.
اقترب
أحد الشباب قائلاً: سنعالجه هنا، وأشار إلى باب تحت الأرض. خمنت أنه باب زريبة أو مستودع.
كان مغلقاً بسلسلة معدنية وقفل. فسألته: ألا يوجد مستوصف أوعيادة نأخذه إليها؟
فأجابني: لا.. الجميع معيّد، ثم إننا نداوي جرحانا في هذا المكان دائماً.
أحد الشباب قائلاً: سنعالجه هنا، وأشار إلى باب تحت الأرض. خمنت أنه باب زريبة أو مستودع.
كان مغلقاً بسلسلة معدنية وقفل. فسألته: ألا يوجد مستوصف أوعيادة نأخذه إليها؟
فأجابني: لا.. الجميع معيّد، ثم إننا نداوي جرحانا في هذا المكان دائماً.
ظللنا
واقفين في مكاننا حوالي ربع ساعة حتى جاء المسؤول عن المكان، وكان في أرضه خارج
الضيعة. نزلنا إلى قبو مساحته كبيرة وسقفه مصلّب ومرتفع، وحجارته قديمة بل أثرية،
وخمنت أن يكون هذا المكان معصرة زيت قديمة.
واقفين في مكاننا حوالي ربع ساعة حتى جاء المسؤول عن المكان، وكان في أرضه خارج
الضيعة. نزلنا إلى قبو مساحته كبيرة وسقفه مصلّب ومرتفع، وحجارته قديمة بل أثرية،
وخمنت أن يكون هذا المكان معصرة زيت قديمة.
وضعت
الطفل على حصير، ثم صعدت إلى الخارج. سألت الشباب: من الذي سيأتي ويعالج الصبي؟
فقيل لي: لقد أرسلنا في طلب الطبيب. إنه في أرضه خارج الضيعة.
الطفل على حصير، ثم صعدت إلى الخارج. سألت الشباب: من الذي سيأتي ويعالج الصبي؟
فقيل لي: لقد أرسلنا في طلب الطبيب. إنه في أرضه خارج الضيعة.
اقتربت
إحدى نسوة الحارة من زوجتي ودعتها والأولاد إلى المنزل. فذهب الجميع وظلّ معي
راشد. انتظرنا حوالي نصف ساعة قضيناها ما بين القبو والشارع في انتظار الطبيب. وفي
أثناء ذلك خاطبت الشباب في نزق ولهفة: كلما سألت واحداً منكم عن الطبيب أجابني لقد
أرسلنا وراءه! أخشى ألا يكون قد ذهب أحد لإحضاره! فأجابوني بثقة: بل لقد أرسلنا من
يأتي به فاطمئن ولا تهتم.
إحدى نسوة الحارة من زوجتي ودعتها والأولاد إلى المنزل. فذهب الجميع وظلّ معي
راشد. انتظرنا حوالي نصف ساعة قضيناها ما بين القبو والشارع في انتظار الطبيب. وفي
أثناء ذلك خاطبت الشباب في نزق ولهفة: كلما سألت واحداً منكم عن الطبيب أجابني لقد
أرسلنا وراءه! أخشى ألا يكون قد ذهب أحد لإحضاره! فأجابوني بثقة: بل لقد أرسلنا من
يأتي به فاطمئن ولا تهتم.
نصف
ساعة هي أطول مدة انتظار أقضيها في حياتي، لأنني في حقيقة الأمر لم أكن أعلم حتى
تلك اللحظة طبيعة إصابة علي، كنت أرجو أن تكون في الفخذين فقط، لكنني خمنت أيضاً
من خلال الدماء التي غطت بطنه وفخذيه أن تكون الرصاصات قد اخترقت أحشاءه.
ساعة هي أطول مدة انتظار أقضيها في حياتي، لأنني في حقيقة الأمر لم أكن أعلم حتى
تلك اللحظة طبيعة إصابة علي، كنت أرجو أن تكون في الفخذين فقط، لكنني خمنت أيضاً
من خلال الدماء التي غطت بطنه وفخذيه أن تكون الرصاصات قد اخترقت أحشاءه.
وصل
الطبيب، وكان دون الخامسة والأربعين من العمر، وكان معه مساعده. طلب منه أن يجرد
الصبي من ثيابه، فجرده من البنطال أولاً، وهنا شاهدت ثلاث فتحات، الأولى فوق
الركبة بطول 2سم، والثانية في الفخذ الأيمن بطول سبعة سم، والثالثة في الفخذ
الأيسر بطول 20سم.
الطبيب، وكان دون الخامسة والأربعين من العمر، وكان معه مساعده. طلب منه أن يجرد
الصبي من ثيابه، فجرده من البنطال أولاً، وهنا شاهدت ثلاث فتحات، الأولى فوق
الركبة بطول 2سم، والثانية في الفخذ الأيمن بطول سبعة سم، والثالثة في الفخذ
الأيسر بطول 20سم.
حتى
هذه اللحظة كان الشك يراودني في أننا إذا خلعنا السروال الداخلي فسنجد ما يسوؤنا،
فربما كانت الرصاصات قد اخترقت خصيتيه، أو مثانته، أو كليته؟ لست أدري، لأن الدم
كان يقطر من السروال الداخلي بعد أن صبغه بلونه القاني، ومع ذلك كنت في غاية
التسليم والاطمئنان، حتى إذا ما قصّ الممرض السروال ونزعه ورأيت المنطقة سليمة
أظلمت عيناي من شدة الفرح، فما عدت أرى الوجوه، ولا أسمع الأصوات. تهلل وجهي
فرحاً، وارتسمت ابتسامة وصلت إلى شحمتي أذني، وشعرت بزهو الانتصار على حراب الاحتمالات
السيئة والمرعبة التي كانت تحاول اختراق شغاف قلبي، فأمسكتها بيدي، وحطمتها تحت
قدمي، وعندها فقط جلست قرب كومة حطب مجمّعة في زاوية القبو، وقلت لراشد: اذهب
وبشّر أمك بسلامته.
هذه اللحظة كان الشك يراودني في أننا إذا خلعنا السروال الداخلي فسنجد ما يسوؤنا،
فربما كانت الرصاصات قد اخترقت خصيتيه، أو مثانته، أو كليته؟ لست أدري، لأن الدم
كان يقطر من السروال الداخلي بعد أن صبغه بلونه القاني، ومع ذلك كنت في غاية
التسليم والاطمئنان، حتى إذا ما قصّ الممرض السروال ونزعه ورأيت المنطقة سليمة
أظلمت عيناي من شدة الفرح، فما عدت أرى الوجوه، ولا أسمع الأصوات. تهلل وجهي
فرحاً، وارتسمت ابتسامة وصلت إلى شحمتي أذني، وشعرت بزهو الانتصار على حراب الاحتمالات
السيئة والمرعبة التي كانت تحاول اختراق شغاف قلبي، فأمسكتها بيدي، وحطمتها تحت
قدمي، وعندها فقط جلست قرب كومة حطب مجمّعة في زاوية القبو، وقلت لراشد: اذهب
وبشّر أمك بسلامته.
كنا
في القبو حوالي عشرة أشخاص، وكلهم دون الخامسة والعشرين، ما عداي وعدا الطبيب. صاح
أحدهم: أين الشاي؟ ألن تسقوا ضيفنا الشاي؟ وكان الشاي في طريقه إلينا. صبت
الأقداح، فتناولت كاساً، وكانت حلاوتها تكفي لقبيلة، لكنني رشفتها وشعرت أنها أطيب
كأس أشربه في حياتي، بدأ الجميع يخرجون سجائرهم ويدخنون. ناولني شاب سيكارة فترددت
لبرهة، ثم أخذتها شاكراً وشربتها، سألني الشاب يبدو أنك غير مدخن؟ فأجبته:بلى.
والتفتُ إلى راشد وقلت له: إذا أردت أن تدخن فخذ واحدة. ابتسم الولد، وقال وقد وضع
يده على صدره في إشارة عفاف: يسلموا.
في القبو حوالي عشرة أشخاص، وكلهم دون الخامسة والعشرين، ما عداي وعدا الطبيب. صاح
أحدهم: أين الشاي؟ ألن تسقوا ضيفنا الشاي؟ وكان الشاي في طريقه إلينا. صبت
الأقداح، فتناولت كاساً، وكانت حلاوتها تكفي لقبيلة، لكنني رشفتها وشعرت أنها أطيب
كأس أشربه في حياتي، بدأ الجميع يخرجون سجائرهم ويدخنون. ناولني شاب سيكارة فترددت
لبرهة، ثم أخذتها شاكراً وشربتها، سألني الشاب يبدو أنك غير مدخن؟ فأجبته:بلى.
والتفتُ إلى راشد وقلت له: إذا أردت أن تدخن فخذ واحدة. ابتسم الولد، وقال وقد وضع
يده على صدره في إشارة عفاف: يسلموا.
دخنّا
جميعاً حتى الطبيب، وهو يقطّب الجرح كان يدخّن. دخنت معهم، وتمنيت في سري أنه لو وجد
حشيش لدخنته أيضاً. ولكنه لم يكن موجوداً، أما آلام علي في الأيام بل الشهرين
التاليين فكانت تفوق الوصف، ولما أبل من جراحه واستطاع أن يمشي بمفرده لأول مرة
سألته: هل تسامح الجندي الذي ضربك يا بني؟ أجابني: لقد سامحته.
جميعاً حتى الطبيب، وهو يقطّب الجرح كان يدخّن. دخنت معهم، وتمنيت في سري أنه لو وجد
حشيش لدخنته أيضاً. ولكنه لم يكن موجوداً، أما آلام علي في الأيام بل الشهرين
التاليين فكانت تفوق الوصف، ولما أبل من جراحه واستطاع أن يمشي بمفرده لأول مرة
سألته: هل تسامح الجندي الذي ضربك يا بني؟ أجابني: لقد سامحته.
محمد أمير ناشر النعم