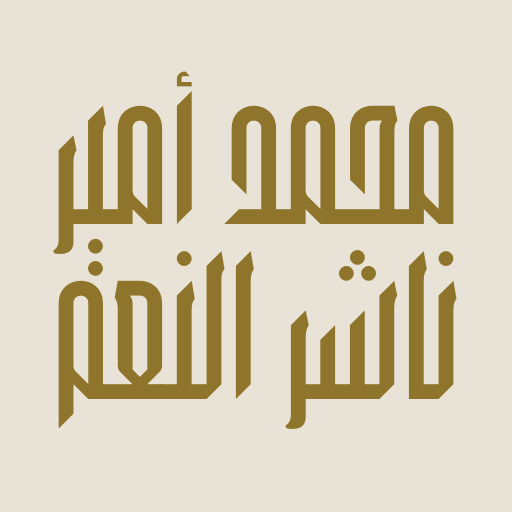يُعدّ التراث الإسلامي
المكتوب باللغة العربية، وفق معظم الدارسين في الشرق والغرب، من أعظم خزائن
المعرفة في تاريخ البشرية، وهو يغطي عملياً كلّ جوانب الثقافة الإسلامية، ويمتاز
بغنى المصادر التاريخية الشاملة مثل: السجلات، ومجموعات السِّير الذاتية (كتب
التراجم والطبقات) التي تُعد بالمئات، وتتناول هذه النصوص العديدة كلّ جانب من
جوانب التاريخ والثقافة: الفتوحات، وتقلبات الأسر الحاكمة، والاضطرابات الحضرية،
والثورات، وأسعار المواد الغذائية، والتجارة البعيدة المدى، والكوارث الطبيعية،
والجوائح والأمراض، وأي شيء آخر يمكن تصوّره والتفكير فيه.
المكتوب باللغة العربية، وفق معظم الدارسين في الشرق والغرب، من أعظم خزائن
المعرفة في تاريخ البشرية، وهو يغطي عملياً كلّ جوانب الثقافة الإسلامية، ويمتاز
بغنى المصادر التاريخية الشاملة مثل: السجلات، ومجموعات السِّير الذاتية (كتب
التراجم والطبقات) التي تُعد بالمئات، وتتناول هذه النصوص العديدة كلّ جانب من
جوانب التاريخ والثقافة: الفتوحات، وتقلبات الأسر الحاكمة، والاضطرابات الحضرية،
والثورات، وأسعار المواد الغذائية، والتجارة البعيدة المدى، والكوارث الطبيعية،
والجوائح والأمراض، وأي شيء آخر يمكن تصوّره والتفكير فيه.
ورغم أنّ نسبة التراث
المطبوع إلى المخطوط ضئيلة جداً فإنّ هذا التراث المطبوع يمدّنا بمادة علمية غنيّة
بمضمونها، وتغرقنا في لجّة من المعلومات، مما يحتّم علينا اتباع تكتيكات
وإستراتيجيات ناجعة للإبحار فيها بأمان، ومخضها واجتباء زبدتها باحتراف.
المطبوع إلى المخطوط ضئيلة جداً فإنّ هذا التراث المطبوع يمدّنا بمادة علمية غنيّة
بمضمونها، وتغرقنا في لجّة من المعلومات، مما يحتّم علينا اتباع تكتيكات
وإستراتيجيات ناجعة للإبحار فيها بأمان، ومخضها واجتباء زبدتها باحتراف.
وفي هذا المجال سنقع على رأي
صادم رغم أنّه لن يتجاوز تصوير الواقع ووصفه، وهو قول المستشرق الألماني المعاصر
كلاوس كلير: “ما زال الاستشراق بوجه عام، والبحث في تاريخ المشرق بوجه خاص
في طور الطفولة إلى حدٍّ بعيد“، وسوف يقرّر في كتابه المهم (خالد وعمر:
بحث نقدي في مصادر التاريخ الإسلامي المبكر) أنّه لا يوجد حتى هذه اللحظة كتابٌ
تعليمي في نقد المراجع التاريخية، في المجال الإسلامي! ومن أجل تدارك هذا
النقص يُقدّم لنا حوالي خمسة عشر مقترحاً في منهجية التعامل مع كتب التاريخ
الإسلامي، ومن هذه المقترحات (استخدام الطرائق الكمّية) حيث يُجمِل في أسطر
مكثّفة حسنات استخدامها، من دون أن يغفل عن ذكر محاذيرها. يقول: “لقد استعملتُ
في بحثي طرائق كمّية في كثير من المواضيع، وكنت في أثناء ذلك أكتسب المرة بعد
الأخرى خبرة مؤدّاها أنّ الإحصاء المتأني لبداية موصوفة بدقّة يتيح التوصّل إلى
نتائج هامة، على أنّ الحكم لا يتمّ إضفاء الصفة الموضوعية عليه من جرّاء ذلك
بالضرورة، لأنّ النزعة الذاتية لم يتوافر لها بعد ميدان واسع قائم بذاته من جرّاء
وضع معايير الاختيار وتفسير الأحداث، غير أنّ التحليل الكمّي يعاكس مصدراً مشهوراً
للأخطاء، وهو الحكم العفوي على أساسٍ قليل من الوقائع، وعندما يكون المرء قد سبق
له أن درس دراسة تمهيدية كمّية يستطيع أن يقدّم نتائج أبحاثه في كثير من الأحيان،
في قالب أكثر إقناعاً […] إلا أنّه ينبغي للمرء أن يكون واعياً تجاه خطر
الموضوعية الظاهرية”.
صادم رغم أنّه لن يتجاوز تصوير الواقع ووصفه، وهو قول المستشرق الألماني المعاصر
كلاوس كلير: “ما زال الاستشراق بوجه عام، والبحث في تاريخ المشرق بوجه خاص
في طور الطفولة إلى حدٍّ بعيد“، وسوف يقرّر في كتابه المهم (خالد وعمر:
بحث نقدي في مصادر التاريخ الإسلامي المبكر) أنّه لا يوجد حتى هذه اللحظة كتابٌ
تعليمي في نقد المراجع التاريخية، في المجال الإسلامي! ومن أجل تدارك هذا
النقص يُقدّم لنا حوالي خمسة عشر مقترحاً في منهجية التعامل مع كتب التاريخ
الإسلامي، ومن هذه المقترحات (استخدام الطرائق الكمّية) حيث يُجمِل في أسطر
مكثّفة حسنات استخدامها، من دون أن يغفل عن ذكر محاذيرها. يقول: “لقد استعملتُ
في بحثي طرائق كمّية في كثير من المواضيع، وكنت في أثناء ذلك أكتسب المرة بعد
الأخرى خبرة مؤدّاها أنّ الإحصاء المتأني لبداية موصوفة بدقّة يتيح التوصّل إلى
نتائج هامة، على أنّ الحكم لا يتمّ إضفاء الصفة الموضوعية عليه من جرّاء ذلك
بالضرورة، لأنّ النزعة الذاتية لم يتوافر لها بعد ميدان واسع قائم بذاته من جرّاء
وضع معايير الاختيار وتفسير الأحداث، غير أنّ التحليل الكمّي يعاكس مصدراً مشهوراً
للأخطاء، وهو الحكم العفوي على أساسٍ قليل من الوقائع، وعندما يكون المرء قد سبق
له أن درس دراسة تمهيدية كمّية يستطيع أن يقدّم نتائج أبحاثه في كثير من الأحيان،
في قالب أكثر إقناعاً […] إلا أنّه ينبغي للمرء أن يكون واعياً تجاه خطر
الموضوعية الظاهرية”.
منذ 1950 بدأ المؤرخون الغربيون باستخدام الطرائق الإحصائية في الدراسات
التاريخية المتعلقة بالسكان والبناء الاجتماعي، وقامت جامعة ستانفورد سنة 1968 بتطوير برنامج الإحصاء والتحليل للعلوم الاجتماعية SPSS، وبتخزين البيانات على بطاقات مثقوبة، ومع بداية السبعينات بدأت
هذه الطرائق تتسلل إلى مجال دراسات التاريخ العربي والإسلامي، وكان المؤرخ والمستشرق الأمريكي ريتشارد دبليو بوليت من
أوائل من استخدم هذه الطريقة، ففي سنة 1970 نشر في مجلة (التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق) مقالاً عنوانه:
(منهج كمّي لمعاجم السِّير المسلمة في العصور الوسطى)، ثم نشر سنة 1972 كتاب (علماء
نيسابور: دراسة في التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى)، وفي سنة 1979 أخرج لنا كتاب:
(اعتناق الإسلام في العصور
الوسطى: مقال في التاريخ الكمي)، وعلى الرغم من ظهور أول كومبيوتر شخصي
سنة 1983 فإنّ معظم الدراسات التي نهجت المنهج الكمي في السبعينات
والثمانينات اعتمدت على استخدام الفرز ميكانيكياً: بطاقات الفهرسة، البطاقات
المثقبة، ثم أجهزة الكومبيوتر المبكرة التي تخزّن البيانات على أشرطة مغناطيسية.
التاريخية المتعلقة بالسكان والبناء الاجتماعي، وقامت جامعة ستانفورد سنة 1968 بتطوير برنامج الإحصاء والتحليل للعلوم الاجتماعية SPSS، وبتخزين البيانات على بطاقات مثقوبة، ومع بداية السبعينات بدأت
هذه الطرائق تتسلل إلى مجال دراسات التاريخ العربي والإسلامي، وكان المؤرخ والمستشرق الأمريكي ريتشارد دبليو بوليت من
أوائل من استخدم هذه الطريقة، ففي سنة 1970 نشر في مجلة (التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق) مقالاً عنوانه:
(منهج كمّي لمعاجم السِّير المسلمة في العصور الوسطى)، ثم نشر سنة 1972 كتاب (علماء
نيسابور: دراسة في التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى)، وفي سنة 1979 أخرج لنا كتاب:
(اعتناق الإسلام في العصور
الوسطى: مقال في التاريخ الكمي)، وعلى الرغم من ظهور أول كومبيوتر شخصي
سنة 1983 فإنّ معظم الدراسات التي نهجت المنهج الكمي في السبعينات
والثمانينات اعتمدت على استخدام الفرز ميكانيكياً: بطاقات الفهرسة، البطاقات
المثقبة، ثم أجهزة الكومبيوتر المبكرة التي تخزّن البيانات على أشرطة مغناطيسية.
وفي السبعينات
بدأ العرب أنفسهم بالتنبّه إلى هذا المجال، فاشتغل الدكتور التونسي المنجي الكعبي
على حوسبة بعض تراجم كتاب (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) لابن العماد الحنبلي،
وكذلك اشتغل الدكتور الأردني أحمد الحسو على حوسبة مئة ترجمة من كتاب (الضوء
اللامع لأهل القرن التاسع) للسخاوي، أما الباحث السوري برهان البخاري فكان جامح
الطموح، فنذر نفسه لإعادة بناء الثقافة العربية حاسوبياً، وابتدأ أولاً بمشروع
أتمتة (الحديث النبوي الشريف)، وكان يطمح إلى حوسبة الببليوغرافيا العربية
والمعاجم الرجالية واللغوية ومعاجم البلدان والبقاع، والنصوص الدينية والأدبية،
وتحويلها إلى مكتبة رقمية تستطيع برامج الكومبيوتر معالجة مواضيعها بطرق سريعة
ودقيقة.
بدأ العرب أنفسهم بالتنبّه إلى هذا المجال، فاشتغل الدكتور التونسي المنجي الكعبي
على حوسبة بعض تراجم كتاب (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) لابن العماد الحنبلي،
وكذلك اشتغل الدكتور الأردني أحمد الحسو على حوسبة مئة ترجمة من كتاب (الضوء
اللامع لأهل القرن التاسع) للسخاوي، أما الباحث السوري برهان البخاري فكان جامح
الطموح، فنذر نفسه لإعادة بناء الثقافة العربية حاسوبياً، وابتدأ أولاً بمشروع
أتمتة (الحديث النبوي الشريف)، وكان يطمح إلى حوسبة الببليوغرافيا العربية
والمعاجم الرجالية واللغوية ومعاجم البلدان والبقاع، والنصوص الدينية والأدبية،
وتحويلها إلى مكتبة رقمية تستطيع برامج الكومبيوتر معالجة مواضيعها بطرق سريعة
ودقيقة.
أما
الدكتور المصري مصطفى زايد فكتب سنة 1997 كتاب (الإحصاء والبحث التاريخي)، وسنة 2000 (التاريخ الكمّي مع تطبيقات في التاريخ الإسلامي).
الدكتور المصري مصطفى زايد فكتب سنة 1997 كتاب (الإحصاء والبحث التاريخي)، وسنة 2000 (التاريخ الكمّي مع تطبيقات في التاريخ الإسلامي).
واعتمد الدكتور سيار الجميل وسائل
البحث الكمّي، ضمن المنهجية التي اتبعها في كتابه: (المجايلة التاريخية: فلسفة
التكوين التاريخي. نظرة رؤيوية في المعرفة العربية الإسلامية) الذي أصدره سنة 1999، وخصّص فيه فصلاً للحديث عن (حاجتنا
إلى التاريخ الكمّي (= الجدولي) والتحليل القياسي).
البحث الكمّي، ضمن المنهجية التي اتبعها في كتابه: (المجايلة التاريخية: فلسفة
التكوين التاريخي. نظرة رؤيوية في المعرفة العربية الإسلامية) الذي أصدره سنة 1999، وخصّص فيه فصلاً للحديث عن (حاجتنا
إلى التاريخ الكمّي (= الجدولي) والتحليل القياسي).
في هذه الأثناء كانت
تكنولوجيا المعلومات تقفز قفزات هائلة، وشهدت المكتبة العربية عملية أتمتة هائلة، ما كان يحلم بها أحد من هؤلاء
الباحثين، الذين كانت تتناول بحوثهم أجزاء من كتاب واحد، فإذا بهم خلال عقدين من
الزمان يتاح لهم آلاف الكتب التراثية بصيغ إلكترونية.
تكنولوجيا المعلومات تقفز قفزات هائلة، وشهدت المكتبة العربية عملية أتمتة هائلة، ما كان يحلم بها أحد من هؤلاء
الباحثين، الذين كانت تتناول بحوثهم أجزاء من كتاب واحد، فإذا بهم خلال عقدين من
الزمان يتاح لهم آلاف الكتب التراثية بصيغ إلكترونية.
وفي عامي
2009 و2010 بدأ
تسويق برنامج SPSS تحت اسم SPSS Statistics والذي أتاح إجراء
عمليات إحصائية تراكمية يمكن معها تحديد العلاقات الثنائية والمركبة بين معلومة
وأخرى، أو مجموعة معلومات غيرها مما له علاقة بها، وهكذا وفّر إمكانيات بحثية هائلة.
2009 و2010 بدأ
تسويق برنامج SPSS تحت اسم SPSS Statistics والذي أتاح إجراء
عمليات إحصائية تراكمية يمكن معها تحديد العلاقات الثنائية والمركبة بين معلومة
وأخرى، أو مجموعة معلومات غيرها مما له علاقة بها، وهكذا وفّر إمكانيات بحثية هائلة.
أما أهم عمل يمكن ذكره في
هذا الصدد فهو رسالة الدكتوراة التي قدّمها المستشرق مكسيم رومانوف في جامعة
ميشيغان سنة 2013 بعنوان:
(القراءة الحاسوبية لمجموعات السِّير الذاتية العربية في العالم السني ما بين عامي
661 و1300م)، ويُعد هذا الباحث اليوم من
أهم منظّري مبادئ الاستخراج والمعالجة الرقمية للبيانات من المصادر العربية، وأهم
مطبّق لما ينظِّر له، وقد قام بمسح أكثر من ثلاثين ألف نصّ عربي من خلال المكتبات
على النت: (المكتبة الشاملة)، و(المشكاة)، و(صيد الفوائد)، و(الورّاق)، و(مكتبة
الشيعة)، بالإضافة إلى مكتبات رقمية على أقراص مضغوطة، كمكتبة المجمّع الفقهي في
قم. إيران، ومكتبة الجامع الكبير. عمّان. الأردن.
هذا الصدد فهو رسالة الدكتوراة التي قدّمها المستشرق مكسيم رومانوف في جامعة
ميشيغان سنة 2013 بعنوان:
(القراءة الحاسوبية لمجموعات السِّير الذاتية العربية في العالم السني ما بين عامي
661 و1300م)، ويُعد هذا الباحث اليوم من
أهم منظّري مبادئ الاستخراج والمعالجة الرقمية للبيانات من المصادر العربية، وأهم
مطبّق لما ينظِّر له، وقد قام بمسح أكثر من ثلاثين ألف نصّ عربي من خلال المكتبات
على النت: (المكتبة الشاملة)، و(المشكاة)، و(صيد الفوائد)، و(الورّاق)، و(مكتبة
الشيعة)، بالإضافة إلى مكتبات رقمية على أقراص مضغوطة، كمكتبة المجمّع الفقهي في
قم. إيران، ومكتبة الجامع الكبير. عمّان. الأردن.
كما أنّه قام بتحليل رقمي مستقل
لكتاب (تاريخ الإسلام) للإمام الذهبي الذي يضم حوالي ثلاثين ألف ترجمة، وبتحليل كتاب
(هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنّفين) لاستكشف الإنتاج الثقافي
الإسلامي حتى بداية القرن العشرين، حيث ذكر مؤلف الكتاب إسماعيل باشا البغدادي المتوفى
سنة 1920 حوالي ثمانية آلاف وثمانمئة
مؤلف، وأربعين ألف عنوان كتاب.
لكتاب (تاريخ الإسلام) للإمام الذهبي الذي يضم حوالي ثلاثين ألف ترجمة، وبتحليل كتاب
(هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنّفين) لاستكشف الإنتاج الثقافي
الإسلامي حتى بداية القرن العشرين، حيث ذكر مؤلف الكتاب إسماعيل باشا البغدادي المتوفى
سنة 1920 حوالي ثمانية آلاف وثمانمئة
مؤلف، وأربعين ألف عنوان كتاب.
لمكسيم رومانوف مدونة اسمها:
al Raqmiyyat، يشرح لنا فيها عن لغات البرمجة في أنماط البحث التاريخي، عن
تجريد المعلومة، وتفسيرها، وعن تحليله الخوارزمي لمجموعات السير العربية، وعن
مبادرة النصوص
الإسلامية (OpenITI) ، التي تجمع علماء من جامعة لايبزيغ، وجامعة
ماريلاند (كوليدج بارك)، وجامعة أغاخان (لندن)، وجامعة فيينا، وتهدف إلى بناء أول
مجموعة علمية تدرس النصوص الإسلامية آلياً باعتماد خوارزميات الكومبيوتر.
al Raqmiyyat، يشرح لنا فيها عن لغات البرمجة في أنماط البحث التاريخي، عن
تجريد المعلومة، وتفسيرها، وعن تحليله الخوارزمي لمجموعات السير العربية، وعن
مبادرة النصوص
الإسلامية (OpenITI) ، التي تجمع علماء من جامعة لايبزيغ، وجامعة
ماريلاند (كوليدج بارك)، وجامعة أغاخان (لندن)، وجامعة فيينا، وتهدف إلى بناء أول
مجموعة علمية تدرس النصوص الإسلامية آلياً باعتماد خوارزميات الكومبيوتر.
وله أيضاً بحث بعنوان: (تحليل خوارزمي للقرون الوسطى
العربية: مجموعات السِّير الذاتية)، ويحدثنا في هذا البحث عن برامج الكومبيوتر التي يستخدمها في معالجة النصوص
العربية، وعن خطوات
تحليل الخوارزميات، من العثور على نصٍّ مقروء آلياً، إلى تجميع
كلمات رؤوس الفصول، وتحديد علاماتها وكياناتها المحدّدة، وتصنيف الوسوم: أسماء
الأماكن، أسماء الأشخاص، الأسماء الوصفية (فقيه، مفت، قاض، طبيب، مفسر، إلخ)،
تواريخ السنين، العلامات الاجتماعية، المهنية، الإثنية، أنماط الكتب التي ألّفها
المؤلفون، وإثراء البيانات وإعادة تشكيلها وتنظيمها، في مجموعات فرعية لمجموعات
منوّعة، علامات التسلسل الزمني، والجغرافي، ويشرح لنا حلول إزالة الالتباس والغموض
(كيف نفرّق، على سبيل المثال، ما بين طرابلس بلاد الشام وطرابلس الغرب).
العربية: مجموعات السِّير الذاتية)، ويحدثنا في هذا البحث عن برامج الكومبيوتر التي يستخدمها في معالجة النصوص
العربية، وعن خطوات
تحليل الخوارزميات، من العثور على نصٍّ مقروء آلياً، إلى تجميع
كلمات رؤوس الفصول، وتحديد علاماتها وكياناتها المحدّدة، وتصنيف الوسوم: أسماء
الأماكن، أسماء الأشخاص، الأسماء الوصفية (فقيه، مفت، قاض، طبيب، مفسر، إلخ)،
تواريخ السنين، العلامات الاجتماعية، المهنية، الإثنية، أنماط الكتب التي ألّفها
المؤلفون، وإثراء البيانات وإعادة تشكيلها وتنظيمها، في مجموعات فرعية لمجموعات
منوّعة، علامات التسلسل الزمني، والجغرافي، ويشرح لنا حلول إزالة الالتباس والغموض
(كيف نفرّق، على سبيل المثال، ما بين طرابلس بلاد الشام وطرابلس الغرب).
وفي
هذه المدونة نقرأ أيضاً بحثه بعنوان: (التغطية الزمنية لمجموعة عربية: تجربة مع
بيانات التاريخ)، وفيها تطبيق ممتاز لعمل الخوارزميات في استنباط البيانات
والمخططات والخرائط من المادة التاريخية التي يتمّ تناولها ومعالجتها.
هذه المدونة نقرأ أيضاً بحثه بعنوان: (التغطية الزمنية لمجموعة عربية: تجربة مع
بيانات التاريخ)، وفيها تطبيق ممتاز لعمل الخوارزميات في استنباط البيانات
والمخططات والخرائط من المادة التاريخية التي يتمّ تناولها ومعالجتها.
إنّ
البيئة الجديدة للبحث توفر للمؤرخين فرصة للتحقق مما إذا كان هنالك نصّ معيّن مدرج
في مجموعة معيّنة، وكيف تترابط الكتب وتتكامل، أو كيف يتداخل بعضها ببعض، وكيف
تتشابك الأحداث التاريخية المختلفة، وكيف ترتبط المصطلحات والمفاهيم مع بعضها
بعضاً، وكيف تتطور عبر الزمان والمكان.
البيئة الجديدة للبحث توفر للمؤرخين فرصة للتحقق مما إذا كان هنالك نصّ معيّن مدرج
في مجموعة معيّنة، وكيف تترابط الكتب وتتكامل، أو كيف يتداخل بعضها ببعض، وكيف
تتشابك الأحداث التاريخية المختلفة، وكيف ترتبط المصطلحات والمفاهيم مع بعضها
بعضاً، وكيف تتطور عبر الزمان والمكان.
وسوف
تقودنا تلك الآليات إلى اكتشاف أخطاء كبيرة في كتب الأنساب
والأدب واللغة والتاريخ، وكذلك إلى اكتشاف الانحيازات المعرفية والسياسية، لصالح
مذهب، أو بلد، أو حقبة تاريخية، وكلّ من طبّق هذا النمط من الدراسة حدّثنا عن
اكتشافاته ومفاجآته كبرهان البخاري، حين درس أعلام الزركلي والموسوعة العربية
الميسرة، وقارن بينهما، والدكتور أحمد
الحسو، في دراسته حول (الواقع الحضاري لمدينة الموصل في عهد السيطرة المغولية
الإيلخانية)، والدكتور هاني الرفوع في أطروحته الدكتوراة (الحياة الثقافية
والعلمية في بغداد في عهد الدولة الإيلخانية).
تقودنا تلك الآليات إلى اكتشاف أخطاء كبيرة في كتب الأنساب
والأدب واللغة والتاريخ، وكذلك إلى اكتشاف الانحيازات المعرفية والسياسية، لصالح
مذهب، أو بلد، أو حقبة تاريخية، وكلّ من طبّق هذا النمط من الدراسة حدّثنا عن
اكتشافاته ومفاجآته كبرهان البخاري، حين درس أعلام الزركلي والموسوعة العربية
الميسرة، وقارن بينهما، والدكتور أحمد
الحسو، في دراسته حول (الواقع الحضاري لمدينة الموصل في عهد السيطرة المغولية
الإيلخانية)، والدكتور هاني الرفوع في أطروحته الدكتوراة (الحياة الثقافية
والعلمية في بغداد في عهد الدولة الإيلخانية).
يقول كلاوس كلير: “لا
يكاد يوجد محيط ثقافي تتوافر، تحت تصرّفه، على مدى الماضي الذي يمتد وراءه على
مسافة شاسعة، مادة من الكتابة التاريخية غنية المضمون كهذه المادة التي تتوافر في
العالم الإسلامي، وقد فضّت في الحقيقة جهود نفر جمّ من العلماء في العقود الأخيرة
جزءاً لا يُستهان به من كنوز المكتبات العربية، ومجموعات المخطوطات، ولكن لم يتحقق
بعدُ في مضمار التحقيق الجيد للنصوص القديمة سوى الخطوة الأولى لاستغلال هذه
المادة، وكان ينبغي أن تعقبها الخطوة التالية الأصعب: إذ لا بدّ من تقويم النصوص
الجديدة
تقييماً نقدياً، ولكن ما زال من الواجب القيام بالكثير الذي لا نهاية له في هذا
الميدان من ميادين العلم، فالمزيد من نصوص المراجع لا يؤدي، بصورة آلية، إلى فهمٍ
أفضل للعصر الذي نتحدث عنه”.
يكاد يوجد محيط ثقافي تتوافر، تحت تصرّفه، على مدى الماضي الذي يمتد وراءه على
مسافة شاسعة، مادة من الكتابة التاريخية غنية المضمون كهذه المادة التي تتوافر في
العالم الإسلامي، وقد فضّت في الحقيقة جهود نفر جمّ من العلماء في العقود الأخيرة
جزءاً لا يُستهان به من كنوز المكتبات العربية، ومجموعات المخطوطات، ولكن لم يتحقق
بعدُ في مضمار التحقيق الجيد للنصوص القديمة سوى الخطوة الأولى لاستغلال هذه
المادة، وكان ينبغي أن تعقبها الخطوة التالية الأصعب: إذ لا بدّ من تقويم النصوص
الجديدة
تقييماً نقدياً، ولكن ما زال من الواجب القيام بالكثير الذي لا نهاية له في هذا
الميدان من ميادين العلم، فالمزيد من نصوص المراجع لا يؤدي، بصورة آلية، إلى فهمٍ
أفضل للعصر الذي نتحدث عنه”.
وأقول: ربما أدّت بنا القراءة الكمّية، واعتماد آليات
تكنولوجيا المعلومات إلى هذا الفهم الأفضل.
تكنولوجيا المعلومات إلى هذا الفهم الأفضل.
محمد أمير ناشر النعم
المصدر: https://www.syria.tv/content/تحليل-التاريخ-الإسلامي-خوارزمياً