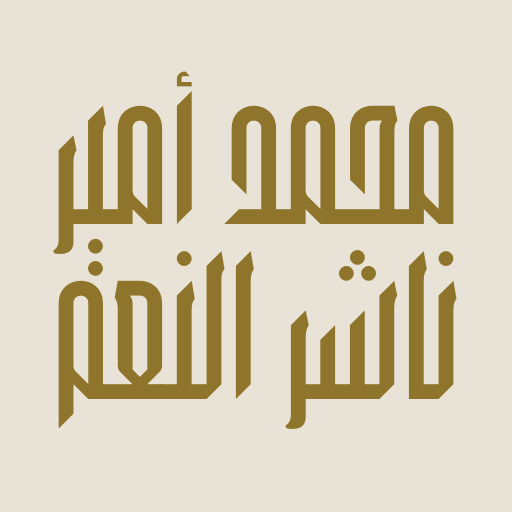إنه
عنوان كتاب المؤرخ والمستشرق والروائي الأمريكي ريتشارد دبليو بوليت المولود
سنة 1940،
والمتخرج من جامعة هارفارد سنة 1967، والمتقاعد سنة 2015 بعد سبع
وأربعين سنة من التدريس في أقسام التاريخ في جامعات كولومبيا وهارفارد وبيركلي،
وخلال هذه المسيرة العلمية التعليمية المديدة المشفوعة بإنتاج أكاديمي رصين أثبت
بوليت أنه تميّز عن باقي المؤرخين في أنه كان دائم الطرح لأسئلة غير معتادة، أو
غير مطروقة سابقاً، وأنه كان يستكشف طرقاً مبتكرة في محاولة الإجابة عنها.
والمتخرج من جامعة هارفارد سنة 1967، والمتقاعد سنة 2015 بعد سبع
وأربعين سنة من التدريس في أقسام التاريخ في جامعات كولومبيا وهارفارد وبيركلي،
وخلال هذه المسيرة العلمية التعليمية المديدة المشفوعة بإنتاج أكاديمي رصين أثبت
بوليت أنه تميّز عن باقي المؤرخين في أنه كان دائم الطرح لأسئلة غير معتادة، أو
غير مطروقة سابقاً، وأنه كان يستكشف طرقاً مبتكرة في محاولة الإجابة عنها.
 ركّزت
ركّزتكتاباته المبكرة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للإسلام في القرون الوسطى،
وبعد الثورة الإسلامية الإيرانية أصبح أكثر اهتماماً بالشؤون الإسلامية المعاصرة،
ولا سيما التيارات السياسية الدينية في العالم الإسلامي، وكان له أطروحة مضادة
لهنتينغتون وبرنارد لويس مجتمعَين كشف عنها في كتابه (دفاعًا عن مقولة:
الحضارة الإسلامية-المسيحية) الذي ترجمته دار النهار، وطبعته سنة 2005،
وقد رأى أنه من الخطأ أن يعبّر عن الحضارة الغربية بأنها “الحضارة اليهودية
ــ المسيحية”، ودلل على أن الأدق والأوفق أن يعبّر عنها بــ “الحضارة
الإسلامية ــ المسيحية”، ولأن مثل هذا الطرح كان يوحي بتعاطف هائل مع الإسلام
إلى درجة يظن المرء فيها أن صاحبه مسلم فإنه كان يصرح، ربما على سبيل الدعابة،
بأنه ليس مسلماً، وليس له أقارب مسلمون.
وتكشف
لنا قائمة كتبه الصادرة حتى هذه اللحظة أن اهتماماته انصبت على ثلاثة مجالات
مختلفة تمام الاختلاف:
لنا قائمة كتبه الصادرة حتى هذه اللحظة أن اهتماماته انصبت على ثلاثة مجالات
مختلفة تمام الاختلاف:
أولاً:
الإسلام بعوالمه الماضية والحاضرة.
الإسلام بعوالمه الماضية والحاضرة.
ثانياً:
تاريخ علاقات الإنسان بالحيوان.
تاريخ علاقات الإنسان بالحيوان.
ثالثاً:
تاريخ التكنولوجية القديمة.
تاريخ التكنولوجية القديمة.
لكن
ما يهمنا من كتبه الآن هو كتابه الفريد (اعتناق الإسلام في العصور الوسطى: مقال في
التاريخ الكمّي) الصادر سنة 1979 عن جامعة هارفارد، ورغم أهمية هذا
الكتاب، وفرادة تناول موضوعه، وأهمية النتائج التي توصل إليها المؤلف فإنه لم يُشر
إليه في الوطن العربي، وبالتالي لم يُستفد منه، ومن نتائجه.
ما يهمنا من كتبه الآن هو كتابه الفريد (اعتناق الإسلام في العصور الوسطى: مقال في
التاريخ الكمّي) الصادر سنة 1979 عن جامعة هارفارد، ورغم أهمية هذا
الكتاب، وفرادة تناول موضوعه، وأهمية النتائج التي توصل إليها المؤلف فإنه لم يُشر
إليه في الوطن العربي، وبالتالي لم يُستفد منه، ومن نتائجه.
يكشف
هذا الكتاب عن لَبس خامر تصوراتنا حول
هذا الكتاب عن لَبس خامر تصوراتنا حول
التحوّل
الشعبي إلى الإسلام في منطقة الشرق الأوسط، فقد تمّ الخلط بين شبه الجزيرة العربية
وبين ما جاورها من بلدان، عندما وسّعنا مدلول سورة الفتح في حديثها عن الدخول في
{دين الله أفواجاً}، فظننا أنّ عملية التحوّل السريع الخاطف الذي شهدناه في شبه
الجزيرة العربية نحو الإسلام خلال العقود الأولى من عمر الدعوة الإسلامية تمّ بنفس
النسبة والسرعة في بلاد العراق والشام ومصر، أو حتى في بلاد فارس وإسبانيا.
لقد
كان اعتناق الإسلام حدثاً هائلاً جللاً في تاريخ البشرية غيّر تاريخ العالم
بتوحيده شعوب الشرق الأوسط في دين جديد، وبخلق إمبراطورية عالمية واسعة المدى
والنطاق، وكان يجدر بالباحثين أن يدرسوا نِسَب هذا التحوّل بالقياس إلى كل بلد من
البلدان، وكيف كانت تتصاعد هذه النِّسَب مع مرور الوقت، ولكن ربما كانوا معذورين
لأنهم لم يهتدوا إلى وسائل القياس وآلياته التي تتيح لهم ملاحظة هذه النِّسَب
الكمِّيَّة، ورصدها بطريقة أقرب ما تكون إلى الواقع من جهة، وإلى اتباع منهجية
علمية لا شطح فيها ولا تعسُّف من جهة أخرى.
كان اعتناق الإسلام حدثاً هائلاً جللاً في تاريخ البشرية غيّر تاريخ العالم
بتوحيده شعوب الشرق الأوسط في دين جديد، وبخلق إمبراطورية عالمية واسعة المدى
والنطاق، وكان يجدر بالباحثين أن يدرسوا نِسَب هذا التحوّل بالقياس إلى كل بلد من
البلدان، وكيف كانت تتصاعد هذه النِّسَب مع مرور الوقت، ولكن ربما كانوا معذورين
لأنهم لم يهتدوا إلى وسائل القياس وآلياته التي تتيح لهم ملاحظة هذه النِّسَب
الكمِّيَّة، ورصدها بطريقة أقرب ما تكون إلى الواقع من جهة، وإلى اتباع منهجية
علمية لا شطح فيها ولا تعسُّف من جهة أخرى.
ومن
هنا أتت أهمية محاولة بوليت في رسمه مخططات بيانية لكلٍّ من المناطق التالية:
(إيران ــ العراق ــ سورية ــ مصر ــ تونس ــ إسبانيا)، ترصد نِسَب تحوّل شعوبها
إلى الإسلام على مرِّ السنين، ويقول في ذلك: “لقد تمّ اشتقاق الرسوم
البيانية بطريقة منهجية من مجموعة كبيرة وموثوقة من البيانات، ولكن يجب أن يظل
المعنى المخصص للرسوم البيانية مسألة تفسير. وحتى في الحالات الأكثر مباشرة، فإن
غياب البيانات المستقلة القابلة للقياس الكمّي يشكّل عقبة لا يمكن التغلب عليها.
على أنه إذا لم يكن بإمكان المرء أن يضع ثقته الكاملة في التفاصيل الدقيقة لرسم
بيانيٍّ معيَّن، فإنّ هذا لا يعفيه من أن يجد فيه محفِّزاً للتفكير في مدلولاته
التاريخية”.
هنا أتت أهمية محاولة بوليت في رسمه مخططات بيانية لكلٍّ من المناطق التالية:
(إيران ــ العراق ــ سورية ــ مصر ــ تونس ــ إسبانيا)، ترصد نِسَب تحوّل شعوبها
إلى الإسلام على مرِّ السنين، ويقول في ذلك: “لقد تمّ اشتقاق الرسوم
البيانية بطريقة منهجية من مجموعة كبيرة وموثوقة من البيانات، ولكن يجب أن يظل
المعنى المخصص للرسوم البيانية مسألة تفسير. وحتى في الحالات الأكثر مباشرة، فإن
غياب البيانات المستقلة القابلة للقياس الكمّي يشكّل عقبة لا يمكن التغلب عليها.
على أنه إذا لم يكن بإمكان المرء أن يضع ثقته الكاملة في التفاصيل الدقيقة لرسم
بيانيٍّ معيَّن، فإنّ هذا لا يعفيه من أن يجد فيه محفِّزاً للتفكير في مدلولاته
التاريخية”.
وسوف
نختار ههنا من جملة الجداول والمخططات البيانية العديدة الخاصة بكل إقليم من هذه
الأقاليم جدولاً جامعاً يلخص لنا نتائج الكتاب الأساسية، ويعطينا زبدة هذا التاريخ
الكمِّي، ويتناول الجدول نسبة الدخول في الإسلام من القرن الأول حتى الرابع
الهجري/ من القرن السابع حتى العاشر الميلادي:
نختار ههنا من جملة الجداول والمخططات البيانية العديدة الخاصة بكل إقليم من هذه
الأقاليم جدولاً جامعاً يلخص لنا نتائج الكتاب الأساسية، ويعطينا زبدة هذا التاريخ
الكمِّي، ويتناول الجدول نسبة الدخول في الإسلام من القرن الأول حتى الرابع
الهجري/ من القرن السابع حتى العاشر الميلادي:
|
السنوات
بالهجري |
إيران
|
العراق
|
سورية
|
مصر
|
إسبانيا
|
|
نسبة
المسلمين مع نهاية أول مئة عام |
5 %
|
3 %
|
2 %
|
2 %
|
أقل
من 1 % |
|
السنوات
التي صارت النسبة فيها 25 % من السكان |
185
|
225
|
275
|
275
|
295
|
|
السنوات
التي صارت النسبة فيها 50 % من السكان |
235
|
280
|
330
|
330
|
355
|
|
السنوات
التي صارت النسبة فيها 75 % من السكان |
280
|
320
|
385
|
385
|
400
|
إنّ
هذه النِّسَب، وقد لا تكون دقيقة مئة بالمئة، لا بدّ من أن تدفعنا لإثارة أسئلة
عديدة:
هذه النِّسَب، وقد لا تكون دقيقة مئة بالمئة، لا بدّ من أن تدفعنا لإثارة أسئلة
عديدة:
ــ
ما أسباب هذا التحوّل؟ وما دوافعه وبواعثه؟
ما أسباب هذا التحوّل؟ وما دوافعه وبواعثه؟
ــ
لماذا كانت نسبة التحوّل في إيران والعراق أسرع من بلاد الشام ومصر؟
لماذا كانت نسبة التحوّل في إيران والعراق أسرع من بلاد الشام ومصر؟
ــ
لماذا نرى نِسَب التحوّل في بلاد الشام ومصر متطابقة؟
لماذا نرى نِسَب التحوّل في بلاد الشام ومصر متطابقة؟
ــ
لماذا كانت نسبة الدخول إلى الإسلام في إسبانيا أعلى في زمن ملوك الطوائف منها في
زمن الخلافة الأموية في الأندلس.
لماذا كانت نسبة الدخول إلى الإسلام في إسبانيا أعلى في زمن ملوك الطوائف منها في
زمن الخلافة الأموية في الأندلس.
ــ
هل كانت نِسَب التحوّل في تلك الأقاليم متساوية ما بين الأرياف والمدن؟ أم أن
الريف كان أبطأ في التحوّل؟ وما سبب ذلك؟
هل كانت نِسَب التحوّل في تلك الأقاليم متساوية ما بين الأرياف والمدن؟ أم أن
الريف كان أبطأ في التحوّل؟ وما سبب ذلك؟
ــ
ما عواقب تجاوز عتبة تحوّل شعوب هذه المناطق عتبة الـ 50 % من السكان
على السلطة السياسية؟
ما عواقب تجاوز عتبة تحوّل شعوب هذه المناطق عتبة الـ 50 % من السكان
على السلطة السياسية؟
وقد
حاول بوليت أن يجيب على هذه الأسئلة ومثيلاتها سواءً في فصول الكتاب المتعددة، أو
في فصله الأخير الذي عنونه بــ (عواقب التحويل)، إجابات تحمل معنى الاستنتاج
والخلاصات، ويبقى الاستنتاج الأهم والأبرز في نظر المؤلف هو أنّ التحوّل إلى
الإسلام كان يؤدي إلى إضعاف الحكومة المركزية أو تفككها، وهذه النتيجة تبيّن أنّ
نشوء القيادة السياسية وتطورها جاء استجابةً لاحتياجات المجتمع الإسلامي في تثبيت
وجوده، من دون أن يُنظر إليها على أنها مادة إيمان أو أن تُعدَّ عنصراً ضرورياً في
علاقة الإنسان بالله، لذلك تضاءلت أهمية وجود مؤسسة سياسية مركزية مع تضاؤل حاجة
المجتمع إليها، لامتلاكه الثقة بذاته، ولشعوره أنّ الإسلام غدا طريقة حياة مستقرة
ودائمة، ولم يعد مهدَّداً بالديانات المحلية الأخرى، وللتدليل على هذا الاستنتاج
يستعرض المؤلف حالات تاريخية لاحقة تؤكد كلامه، فعند كل تهديد لحوزة الإسلام كان
يتمّ اللجوء إلى فكرة الخلافة أو ما يعادلها، وفي هذا السياق يفسِّر المؤلف موافقة
مسلمي إسبانيا على الانضواء تحت راية المرابطين ثم الموحدين في مواجهة القوى
المسيحية الإسبانية المضادة، ويُفسّر أيضاً تجديد الاهتمام بمنصب الخليفة في نهاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، عندما بدا أنّ الإمبريالية الغربية تهدِّد
أسس المجتمع المسلم، ويدرك المؤلف ههنا أنّ هذه النتيجة تتعارض مباشرةً مع المفهوم
الأساسي للإسلام بوصفه ديناً شاملاً يوحِّد جميع جوانب الحياة، فلطالما شعر
المسلمون المعاصرون بأنّ الإسلام يشتمل على نظرية سياسية إسلامية تستند إليها
مؤسسة سياسية مركزية، لكن يبدو أنّ المعطى التاريخي، بحسب المؤلف، لا يدعم هذه
الإيديولوجية التي يتسالم عليها معظم المسلمين اليوم.
حاول بوليت أن يجيب على هذه الأسئلة ومثيلاتها سواءً في فصول الكتاب المتعددة، أو
في فصله الأخير الذي عنونه بــ (عواقب التحويل)، إجابات تحمل معنى الاستنتاج
والخلاصات، ويبقى الاستنتاج الأهم والأبرز في نظر المؤلف هو أنّ التحوّل إلى
الإسلام كان يؤدي إلى إضعاف الحكومة المركزية أو تفككها، وهذه النتيجة تبيّن أنّ
نشوء القيادة السياسية وتطورها جاء استجابةً لاحتياجات المجتمع الإسلامي في تثبيت
وجوده، من دون أن يُنظر إليها على أنها مادة إيمان أو أن تُعدَّ عنصراً ضرورياً في
علاقة الإنسان بالله، لذلك تضاءلت أهمية وجود مؤسسة سياسية مركزية مع تضاؤل حاجة
المجتمع إليها، لامتلاكه الثقة بذاته، ولشعوره أنّ الإسلام غدا طريقة حياة مستقرة
ودائمة، ولم يعد مهدَّداً بالديانات المحلية الأخرى، وللتدليل على هذا الاستنتاج
يستعرض المؤلف حالات تاريخية لاحقة تؤكد كلامه، فعند كل تهديد لحوزة الإسلام كان
يتمّ اللجوء إلى فكرة الخلافة أو ما يعادلها، وفي هذا السياق يفسِّر المؤلف موافقة
مسلمي إسبانيا على الانضواء تحت راية المرابطين ثم الموحدين في مواجهة القوى
المسيحية الإسبانية المضادة، ويُفسّر أيضاً تجديد الاهتمام بمنصب الخليفة في نهاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، عندما بدا أنّ الإمبريالية الغربية تهدِّد
أسس المجتمع المسلم، ويدرك المؤلف ههنا أنّ هذه النتيجة تتعارض مباشرةً مع المفهوم
الأساسي للإسلام بوصفه ديناً شاملاً يوحِّد جميع جوانب الحياة، فلطالما شعر
المسلمون المعاصرون بأنّ الإسلام يشتمل على نظرية سياسية إسلامية تستند إليها
مؤسسة سياسية مركزية، لكن يبدو أنّ المعطى التاريخي، بحسب المؤلف، لا يدعم هذه
الإيديولوجية التي يتسالم عليها معظم المسلمين اليوم.
أما
الاستنتاج الأهم في نظري فهو ما ختم المؤلف به كتابه في آخر سطوره: “إنّ
الخيط الأساسي الحقيقي للتاريخ الإسلامي لا يكمن في المجال السياسي للخلفاء
والسلاطين، بل في المجال الاجتماعي، حيث كان العلماء بمثابة القلب الفاعل للمجتمع
المسلم التاريخي”.
الاستنتاج الأهم في نظري فهو ما ختم المؤلف به كتابه في آخر سطوره: “إنّ
الخيط الأساسي الحقيقي للتاريخ الإسلامي لا يكمن في المجال السياسي للخلفاء
والسلاطين، بل في المجال الاجتماعي، حيث كان العلماء بمثابة القلب الفاعل للمجتمع
المسلم التاريخي”.
ومن
هذه الخلاصة المدعومة بأرقام نِسَب التحول يتبيّن لنا بجلاء أنّ الفتوحات
الإسلامية لهذه البلاد لم تؤدِّ إلى الدخول الشامل في الإسلام مباشرة،ً لا طوعاً
ولا كرهاً، وأنّ ذلك الاعتقاد القائل: إن تلك الشعوب قد فُتنت بتعاليم الدين
الجديد فسارعت لاعتناقه طوعاً وحباً، أو القائل: إن تلك الشعوب قد بهرها شعاع سيوف
الفاتحين فارتمت في أحضان دينهم كرهاً وتقيّةً ما هو إلا خيالات وخرافات!
هذه الخلاصة المدعومة بأرقام نِسَب التحول يتبيّن لنا بجلاء أنّ الفتوحات
الإسلامية لهذه البلاد لم تؤدِّ إلى الدخول الشامل في الإسلام مباشرة،ً لا طوعاً
ولا كرهاً، وأنّ ذلك الاعتقاد القائل: إن تلك الشعوب قد فُتنت بتعاليم الدين
الجديد فسارعت لاعتناقه طوعاً وحباً، أو القائل: إن تلك الشعوب قد بهرها شعاع سيوف
الفاتحين فارتمت في أحضان دينهم كرهاً وتقيّةً ما هو إلا خيالات وخرافات!
عن
موقع: تلفزيون سوريا
موقع: تلفزيون سوريا