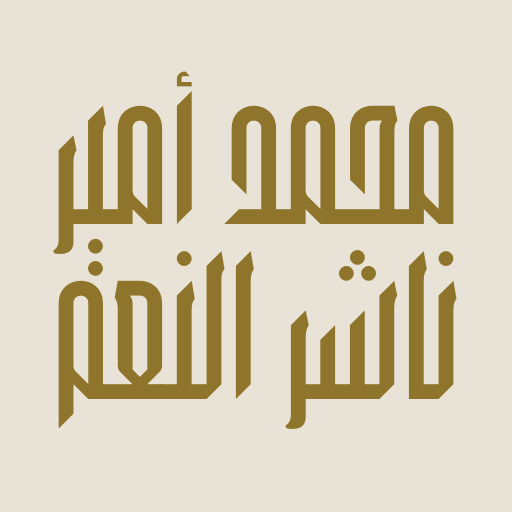نقرأ
نقرأفي القرآن الكريم أنَّه (لكلِّ أمَّة جعلنا منسكاً هم ناسكوه). وإذا صدق هذا على
العالم القديم حيث اختصَّت كل أمة بحجٍ معيّن، لا تشاركها فيه بقيَّة الأمم، فهو
يصدق كذلك على العالم الحديث الذي يجمع هذه الأمم، ويوحّدها على ارتياد أماكن
جديدة، انبثقت من عالم الحداثة، ونالت من الإقبال وقصد الزيارة لمعظَّم ما جعلها
محجّاً يتفق عليه البشر جميعاً، فيفدون إليه على اختلاف أصنافهم وأعراقهم،
وأديانهم ولغاتهم، وهذه الأماكن هي التي يروي المرء فيها ظمأه الروحي للفنِّ
وللجمال، وللتأمل الإنساني الحر، وللاطلاع على التجارب الإبداعيَّة الفرديَّة أو
الجماعيَّة، وسنرى أن أعداد البشر التي ترتادها لا تقل، ألبتة، عن أعداد حجَّاج
بيت الله في مكَّة، أو حجَّاج حائط البراق (المبكى) في القدس، أوكنيسة المهد في
بيت لحم، أو نهر الغانج في الله آباد. وسنرى الأرتال الطويلة كأنَّها تمارس نوعاً
من العبادة، وهي في حالة إصرارٍ على انتظارٍ قد يمتدّ لساعات، حتى يتسنى لها
التطواف في متحف اللوفر في باريس، أو في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، أو
في متحف الإرميتاج أو متحف دوستويفسكي في سان بطرسبرغ، أو في دار الأوبرا في أوسلو،
أو في متحف الشمع (متحف مدام توسو) في لندن.
لكن
لا يقتصر هذا الإقبال في عالم الحداثة على بؤر الفن والجمال والتجارب الروحيَّة،
والتجارب الإبداعيَّة الفرديَّة أو الجماعية فقط، بل يتعداه إلى رحاب مناسك أخرى،
تُعزِّز لدى المرء شعوره بقيم الحرية والعدالة، وتنفخ فيه روح التعاطف والمواساة،
وتلفت نظره إلى الكوارث والمآسي التي تصيب الإنسانية في ساعات غفلتها، عندما
تتلبسها إيديولوجيا قاتلة، أو ديكتاتورية همجيَّة.
لا يقتصر هذا الإقبال في عالم الحداثة على بؤر الفن والجمال والتجارب الروحيَّة،
والتجارب الإبداعيَّة الفرديَّة أو الجماعية فقط، بل يتعداه إلى رحاب مناسك أخرى،
تُعزِّز لدى المرء شعوره بقيم الحرية والعدالة، وتنفخ فيه روح التعاطف والمواساة،
وتلفت نظره إلى الكوارث والمآسي التي تصيب الإنسانية في ساعات غفلتها، عندما
تتلبسها إيديولوجيا قاتلة، أو ديكتاتورية همجيَّة.
وكأنَّ
هذه الزيارة بحد ذاتها تغدو نوعاً من اللقاح أو الطُّعم الذي يثبِّت ويدعِّم لدى
الإنسان التفريق بين العدل والظلم، بين الحريَّة والعبوديَّة، بين الديمقراطيَّة
والديكتاتوريَّة، ولعلَّ من أهمَّ المناسك التي تقدِّم هذا اللقاح (بيت آن فرانك)
في أمستردام، الذي يحجُّ إليه يومياً مئات البشر، من كل أنحاء الأرض، يستذكرون
قصَّة هذه الفتاة اليهوديَّة الصغيرة التي فرَّت مع عائلتها من ألمانيا إلى
هولندا، وكان عمرها اثنتي عشرة سنة، وعندما اجتاحها النازيُّون اضطرت العائلة
للاختباء في منزل في أمستردام لمدة سنتين، وخلال هذه الفترة تبدأ آن بكتابة
مذكراتها إلى أن يكتشف النازيون مخبأهم، فيسوقونهم إلى المعتقل، وهنالك تلقى آن
فرانك حتفها! وبعد اندحار النازيين، وخروج والدها من المعتقل يقوم بنشر هذه
المذكرات، ثمَّ تُترجم إلى معظم لغات العالم، ويتمّ تحويل البيت الذي اختبأت فيه
إلى متحف، وتغدو رمزاً لكل طفل يُنتهك ويُؤذى.
هذه الزيارة بحد ذاتها تغدو نوعاً من اللقاح أو الطُّعم الذي يثبِّت ويدعِّم لدى
الإنسان التفريق بين العدل والظلم، بين الحريَّة والعبوديَّة، بين الديمقراطيَّة
والديكتاتوريَّة، ولعلَّ من أهمَّ المناسك التي تقدِّم هذا اللقاح (بيت آن فرانك)
في أمستردام، الذي يحجُّ إليه يومياً مئات البشر، من كل أنحاء الأرض، يستذكرون
قصَّة هذه الفتاة اليهوديَّة الصغيرة التي فرَّت مع عائلتها من ألمانيا إلى
هولندا، وكان عمرها اثنتي عشرة سنة، وعندما اجتاحها النازيُّون اضطرت العائلة
للاختباء في منزل في أمستردام لمدة سنتين، وخلال هذه الفترة تبدأ آن بكتابة
مذكراتها إلى أن يكتشف النازيون مخبأهم، فيسوقونهم إلى المعتقل، وهنالك تلقى آن
فرانك حتفها! وبعد اندحار النازيين، وخروج والدها من المعتقل يقوم بنشر هذه
المذكرات، ثمَّ تُترجم إلى معظم لغات العالم، ويتمّ تحويل البيت الذي اختبأت فيه
إلى متحف، وتغدو رمزاً لكل طفل يُنتهك ويُؤذى.
أمام
هذا البيت شاهدت في طوابير الانتظار الطويلة التي تمتد مئات الأمتار شعوب الكرة
الأرضية جميعاً. يقف المنتظرون في الطابور، جماعات جماعات: رحلة مدرسية ألمانية،
قافلة سيّاح من اليابانيين، أو من الكوريين، عائلة كندية، وأخرى برازيلية، وثالثة
جنوب إفريقية. يتناقشون. يتسامرون. يتضاحكون. يأكلون الآيس كريم. يدخنون. أناس
مبتهجون.
هذا البيت شاهدت في طوابير الانتظار الطويلة التي تمتد مئات الأمتار شعوب الكرة
الأرضية جميعاً. يقف المنتظرون في الطابور، جماعات جماعات: رحلة مدرسية ألمانية،
قافلة سيّاح من اليابانيين، أو من الكوريين، عائلة كندية، وأخرى برازيلية، وثالثة
جنوب إفريقية. يتناقشون. يتسامرون. يتضاحكون. يأكلون الآيس كريم. يدخنون. أناس
مبتهجون.
لدى
زيارتي البيتَ شاهدت غرفتها الصغيرة، والمغسلة التي كانت تغسل يديها فيها، والسرير
الذي كانت تنام عليه، وفي الردهات وفي بعض الغرف شاهدت الأفلام الوثائقية، من خلال
الشاشات الذكية، التي تحكي عن حياتها. شاهدت لقاءً مع أبيها، ولقاء آخر مع
مدرِّستها، ولقاء ثالثاً مع إحدى قريباتها. في هذه الأثناء كانت المقارنات تفرض
نفسها عليَّ، وكان الأسف، لتقصيرنا، يزدريني، فأمة المليار نسمة من المسلمين لم
تستطع حتى هذه الساعة أن تخصص متحفاً واحداً يوثق ويشرح ويلفت النظر إلى فواجعها
ومآسيها، بدءاً مما يحدث لضعفاء الروهينغا في مشرق الأرض، وانتهاءاً بدول البلقان
التي لم تزل دماء المجازر فيها عبيطة في غربها، وبينما كنت أتجول في ذلك المخبأ
الذي توارت فيه آن كفأر صغير عن عيون العدو النازي، كاد خفقان قلبي يقعدني! فمثل
أيِّ سوري منفي، غدوتُ كأمٍّ ثكلى يعلو وجيب قلبها لدى كل شرارة تصادفها.
زيارتي البيتَ شاهدت غرفتها الصغيرة، والمغسلة التي كانت تغسل يديها فيها، والسرير
الذي كانت تنام عليه، وفي الردهات وفي بعض الغرف شاهدت الأفلام الوثائقية، من خلال
الشاشات الذكية، التي تحكي عن حياتها. شاهدت لقاءً مع أبيها، ولقاء آخر مع
مدرِّستها، ولقاء ثالثاً مع إحدى قريباتها. في هذه الأثناء كانت المقارنات تفرض
نفسها عليَّ، وكان الأسف، لتقصيرنا، يزدريني، فأمة المليار نسمة من المسلمين لم
تستطع حتى هذه الساعة أن تخصص متحفاً واحداً يوثق ويشرح ويلفت النظر إلى فواجعها
ومآسيها، بدءاً مما يحدث لضعفاء الروهينغا في مشرق الأرض، وانتهاءاً بدول البلقان
التي لم تزل دماء المجازر فيها عبيطة في غربها، وبينما كنت أتجول في ذلك المخبأ
الذي توارت فيه آن كفأر صغير عن عيون العدو النازي، كاد خفقان قلبي يقعدني! فمثل
أيِّ سوري منفي، غدوتُ كأمٍّ ثكلى يعلو وجيب قلبها لدى كل شرارة تصادفها.
وما
الشرارة؟
الشرارة؟
إنَّها
كلُّ حادثة، كل نشاط، كل خبر، كل قصَّة، كل مشهد، حزيناً كان أم سعيداً، بهيجاً أم
كئيباً!
كلُّ حادثة، كل نشاط، كل خبر، كل قصَّة، كل مشهد، حزيناً كان أم سعيداً، بهيجاً أم
كئيباً!
فعلى
مدار سبع سنوات جفَّف إجرام النظام الأسدي إهابنا، ماضينا، حاضرنا، مستقبلنا.
أمَّا سكوت العالم بدوله وأنظمته، وتغاضيه عن الجريمة إبَّان حدوثها فقد يبّس
أحلامنا وأرواحنا!
مدار سبع سنوات جفَّف إجرام النظام الأسدي إهابنا، ماضينا، حاضرنا، مستقبلنا.
أمَّا سكوت العالم بدوله وأنظمته، وتغاضيه عن الجريمة إبَّان حدوثها فقد يبّس
أحلامنا وأرواحنا!
حزنت
لقصة آن أيَّما حزن، وأنا الغاصّ به، والغائص فيه، وتعاطفت معها أيَّما
تعاطف، وأنا الذي أنشد التعاطف، ليس من أجلي بل من أجل أن يدلِّل
المتعاطفون على إنسانيتهم وأخلاقهم وضميرهم، وكان شعوري مصعّداً ومضروباً بأُسٍّ،
لأنَّني رأيت في عيون آن، وفي بسمتها، وفي قلقها، وفي شغفها، وفي بوحها، وفي
آمالها، وفي جريها، وفي رقصها والتفافها ودورانها على نفسها، وفي دراستها، وفي
كتابتها، وفي الإمكانات الهائلة التي كان من المفترض أن تكونها!! رأيت
في كل ذلك رزان زيتونة، وطل الملوحي، ورانيا عباسي، وسميرة خليل، ورحاب العلاوي، وآلاف
المعتقلات في سجون النظام الأسدي، ممن لا نعلم عنهن شيئاً، ولا نجرؤ على تصوّر أو
تخيّل ما هم فيه من محنة وكرب وظلم وشدّة!!
لقصة آن أيَّما حزن، وأنا الغاصّ به، والغائص فيه، وتعاطفت معها أيَّما
تعاطف، وأنا الذي أنشد التعاطف، ليس من أجلي بل من أجل أن يدلِّل
المتعاطفون على إنسانيتهم وأخلاقهم وضميرهم، وكان شعوري مصعّداً ومضروباً بأُسٍّ،
لأنَّني رأيت في عيون آن، وفي بسمتها، وفي قلقها، وفي شغفها، وفي بوحها، وفي
آمالها، وفي جريها، وفي رقصها والتفافها ودورانها على نفسها، وفي دراستها، وفي
كتابتها، وفي الإمكانات الهائلة التي كان من المفترض أن تكونها!! رأيت
في كل ذلك رزان زيتونة، وطل الملوحي، ورانيا عباسي، وسميرة خليل، ورحاب العلاوي، وآلاف
المعتقلات في سجون النظام الأسدي، ممن لا نعلم عنهن شيئاً، ولا نجرؤ على تصوّر أو
تخيّل ما هم فيه من محنة وكرب وظلم وشدّة!!
انتهيت
من زيارتي، وخرجت مع الخارجين. كنت أتفرَّس في وجوههم فأراهم مذهولين، مصدومين،
غير مصدِّقين. رأيتهم، وقد ضُربت عليهم أسداد الكرب، يمشون الهوينى، مكبلين
بالأسئلة الأخلاقية الكبرى التي تثيرها وتحركها هذه الزيارة، رغم بساطة ما فيها،
ورغم قلة مفرداتها، ولكن هكذا هو شأن الرموز الكبرى: بسيطة في شكلها، قليلة في
مفرداتها، ومع ذلك تختزن طاقة نووية، فيمتدُّ تأثيرها أبعد مما نتصوّر أو نتخيّل.
من زيارتي، وخرجت مع الخارجين. كنت أتفرَّس في وجوههم فأراهم مذهولين، مصدومين،
غير مصدِّقين. رأيتهم، وقد ضُربت عليهم أسداد الكرب، يمشون الهوينى، مكبلين
بالأسئلة الأخلاقية الكبرى التي تثيرها وتحركها هذه الزيارة، رغم بساطة ما فيها،
ورغم قلة مفرداتها، ولكن هكذا هو شأن الرموز الكبرى: بسيطة في شكلها، قليلة في
مفرداتها، ومع ذلك تختزن طاقة نووية، فيمتدُّ تأثيرها أبعد مما نتصوّر أو نتخيّل.
لكم
رجوت وأنا أشاهد هذه الطوابير حين خروجها أن نطبع ملايين البرشورات
والكتيبات بأهمِّ لغات العالم، وأن نقدّمها لهؤلاء الحجَّاج، نشرح لهم فيها مأساة
المرأة السوريَّة المغيَّبة في معتقلات تنظيمات الأسد أو التنظيمات العدمية
الأخرى، ولا شكّ لدي في أنَّه سيكون أعظم أثراً من كثير من أنشطتنا، وأمضى نتيجةً
من كثير من فعَّاليَّاتنا، لأنه سيصل بشكل مباشر إلى أعداد لا حصر لها من جميع
جنسيات العالم، وإلى أشخاص مستثارين للتوِّ إنسانياً وعاطفياً وأخلاقياً، أشخاصٍ
أكثر أهلية للفهم والتعاطف، وأكثر قابلية للتأثر في الحال، والتأثير في المآل.
رجوت وأنا أشاهد هذه الطوابير حين خروجها أن نطبع ملايين البرشورات
والكتيبات بأهمِّ لغات العالم، وأن نقدّمها لهؤلاء الحجَّاج، نشرح لهم فيها مأساة
المرأة السوريَّة المغيَّبة في معتقلات تنظيمات الأسد أو التنظيمات العدمية
الأخرى، ولا شكّ لدي في أنَّه سيكون أعظم أثراً من كثير من أنشطتنا، وأمضى نتيجةً
من كثير من فعَّاليَّاتنا، لأنه سيصل بشكل مباشر إلى أعداد لا حصر لها من جميع
جنسيات العالم، وإلى أشخاص مستثارين للتوِّ إنسانياً وعاطفياً وأخلاقياً، أشخاصٍ
أكثر أهلية للفهم والتعاطف، وأكثر قابلية للتأثر في الحال، والتأثير في المآل.
هل
يصل اقتراحي؟ أرجو ذلك!
يصل اقتراحي؟ أرجو ذلك!
محمد أمير ناشر النعم