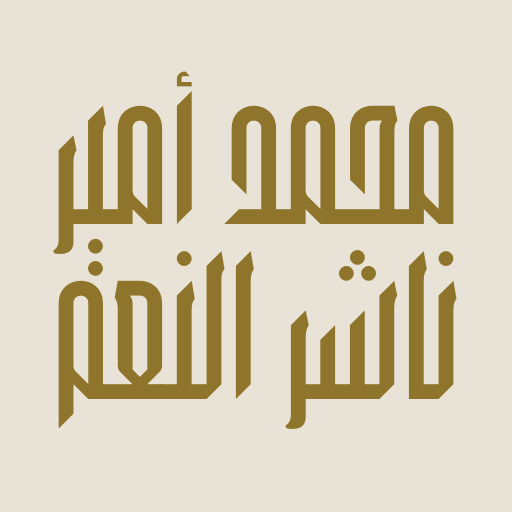كم نحن بائسون يائسون حين يستعيد ويسرد في القرن الحادي والعشرين شيخ يحمل درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من جامعة غربية في صفحته على الفيس بوك أحاديث ومأثورات تدعو للتشفع والتوسط بين الغني والفقير، وبين القوي والضعيف، وبين الحاكم والمحكوم، وتبيّن فضل الشفيع والوسيط، ومكانتهما وكرامتهما.
فيورد ما يلي:
ــ “أفضل الصدقة اللسان. قيل: يا رسول الله وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة. يُفكّ بها الأسير، ويُحقن بها الدم، وتَجرُّ بها المعروف والإحسان إلى أخيك، وتدفع عنه الكريهة”.
ـــ “مَنْ كان وُصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر، أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام”.
ــ “إنّ لله خلقاً خلقهم لحوائج الناس، تفزع الناس إليهم في حوائجهم. أولئك الآمنون من عذاب الله”.
ــ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبَّت الله قدميه يوم القيامة” الترمذي.
ولسنا هنا في مقام دراسة هذه الأحاديث من حيث درجة ثبوتها وقوة أسانيدها، لكنّنا نؤكد أنّها حتى في حال صحة إسنادها لا يمكن حملها على المعنى التوظيفي المتهالك الذي نراه بأم أعيننا، ليغطي به بعض المشايخ عوراتهم، فإن هذا المعنى يصطدم بعموم مقاصد الشريعة ومعانيها، بل وأسسها ومبانيها.
وهنا سأستعير مصطلحات الأصوليين في علم الدلالة، حين يتكلمون عن ثلاث مراحل لها: الوضع ـــ الاستعمال ـــ الحمل.
ففي الوضع: يقوم الواضع بوضع اللفظ بإزاء المعنى.
وفي الاستعمال: يقوم المتكلم باستعمال اللفظ في ذلك المعنى.
وفي الحمل: يقوم السامع بحمل اللفظ على ذلك المعنى.
ولا شك في أنّ (الواضع) حين قال هذه الأحاديث في ذلك الزمان فإنّه راعى قيم الناس وأعرافهم وحدودها وإمكاناتها، وماشى آليات تحريك المشاعر والضمائر حتى تنالها هزّة الأريحية والكرم، وعطفة الإسعاف والإنجاد، نصرةً للمظلوم، ورعاية للأسير، وخدمة للفقير، وكلاءة للمعتر.
ولكنّنا نشكّ في أن (المستعمل) وهو ههنا الشيخ ورجل الدين الذي يعيد سرد هذه الأقوال والأحاديث إنّما يسردها في نفس المعاني، ولنفس الأهداف التي أرادها (الواضع)، حين يستدعيها بعد خمسة عشر قرناً! ذلك أنّه لم تكد تمضي خمسون سنة على قولها حتى انزاحت عن مقاصدها، وحُرفت عن معانيها. فقد اكتشف الحاكم من جهة، والطفيليون من جهة أخرى أنّ مثل هذه الأحاديث أوطأ من المهاد الوثير للاستبداد والفساد. اكتشف الحاكم أنّ هذه الأحاديث تثبّت سلطته، وتزيد شرعيته، وتمنحه لذةً ونشوة لا تصمد أمامهما متع الدنيا بأجمعها، ولم يطلب من الوسيط سوى أن يكون حلو المعشر مداهناً لينال الحظوة والاستجابة!! وهكذا تحوّلت الدلالة من الواضع وفق ما رأينا لتغدو لدى الحاكم في غمرة حجه لنفسه، وسيلةً لتحقيق نشوة التأله، ولذة التربّب. فالحاكم إله يجب أن يدعوه الناس ليستجيب لهم، ويجب أن يتشفّع له الشفعاء ليعفو ويصفح، ويفيض وينعم، أوَ ليس وجود الرعية بحد ذاته عطية من عطاياه، فالحاكم هو السيد القائد، والأب البطريرك الصامد، وعبر الوريث هو الممتد الخالد.
وقد غدا هذا
الطلب: “اشفعوا تؤجروا” عادةً لدى كل المستبدين، وديدناً لهم، وفي
الحقيقة كان هو الغاية والنهاية، من وراء استبدادهم وفسادهم، فكل حركاتهم
وسكناتهم، وكل تلويحاتهم وإشاراتهم فضلاً عن عباراتهم كانت تقول:
الطلب: “اشفعوا تؤجروا” عادةً لدى كل المستبدين، وديدناً لهم، وفي
الحقيقة كان هو الغاية والنهاية، من وراء استبدادهم وفسادهم، فكل حركاتهم
وسكناتهم، وكل تلويحاتهم وإشاراتهم فضلاً عن عباراتهم كانت تقول:
امدحوني،
واستعطفوني، وتملقوني، وقفوا ببابي واطلبوني.
واستعطفوني، وتملقوني، وقفوا ببابي واطلبوني.
أرسلوا شفعاءكم،
وليقولوا لي: كان شاباً، أهوج، غراً، مندفعاً، ملعوباً بعقله، وبعاطفته، وإنّ له
أماً تدعو لك ليل نهار لكي يعطّف الله قلبك الشريف عليه، وسأخرجه من المعتقل.
وليقولوا لي: كان شاباً، أهوج، غراً، مندفعاً، ملعوباً بعقله، وبعاطفته، وإنّ له
أماً تدعو لك ليل نهار لكي يعطّف الله قلبك الشريف عليه، وسأخرجه من المعتقل.
قولوا لي: خدم
في دولتك، بل في مزرعتك، بل في حظيرتك ثلاثين سنة، ولم يغب يوماً واحداً عن
وظيفته، وكان كامل الولاء والوفاء لك، وسآمر بتقريب دوره في العملية الجراحية
المستعجلة.
في دولتك، بل في مزرعتك، بل في حظيرتك ثلاثين سنة، ولم يغب يوماً واحداً عن
وظيفته، وكان كامل الولاء والوفاء لك، وسآمر بتقريب دوره في العملية الجراحية
المستعجلة.
قولوا لي ولا
تتأخروا، فأنا الذي أُنشط الحبل على رقابكم فأشنقكم، وأنا الذي أفك الأحبولة عنها
فأحييكم، وأنا الذي أفقركم, وأنا الذي أغنيكم.
تتأخروا، فأنا الذي أُنشط الحبل على رقابكم فأشنقكم، وأنا الذي أفك الأحبولة عنها
فأحييكم، وأنا الذي أفقركم, وأنا الذي أغنيكم.
واكتشف
الطفيليون في الوقت نفسه كيف يَفِدُون على ذوي السلطان بكل وسيلة وآلة، وكيف
يرتبطون به بأسبابٍ متان، وكيف يفتدون كَلَبهم عليهم بكل مرتخص وغال، كيف يجيدون
لعبة الاستخفاء السخيفة وراء نفع الآخرين. وما كان أسعدهم بعبارة: “اشفعوا
تؤجروا”. حيث لم تسوِّغ دورهم في معافسة ذوي القوة والسلطة، ولم تستر
طفيليتهم فحسب، وإنما جعلت التمسح في عتبات السلطان، وبسط كامل عدة التبجيل
والتزلف بين يديه عبادةً يؤجر المتملق عليها، فيتوّج بتاج الفضل، وينوء بأوسمة
المنة، في الدنيا قبل الآخرة، كما هو واقع ومشاهد.
الطفيليون في الوقت نفسه كيف يَفِدُون على ذوي السلطان بكل وسيلة وآلة، وكيف
يرتبطون به بأسبابٍ متان، وكيف يفتدون كَلَبهم عليهم بكل مرتخص وغال، كيف يجيدون
لعبة الاستخفاء السخيفة وراء نفع الآخرين. وما كان أسعدهم بعبارة: “اشفعوا
تؤجروا”. حيث لم تسوِّغ دورهم في معافسة ذوي القوة والسلطة، ولم تستر
طفيليتهم فحسب، وإنما جعلت التمسح في عتبات السلطان، وبسط كامل عدة التبجيل
والتزلف بين يديه عبادةً يؤجر المتملق عليها، فيتوّج بتاج الفضل، وينوء بأوسمة
المنة، في الدنيا قبل الآخرة، كما هو واقع ومشاهد.
ونعود للشيخ
ورجل الدين حين يستعمل هذه الأحاديث لنرى المعاني المستكنة وراء
حجاب ما أراده الواضع من معنى نبيل، ومقصد إنساني سام.
ورجل الدين حين يستعمل هذه الأحاديث لنرى المعاني المستكنة وراء
حجاب ما أراده الواضع من معنى نبيل، ومقصد إنساني سام.
1 ــ “أفضل
الصدقة اللسان”. فلا تتعتبوا علينا ــ أيها المستمعون ــ فكيف للسان أن
يستحصد الخير والمعروف والإحسان من “ذي السلطان” إن لم يتقن فنون التزلف
والتودد والمحاباة والاستعطاف والاستلطاف، ونفخ ذي السلطان إلى أن يغدو بحجم الكرة
الأرضية، بل إيهامه أنّ الكرة الأرضية تظل أدنى من مزاياه وسجاياه، وهكذا لا تضيع
دراستنا للأدب العربي هباءً، ولا حفظنا مدائح الشعراء سدىً، ولا تذهب ملكاتنا
البلاغية أدراج الرياح.
الصدقة اللسان”. فلا تتعتبوا علينا ــ أيها المستمعون ــ فكيف للسان أن
يستحصد الخير والمعروف والإحسان من “ذي السلطان” إن لم يتقن فنون التزلف
والتودد والمحاباة والاستعطاف والاستلطاف، ونفخ ذي السلطان إلى أن يغدو بحجم الكرة
الأرضية، بل إيهامه أنّ الكرة الأرضية تظل أدنى من مزاياه وسجاياه، وهكذا لا تضيع
دراستنا للأدب العربي هباءً، ولا حفظنا مدائح الشعراء سدىً، ولا تذهب ملكاتنا
البلاغية أدراج الرياح.
2 ــ ولأجلكم،
وكرمى عيون أولادكم وزعرانكم نسجنا علاقاتنا مع رؤساء فروع الأمن والمخابرات، ومع
كل ضربة مكّوك في نول النسج ضَرَبَتنا خضة توجس، وخفقة قلق، حتى لكأن الريح تحتنا
وفوقنا وعن أيماننا وشمائلنا، إلى أن غدونا “وُصلة” بينكم وبينهم.
تحمّلنا غلظة العلاقة معهم، وكُرب المكث بينهم، وغضضنا الطرف عن كل أنواع تجديفهم،
وتجاوزنا عن كل أنواع مزاحهم، بل استهزائهم، وسترون كيف سيكافئنا ربنا،
و”يجيزنا الصراط” عندما تدحض أقدامهم وأقدامكم.
وكرمى عيون أولادكم وزعرانكم نسجنا علاقاتنا مع رؤساء فروع الأمن والمخابرات، ومع
كل ضربة مكّوك في نول النسج ضَرَبَتنا خضة توجس، وخفقة قلق، حتى لكأن الريح تحتنا
وفوقنا وعن أيماننا وشمائلنا، إلى أن غدونا “وُصلة” بينكم وبينهم.
تحمّلنا غلظة العلاقة معهم، وكُرب المكث بينهم، وغضضنا الطرف عن كل أنواع تجديفهم،
وتجاوزنا عن كل أنواع مزاحهم، بل استهزائهم، وسترون كيف سيكافئنا ربنا،
و”يجيزنا الصراط” عندما تدحض أقدامهم وأقدامكم.
3 ــ ولأجلكم،
وكرمى عيون أسركم وبناتكم شبكنا هذه العلاقات مع التجار والأغنياء وأرباب النعمة
واليسار. أَوَ تظنون أنّ الجميع مؤهّل لهذه العلاقات؟ لا. فنحن خلقنا الله
“لقضاء حوائجكم”، وللتوسط والشفاعة لكم، ولأجلكم ذهبنا لمزارعهم
ومضافاتهم الفاخرة، وشاركناهم بطرهم في أفراحهم وأتراحهم الفاجرة، وباركنا حولهم
وبهم وفيهم، وأفتينا لغلولهم، وسكتنا عن مصائبهم وفظائعهم، وها أنتم ذا تفزعون
إلينا فنلبيكم، ونأخذ بأيديكم، فنستجديهم لكم، ونستعطفهم عليكم، فنحن
“الآمنون من عذاب الله” يوم يعذبهم ويعذبكم.
وكرمى عيون أسركم وبناتكم شبكنا هذه العلاقات مع التجار والأغنياء وأرباب النعمة
واليسار. أَوَ تظنون أنّ الجميع مؤهّل لهذه العلاقات؟ لا. فنحن خلقنا الله
“لقضاء حوائجكم”، وللتوسط والشفاعة لكم، ولأجلكم ذهبنا لمزارعهم
ومضافاتهم الفاخرة، وشاركناهم بطرهم في أفراحهم وأتراحهم الفاجرة، وباركنا حولهم
وبهم وفيهم، وأفتينا لغلولهم، وسكتنا عن مصائبهم وفظائعهم، وها أنتم ذا تفزعون
إلينا فنلبيكم، ونأخذ بأيديكم، فنستجديهم لكم، ونستعطفهم عليكم، فنحن
“الآمنون من عذاب الله” يوم يعذبهم ويعذبكم.
4 ــ نحن نستحق
المكافأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من أتى إليكم بمعروف
فكافئوه”. هيّا فكافئونا، والشاعر العربي الذي يقطر حكمة وحنكة يقول:
المكافأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من أتى إليكم بمعروف
فكافئوه”. هيّا فكافئونا، والشاعر العربي الذي يقطر حكمة وحنكة يقول:
وإذا امرؤٌ أهدى إليك صنيعة……. من جاهه فكأنها من
ماله
ماله
فها نحن ذا نبذل
جاهنا لكم، بل نبذل ماء محيّانا لكم. ألا فكافئونا، أوَ لم تسمعوا غوته يقول:
“نكران الجميل أعظم الآثام”! فإن لم تجدوا فقبّلوا أيادينا، شكراناً
لأيادينا، فنحن من ريحة الاستبداد يسرنا ما يسرّه، ويبهجنا ما يبهجه، وكما أننا
دعونا للفاسدين في خطبنا وصلواتنا فلتتدفقوا دعاءً لنا، قياماً وقعوداً وعلى
جنوبكم، ولترسفوا في أغلال الشكر والحمد والثناء إلى يوم الدين، وأبد الآبدين.
جاهنا لكم، بل نبذل ماء محيّانا لكم. ألا فكافئونا، أوَ لم تسمعوا غوته يقول:
“نكران الجميل أعظم الآثام”! فإن لم تجدوا فقبّلوا أيادينا، شكراناً
لأيادينا، فنحن من ريحة الاستبداد يسرنا ما يسرّه، ويبهجنا ما يبهجه، وكما أننا
دعونا للفاسدين في خطبنا وصلواتنا فلتتدفقوا دعاءً لنا، قياماً وقعوداً وعلى
جنوبكم، ولترسفوا في أغلال الشكر والحمد والثناء إلى يوم الدين، وأبد الآبدين.
نكتفي بسرد هذه
الشذرة من لسان حال السلطان والشفيع، ويعلم الله أننا لم نسطّر ههنا من هذه
المعاني إلا ما يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد إيجازاً واختصاراً وترفّعاً. على
أننا لا نعتب على المشايخ ورجال الدين حين يتلهفون لأداء هذا الدور، ويستميتون
لعطف القلوب والعقول إليهم، فهم من ناحية جبلوا على أن يكونوا كاللبلاب يسره أن
يلعب الدور الرئيسي حيثما التصق، وهم من ناحية أخرى لم يأتهم نبأ الدولة المدنية
الحديثة التي غدا القانون ومؤسساته فيها الوسيلة الوحيدة لأقرار الحقوق والحصول
عليها، وتحديد الواجبات وفرضها، بدون تمييز بين الأفراد على اختلاف صنوفهم
وأنواعهم ومراتبهم، حيث تفقد وسيلة “التشفّع والاستجداء” قيمتها، بل حتى
إنه لا يمكن تفعليها ولا ممارستها، كما إنه ينتفي وجود رجل الدولة “ذي
السلطان” الذي يُلتمس دفع ضره، أو جلب منفعته، لأنه بكل بساطة غدا مجرّد موظف
لا يملك أدنى صلاحية خارج وظيفته التي تنتهي في وقت محدد معلوم، ولا يملك أن
يتجاوز في أدائها، قيد أنملة، الإطار المرسوم.
الشذرة من لسان حال السلطان والشفيع، ويعلم الله أننا لم نسطّر ههنا من هذه
المعاني إلا ما يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد إيجازاً واختصاراً وترفّعاً. على
أننا لا نعتب على المشايخ ورجال الدين حين يتلهفون لأداء هذا الدور، ويستميتون
لعطف القلوب والعقول إليهم، فهم من ناحية جبلوا على أن يكونوا كاللبلاب يسره أن
يلعب الدور الرئيسي حيثما التصق، وهم من ناحية أخرى لم يأتهم نبأ الدولة المدنية
الحديثة التي غدا القانون ومؤسساته فيها الوسيلة الوحيدة لأقرار الحقوق والحصول
عليها، وتحديد الواجبات وفرضها، بدون تمييز بين الأفراد على اختلاف صنوفهم
وأنواعهم ومراتبهم، حيث تفقد وسيلة “التشفّع والاستجداء” قيمتها، بل حتى
إنه لا يمكن تفعليها ولا ممارستها، كما إنه ينتفي وجود رجل الدولة “ذي
السلطان” الذي يُلتمس دفع ضره، أو جلب منفعته، لأنه بكل بساطة غدا مجرّد موظف
لا يملك أدنى صلاحية خارج وظيفته التي تنتهي في وقت محدد معلوم، ولا يملك أن
يتجاوز في أدائها، قيد أنملة، الإطار المرسوم.
ولكن هل لنا أن
نحلم بمشايخ ورجال دين يتعالون على واقعهم مهما كان مشؤوماً بالقبلية، منخوراً بالعشائرية،
ويكفّون عن ترسيخ كل ما هو عفن، وعن تثبيت كل ما هو منحط؟
نحلم بمشايخ ورجال دين يتعالون على واقعهم مهما كان مشؤوماً بالقبلية، منخوراً بالعشائرية،
ويكفّون عن ترسيخ كل ما هو عفن، وعن تثبيت كل ما هو منحط؟
هل لنا أن نحلم
بأن نخرج ويخرجوا من عصور السلاطين والمماليك؟
بأن نخرج ويخرجوا من عصور السلاطين والمماليك؟
هل لنا أن نحلم
بأن ينطفئ توقهم الدائم ليكونوا مجرد بديل بائس للقانون، وبدلاً من أن ينفخوا في
قيم بالية بائدة أن يدعوا لمجتمع يسوده القانون، ويبسط سلطانه في كل مناحيه، فلا
يحتاج المواطن لأن يتمسّح بالشفيع، ولا أن يلهث وراء الوسيط، ولا أن يظل مبرشماً
بالاستجداء المبتذل الذي لا يلائمه سوى عطاء مبتذل. هل لنا بأن نحلم بأن يغدوا
دعاة لمواطن أشمّ، لا يستنشق سوى عبير الكرامة الإنسانية، ويخلو صدره ورئتاه من
غبار التملق وسخام الاستجداء؟
بأن ينطفئ توقهم الدائم ليكونوا مجرد بديل بائس للقانون، وبدلاً من أن ينفخوا في
قيم بالية بائدة أن يدعوا لمجتمع يسوده القانون، ويبسط سلطانه في كل مناحيه، فلا
يحتاج المواطن لأن يتمسّح بالشفيع، ولا أن يلهث وراء الوسيط، ولا أن يظل مبرشماً
بالاستجداء المبتذل الذي لا يلائمه سوى عطاء مبتذل. هل لنا بأن نحلم بأن يغدوا
دعاة لمواطن أشمّ، لا يستنشق سوى عبير الكرامة الإنسانية، ويخلو صدره ورئتاه من
غبار التملق وسخام الاستجداء؟
إن كان حلمنا
بعيد المنال فلنعرِّ هذه الطبقة من الطفيليين، ولنقاطعها، ولندعُ الإنسان ليكون
سيد نفسه، سيد مصيره.
بعيد المنال فلنعرِّ هذه الطبقة من الطفيليين، ولنقاطعها، ولندعُ الإنسان ليكون
سيد نفسه، سيد مصيره.