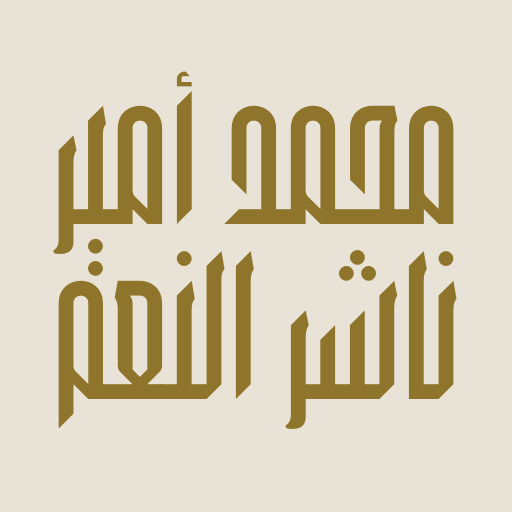تلقى
تلقىمحمد إقبال تعليماً إسلامياً وغربياً في مسقط رأسه في سيالكوت بإقليم البنجاب، ثم
في كلية لاهور الشرقية التي أكمل فيها دراسة الماجستير في الفلسفة، وخلال تدريسه
في لاهور توطدت صداقته مع المستشرق البريطاني البارز توماس آرنولد الذي شجّعه على
السفر إلى أوروبا، فسافر ما بين عامي 1905 و1908م، وبعد إكمال دراساته في الفلسفة
والقانون في جامعة كامبرديج أمضى
قريباً من ستة أشهر في ألمانيا سنة 1907م، التحق
فيها بجامعة ميونخ، وقدّم أطروحة دكتوراه بالإنكليزية بعنوان: (تطور الميتافيزيقيا
في فارس)(1)، كانت هذه الأطروحة أول عرض مكتمل لتطور الفكر الفلسفي في إيران، وكان
“إقبال المتأمل الدارس يعطي إلى جانب الحقائق العلمية والموازنات الفكرية
انطباعاته الشخصية، وفهمه الذاتي لهذه الاتجاهات والمواقف الفكرية، بحيث تحمل
تحليلاته آثار معاناة نفسية، ومعايشة لتلك الأفكار والمواقف، لا مجرّد سرد موضوعي
جاف، أوتحليل عقلي خالص”(2). وقد قادته هذه الدراسة إلى الاطلاع اطلاعاً وافياً
على النِّحلة الجديدة الناشئة للتوّ في إيران، وإلى أن يقدّم تلخيصاً مكثفاً عنها
في صورتيها: (البابية) و(البهائية)، وكانت كل الدلائل تشير إلى صعود سريع لنجم هذه
الديانة في سماء إيران في بداية القرن العشرين، حتى إن المراقبين، ومن بينهم إقبال
نفسه، ظنوا أن هذه الديانة ستعم الإيرانيين في غضون سنوات قلائل، غير أن المقاومة
العنيفة التي منيت بها جعلتها تنكفئ على نفسها في إيران، وتمتد وتتوسع في الغرب،
ولا سيما في أمريكا.
فيها بجامعة ميونخ، وقدّم أطروحة دكتوراه بالإنكليزية بعنوان: (تطور الميتافيزيقيا
في فارس)(1)، كانت هذه الأطروحة أول عرض مكتمل لتطور الفكر الفلسفي في إيران، وكان
“إقبال المتأمل الدارس يعطي إلى جانب الحقائق العلمية والموازنات الفكرية
انطباعاته الشخصية، وفهمه الذاتي لهذه الاتجاهات والمواقف الفكرية، بحيث تحمل
تحليلاته آثار معاناة نفسية، ومعايشة لتلك الأفكار والمواقف، لا مجرّد سرد موضوعي
جاف، أوتحليل عقلي خالص”(2). وقد قادته هذه الدراسة إلى الاطلاع اطلاعاً وافياً
على النِّحلة الجديدة الناشئة للتوّ في إيران، وإلى أن يقدّم تلخيصاً مكثفاً عنها
في صورتيها: (البابية) و(البهائية)، وكانت كل الدلائل تشير إلى صعود سريع لنجم هذه
الديانة في سماء إيران في بداية القرن العشرين، حتى إن المراقبين، ومن بينهم إقبال
نفسه، ظنوا أن هذه الديانة ستعم الإيرانيين في غضون سنوات قلائل، غير أن المقاومة
العنيفة التي منيت بها جعلتها تنكفئ على نفسها في إيران، وتمتد وتتوسع في الغرب،
ولا سيما في أمريكا.
لم
يتحدث إقبال عن (البابية) حركةً مستقلةً، بل وضعها في سياق تطور (البهائية). وقد
بدأت (البابية)، كما يخبرنا إقبال، باعتبارها “حركة شيعية على يد الميرزا علي محمد
الباب الشيرازي (المولود 1820م)، ثم أخذت تبتعد شيئاً فشيئاً عن الصبغة الإسلامية
بتنامي الصراع بينها وبين الاتجاه الإسلامي المحافظ، وما نجم عن ذلك من ضحايا
واضطهادات”(3).
يتحدث إقبال عن (البابية) حركةً مستقلةً، بل وضعها في سياق تطور (البهائية). وقد
بدأت (البابية)، كما يخبرنا إقبال، باعتبارها “حركة شيعية على يد الميرزا علي محمد
الباب الشيرازي (المولود 1820م)، ثم أخذت تبتعد شيئاً فشيئاً عن الصبغة الإسلامية
بتنامي الصراع بينها وبين الاتجاه الإسلامي المحافظ، وما نجم عن ذلك من ضحايا
واضطهادات”(3).
ويشير إقبال هنا
إلى الاضطهادات التي تعرّض لها البابيون بعد محاولة أحدهم قتل الشاه، وعندها تحركت
قوات الشاه لتلقي القبض على كل من حامت حوله شبهة اعتناق البابية، ففقئت أعينهم،
ونشرت أجسادهم بالمناشير، وخُنقوا وقُذفوا من أفواه المدافع، ومزّقوا شر ممزق
بالفؤوس والآلات الحادة، ونعلت أقدامهم بحدوات الخيل، وأرغموا على الجري، وطعنوا
بالحراب، ورجموا بالحجارة، وساق الجلادون النساء والأطفال من أتباع الباب بأجساد
ممزقة تشتعل في ثقوبها الشموع في الشوارع، وإذا ما هلك الأطفال في الطرق رمى
الجلادون أجسادهم تحت أقدام آبائهم وإخوتهم، وقد صمد البابيون، وصبروا صبراً فاق
الوصف، في مطابقة تامة لمقولة ياسبرز: “الحقيقة الميتافيزيقية هي تلك الحقيقة التي
نرضى بالموت من أجلها”.

العرض
والتفصيل:
يتتبع إقبال
أصول هذه الفرقة في فرقة سابقة عليها هي (الشيخية) فيقول: “وترجع أصول الفلسفة
الدينية التي تتبناها هذه الفرقة إلى فرقة أخرى سبقتها هي الفرقة الشيخية التي
ظهرت في الوسط الشيعي، وأسسها الشيخ أحمد الإحسائي(4) أحد الدارسين المتحمسين
لفلسفة ملا صدرا وأحد شرّاحها البارزين. وتفترق جماعة الشيخية هؤلاء عن سائر
الشيعة الاثني عشرية في اعتقاد الشيخية بوجوب وجود حلقة وصل دائمة بين الشيعة
وإمامهم الغائب (أي الإمام الثاني عشر للفرقة، الذي يترقبون ظهوره من وقت لآخر)،
وعدّوا الاعتقاد بوجود هذه الوساطة المستمرة أصلاً أساسياً من أصول الدين، وقد
ادعى الشيخ أحمد أنه هو نفسه الوساطة بين شيعة عصره وإمامهم الغائب، وبعد وفاته
كان خليفته الحاج كاظم الرشتي(5) يمثل هذه الوساطة، فلما مات الرشتي وترقب الشيخية
ظهور الوساطة الجديدة بينهم وبين الإمام الغائب أعلن الميرزا علي محمد الشيرازي
الباب، الذي تتلمذ على الرشتي في دروسه بالنجف، أنه هو نفسه تلك الوساطة فارتضى
أكثر الشيخية ذلك”(6).
يكتفي
إقبال بهذا السرد التاريخي المبسّط والموجز للبابية، علماً أن البحث في جذور
البابية يمتد إلى مرحلة أبعد زمناً من الشيخية (أتباع الإحسائي) والكشفية (أتباع
كاظم الرشتي)، أقصد بذلك المدرسة أوالاتجاه الحروفي، ممثلاً بفضل الله الإسترابادي
الذي أعدم سنة 804، على يد الأمير التيموري ميران شاه، وممثلاً بشكل أخص بتلميذه محمود
بسيخاني المتوفي قرابة عام831ه/1427م، والغريب أن إقبالاً كان على معرفة بمحمود من
خلال المصادر التي بين يديه، وأهمها (دبستان مذاهب)، وقد أشار إليه في كتابه (تطور
الفكر الفلسفي في إيران) باسم وحيد الدين محمود، وعدّه رائد مذهب (التعدد) “الذي
قرر أن الحقيقة ليست واحدة، بل متعددة، وهي تمثل في الوحدات الأولية الحية التي
تتركب في شتى الصور، وتسمو بالتدرج نحو الكمال مروراً بسلم صعودي لهذه الأشكال
والصور”.
إقبال بهذا السرد التاريخي المبسّط والموجز للبابية، علماً أن البحث في جذور
البابية يمتد إلى مرحلة أبعد زمناً من الشيخية (أتباع الإحسائي) والكشفية (أتباع
كاظم الرشتي)، أقصد بذلك المدرسة أوالاتجاه الحروفي، ممثلاً بفضل الله الإسترابادي
الذي أعدم سنة 804، على يد الأمير التيموري ميران شاه، وممثلاً بشكل أخص بتلميذه محمود
بسيخاني المتوفي قرابة عام831ه/1427م، والغريب أن إقبالاً كان على معرفة بمحمود من
خلال المصادر التي بين يديه، وأهمها (دبستان مذاهب)، وقد أشار إليه في كتابه (تطور
الفكر الفلسفي في إيران) باسم وحيد الدين محمود، وعدّه رائد مذهب (التعدد) “الذي
قرر أن الحقيقة ليست واحدة، بل متعددة، وهي تمثل في الوحدات الأولية الحية التي
تتركب في شتى الصور، وتسمو بالتدرج نحو الكمال مروراً بسلم صعودي لهذه الأشكال
والصور”.
ويتوقف
إقبال عند سبق وحيد الدين محمود لـ (لايبنز) الذي رأى إن الكون هو تآلف مما سماه
بـ (أفراد) – أي وحدات أساسية – أو ذرات بسيطة وجدت منذ الأزل وأودعت فيها الحياة.
كان محمود
واحداً من أربعة من أقرب المقربين إلى الإسترابادي، لكنه ما لبث أن أقام قطيعة مع
الحروفية التي تؤكد أهمية أسرار الحروف، وأحكم بناء نظام يعتمد على (النقطة)، ومن
هنا عُرف اتجاهه بـ (النقطوية)، وقد عرض في كتبه الستة عشر، ورسائله التي روي أنها
بلغت ألف رسالة ورسالة مركزية (النقطة) وأهميتها في بناء فكر ميتافيزيقي متكامل،
وكان هذا الرجل الذي تمثل كل التراث الحروفي أعلن أنه هو محمود النبي العجمي الذي
بدئ به (دور العجم) في مقابل محمد النبي العربي الذي بدئ به (دور العرب)، وفي هذا
الإعلان تعبير عن تعاظم الشعور وتكامل الوعي بالقومية الفارسية، التي تشربت من
الموروث الزرداشتي فكرة التجدد الدوري للرسالات النبوية(7). هذه الفكرة التي نادى
بها الباب الذي لقّب نفسه أيضاً بـ (النقطة)، وتابعه فيما بعد البهاء، الذي أعلن
أن باب النبوة سيفتح من جديد بعد ألف عام من بعثته.
إقبال عند سبق وحيد الدين محمود لـ (لايبنز) الذي رأى إن الكون هو تآلف مما سماه
بـ (أفراد) – أي وحدات أساسية – أو ذرات بسيطة وجدت منذ الأزل وأودعت فيها الحياة.
كان محمود
واحداً من أربعة من أقرب المقربين إلى الإسترابادي، لكنه ما لبث أن أقام قطيعة مع
الحروفية التي تؤكد أهمية أسرار الحروف، وأحكم بناء نظام يعتمد على (النقطة)، ومن
هنا عُرف اتجاهه بـ (النقطوية)، وقد عرض في كتبه الستة عشر، ورسائله التي روي أنها
بلغت ألف رسالة ورسالة مركزية (النقطة) وأهميتها في بناء فكر ميتافيزيقي متكامل،
وكان هذا الرجل الذي تمثل كل التراث الحروفي أعلن أنه هو محمود النبي العجمي الذي
بدئ به (دور العجم) في مقابل محمد النبي العربي الذي بدئ به (دور العرب)، وفي هذا
الإعلان تعبير عن تعاظم الشعور وتكامل الوعي بالقومية الفارسية، التي تشربت من
الموروث الزرداشتي فكرة التجدد الدوري للرسالات النبوية(7). هذه الفكرة التي نادى
بها الباب الذي لقّب نفسه أيضاً بـ (النقطة)، وتابعه فيما بعد البهاء، الذي أعلن
أن باب النبوة سيفتح من جديد بعد ألف عام من بعثته.
أما
كيف حصل هذا التأثر والتأثير بين النقطوية والبابية فيزعم علي محمد ناظم الشريعة
أنّ علي محمد الشيرازي درس الفكرة النقطوية عندما كان مسجوناً في ماكو، وضمّن
أفكار النقطوية في نصّ كتابه (البيان العربي). ويقول عباس أمانات: “وربما تكون
قراءة النصوص النقطوية في الدوائر الصوفية قد تواصلت حتى بلغت القرن الثالث
عشر/التاسع عشر، والشبه الصارخ ما بين أفكار سيد علي محمد الشيرازي الباب
(1236-1266/1821-1850) مؤسس الحركة البابية ومعتقدات وممارسات النقطوية من الوضوح
بحيث تصعب نسبته إلى انتشار باطنية المناخ (الهرطقي) الفارسي فقط.
كيف حصل هذا التأثر والتأثير بين النقطوية والبابية فيزعم علي محمد ناظم الشريعة
أنّ علي محمد الشيرازي درس الفكرة النقطوية عندما كان مسجوناً في ماكو، وضمّن
أفكار النقطوية في نصّ كتابه (البيان العربي). ويقول عباس أمانات: “وربما تكون
قراءة النصوص النقطوية في الدوائر الصوفية قد تواصلت حتى بلغت القرن الثالث
عشر/التاسع عشر، والشبه الصارخ ما بين أفكار سيد علي محمد الشيرازي الباب
(1236-1266/1821-1850) مؤسس الحركة البابية ومعتقدات وممارسات النقطوية من الوضوح
بحيث تصعب نسبته إلى انتشار باطنية المناخ (الهرطقي) الفارسي فقط.
كما
لا يمكن لمثل هذه الصلة أن تنسب إلى مدرسة الشيخية لمؤسسها الشيخ أحمد الإحسائي
(ت: 1241/1825) وحسب، وهو الذي تأثر بشكل غير مباشر بالموضوعات ذات الصلة
بالإسماعيلية، كما كان الأمر مع خلفه سيد كاظم الرشتي”(8).
لقد كانت
البابية/البهائية وريثتا النقطوية باعتبارهما قد وضعتا حداً للدور الإسلامي برمته،
واستبدالتا به دوراً جديد، وهذا ما لم تفكر فيه (الشيخية) ولا (الكشفية)، ولا من
قبلهما (الإسماعيلية)، لأنهم نظروا إلى مهديهم على أنه سيفتتح طوراً مكملاً داخل
الدور الإسلامي، وليس عهداً جديداً يتجاوزه ويقع خارج نطاقه، وقرر وحيد الدين
محمود بسيخاني أنه عندما يسود هذا الدور الأخير سيكتشف الناس الحقيقة، ويعبدون
الإنسان، وسيدركون أن الجوهر الإنساني هو الحقيقة، ويلخص ذلك شعار النقطوية:
(استعن بنفسك الذي لا إله إلا هو) حيث يشير الضمير (هو) في السياق النقطوي إلى
المكانة الإلهية للإنسان في مركز الخلق.
لقد أنكرت
(النقطوية) الجنة والنار بمعانيها المعهودة، وجعلت (القيامة) حدثاً يقع في حياة
الإنسان نفسه، بسبب من أفعاله الخاصة، وليس حدثاً خارج سيطرته، ولا يقع إلا بعد
وفاته وحسب، أما أصحاب (النعيم) فليسوا سوى أهل (النقطة) الذين ينالون مكافآتهم
العالية في هذا العالم، لأنهم عرفوا محمود بسيخاني وآمنوا به، وبالمقابل فإنّ
أضداد محمود قد آلوا إلى هوة جحيم هذا العالم، لأنهم تجاهلوا مقدم النبي
الجديد(9)، وهذا ما تمثلته البابية تمثلاً تاماً في معتقدها حول عوالم الآخرة،
وسوف نعود لهذه المسألة في بحث آخر لنا.
لا يمكن لمثل هذه الصلة أن تنسب إلى مدرسة الشيخية لمؤسسها الشيخ أحمد الإحسائي
(ت: 1241/1825) وحسب، وهو الذي تأثر بشكل غير مباشر بالموضوعات ذات الصلة
بالإسماعيلية، كما كان الأمر مع خلفه سيد كاظم الرشتي”(8).
لقد كانت
البابية/البهائية وريثتا النقطوية باعتبارهما قد وضعتا حداً للدور الإسلامي برمته،
واستبدالتا به دوراً جديد، وهذا ما لم تفكر فيه (الشيخية) ولا (الكشفية)، ولا من
قبلهما (الإسماعيلية)، لأنهم نظروا إلى مهديهم على أنه سيفتتح طوراً مكملاً داخل
الدور الإسلامي، وليس عهداً جديداً يتجاوزه ويقع خارج نطاقه، وقرر وحيد الدين
محمود بسيخاني أنه عندما يسود هذا الدور الأخير سيكتشف الناس الحقيقة، ويعبدون
الإنسان، وسيدركون أن الجوهر الإنساني هو الحقيقة، ويلخص ذلك شعار النقطوية:
(استعن بنفسك الذي لا إله إلا هو) حيث يشير الضمير (هو) في السياق النقطوي إلى
المكانة الإلهية للإنسان في مركز الخلق.
لقد أنكرت
(النقطوية) الجنة والنار بمعانيها المعهودة، وجعلت (القيامة) حدثاً يقع في حياة
الإنسان نفسه، بسبب من أفعاله الخاصة، وليس حدثاً خارج سيطرته، ولا يقع إلا بعد
وفاته وحسب، أما أصحاب (النعيم) فليسوا سوى أهل (النقطة) الذين ينالون مكافآتهم
العالية في هذا العالم، لأنهم عرفوا محمود بسيخاني وآمنوا به، وبالمقابل فإنّ
أضداد محمود قد آلوا إلى هوة جحيم هذا العالم، لأنهم تجاهلوا مقدم النبي
الجديد(9)، وهذا ما تمثلته البابية تمثلاً تاماً في معتقدها حول عوالم الآخرة،
وسوف نعود لهذه المسألة في بحث آخر لنا.
أما
أهم مظاهر تأثر البابية/ البهائية بالنقطوية فهو تقديسهم الرقم 19، وجعل النظام
العقدي والتشريعي قائماً عليه وعلى مضاعفاته، وقد وجدت البابية لها مستنداً في هذا
التقديس في الآية 31 من سورة المدّثر، التي ورد فيها ذكر هذا الرقم(10).
أهم مظاهر تأثر البابية/ البهائية بالنقطوية فهو تقديسهم الرقم 19، وجعل النظام
العقدي والتشريعي قائماً عليه وعلى مضاعفاته، وقد وجدت البابية لها مستنداً في هذا
التقديس في الآية 31 من سورة المدّثر، التي ورد فيها ذكر هذا الرقم(10).
وينتقل
إقبال بعد ذلك إلى مهمته الرئيسة في دراسته فيلتقط الخيط الميتافيزيقي القابع في
عمق الحركة البابية والناظم لها، والذي يمثل عصب الرؤية فيها. يقول إقبال: “ويرى
المتنبئ الفارسي الشاب [يقصد علي محمد الشيرازي] أن الحقيقة تتمثل في جوهر أصلي لا
يقبل تفرقة بين الذات والصفات، وأول ما فاض عن هذا الجوهر الأول أو انبثق منه هو
الوجود:”الوجود هو المعلوم، والمعلوم هو جوهر المعرفة، والمعرفة إرادة، والإرادة
محبة“. وهكذا يصدر الباب عن التصور الذي قال به الملا صدرا عن”المعلوم والعالم“،
ليصل إلى تصوره هو الخاص بالحق والإرادة والحب. هذا الحب الأصلي الذي يعتبره الباب
الجوهر الحقيقي أو الحق الأول، وهو علة التجلي المتمثل في الكون الذي ليس هو شيئاً
أكثر من فيض المحبة وتمددها، وكلمة الخلق عنده لا تعني إبراز الأشياء من العدم المحض،
إذ الشيخية لا يرون الخلق أمراً مقصوراً على الله – تعالى – وحده، فالآية القرآنية: فتبارك الله أحسن الخالقين تتضمن
عندهم أن هناك موجودات أخرى لها فيوض وتجليات، كما هو الحال بالنسبة إلى الله
تعالى”(11).
إقبال بعد ذلك إلى مهمته الرئيسة في دراسته فيلتقط الخيط الميتافيزيقي القابع في
عمق الحركة البابية والناظم لها، والذي يمثل عصب الرؤية فيها. يقول إقبال: “ويرى
المتنبئ الفارسي الشاب [يقصد علي محمد الشيرازي] أن الحقيقة تتمثل في جوهر أصلي لا
يقبل تفرقة بين الذات والصفات، وأول ما فاض عن هذا الجوهر الأول أو انبثق منه هو
الوجود:”الوجود هو المعلوم، والمعلوم هو جوهر المعرفة، والمعرفة إرادة، والإرادة
محبة“. وهكذا يصدر الباب عن التصور الذي قال به الملا صدرا عن”المعلوم والعالم“،
ليصل إلى تصوره هو الخاص بالحق والإرادة والحب. هذا الحب الأصلي الذي يعتبره الباب
الجوهر الحقيقي أو الحق الأول، وهو علة التجلي المتمثل في الكون الذي ليس هو شيئاً
أكثر من فيض المحبة وتمددها، وكلمة الخلق عنده لا تعني إبراز الأشياء من العدم المحض،
إذ الشيخية لا يرون الخلق أمراً مقصوراً على الله – تعالى – وحده، فالآية القرآنية: فتبارك الله أحسن الخالقين تتضمن
عندهم أن هناك موجودات أخرى لها فيوض وتجليات، كما هو الحال بالنسبة إلى الله
تعالى”(11).
ويشير
إقبال في موطن آخر إلى الرأي الذي صدرت به البابية عن الملا صدرا، في مسألة
(المعلوم والعالم) فيقول: “إنّ مذهب صدر الدين في وحدة الذات والموضوع يمثل الخطوة
الأخيرة التي خطاها العقل الفارسي نحو الوحدة الخالصة، بل إنّ فلسفة صدر الدين هي
مصدر الميتافيزيقيا البابية”(12).
إقبال في موطن آخر إلى الرأي الذي صدرت به البابية عن الملا صدرا، في مسألة
(المعلوم والعالم) فيقول: “إنّ مذهب صدر الدين في وحدة الذات والموضوع يمثل الخطوة
الأخيرة التي خطاها العقل الفارسي نحو الوحدة الخالصة، بل إنّ فلسفة صدر الدين هي
مصدر الميتافيزيقيا البابية”(12).
واستطراداً
أقول إن هذه المسألة عرفت في التراث الفلسفي الإسلامي باسم (اتحاد العاقل
والمعقول)، غير أن الاتجاه الصوفي المتسرب إلى العرفانيين المسلمين كان لا يحبذ
استخدام كلمة (العقل) كثيراً فحوّرها إلى (اتحاد العالم والمعلوم)، وهي مسألة
تتعلق بنظرية المعرفة، ونجد أصولها عند أفلاطون وأرسطو وأفلوطين، ثم انتقلت إلى
الفلاسفة المسلمين بدءاً من الكندي إلى الفارابي، ثم إلى ابن سينا الذي تردد بين
قبولها وإنكارها، ثم نجد صدر الدين القونوي (ت: 673هـ/1274م) التلميذ الأبرز لمحيي
الدين بن عربي يتناول هذه المسألة ويقررها في (رسالة النصوص)، ولكن يعد الملا صدرا
بحق آخر فيلسوف كبير تناول في العصور الأخيرة هذه المسألة، ويشير ملا صدرا في
كتابه (الأسفار الأربعة) إلى أنّ هذه المسألة من أعقد المسائل الفلسفية التي لم
يفتح مغالقها أي من علماء الإسلام حتى ذلك الزمان، ويشير إلى أنه تضرع إلى الله أن
يفتح هذا الباب أمامه، فاستجيب دعاؤه، ومنحه الله علماً جديداً حول هذه المسألة.
وبإمكان المستزيد أن يراجع (الأسفار الأربعة) ففيها عرض المسألة وبراهينها،
ومناقشة استدلالات ابن سينا في إبطالها.
أقول إن هذه المسألة عرفت في التراث الفلسفي الإسلامي باسم (اتحاد العاقل
والمعقول)، غير أن الاتجاه الصوفي المتسرب إلى العرفانيين المسلمين كان لا يحبذ
استخدام كلمة (العقل) كثيراً فحوّرها إلى (اتحاد العالم والمعلوم)، وهي مسألة
تتعلق بنظرية المعرفة، ونجد أصولها عند أفلاطون وأرسطو وأفلوطين، ثم انتقلت إلى
الفلاسفة المسلمين بدءاً من الكندي إلى الفارابي، ثم إلى ابن سينا الذي تردد بين
قبولها وإنكارها، ثم نجد صدر الدين القونوي (ت: 673هـ/1274م) التلميذ الأبرز لمحيي
الدين بن عربي يتناول هذه المسألة ويقررها في (رسالة النصوص)، ولكن يعد الملا صدرا
بحق آخر فيلسوف كبير تناول في العصور الأخيرة هذه المسألة، ويشير ملا صدرا في
كتابه (الأسفار الأربعة) إلى أنّ هذه المسألة من أعقد المسائل الفلسفية التي لم
يفتح مغالقها أي من علماء الإسلام حتى ذلك الزمان، ويشير إلى أنه تضرع إلى الله أن
يفتح هذا الباب أمامه، فاستجيب دعاؤه، ومنحه الله علماً جديداً حول هذه المسألة.
وبإمكان المستزيد أن يراجع (الأسفار الأربعة) ففيها عرض المسألة وبراهينها،
ومناقشة استدلالات ابن سينا في إبطالها.
وتجدر
الإشارة هنا إلى أن سيد حسين نصر عدّ نسبة ظهور البابية إلى مدرسة ملا صدرا من
أخطاء إقبال في كتابه (تطور الفكر الديني في إيران) على اعتبار أن الباب كان تلميذ
مدرسة الشيخ أحمد الإحسائي الذي كتب شرحاً مناقضاً لأحد كتب ملا صدرا“(13).
الإشارة هنا إلى أن سيد حسين نصر عدّ نسبة ظهور البابية إلى مدرسة ملا صدرا من
أخطاء إقبال في كتابه (تطور الفكر الديني في إيران) على اعتبار أن الباب كان تلميذ
مدرسة الشيخ أحمد الإحسائي الذي كتب شرحاً مناقضاً لأحد كتب ملا صدرا“(13).
غير
أن سيد حسين نصر على جلالة اطلاعه ومعرفته وفهمه، كان متسرعاً في تخطئة إقبال، ذلك
أن الشيخ الإحسائي الذي لم يتخذ أستاذاً، ولم يشر في كل مؤلفاته إلى أي أحد
باعتباره أستاذاً له، كان قد تتلمذ فعلياً على مؤلفات ملا صدرا، ولا سيما في شرحه
للكافي، وفي كتابه الفلسفي العرفاني مفاتيح الغيب، فضلاً عن الأسفار الأربعة،
فتشرّب صفوتها ولبابها، حتى إذا ما ألّف وكتب احتذى مثالها، وأعاد إنتاجها.
أن سيد حسين نصر على جلالة اطلاعه ومعرفته وفهمه، كان متسرعاً في تخطئة إقبال، ذلك
أن الشيخ الإحسائي الذي لم يتخذ أستاذاً، ولم يشر في كل مؤلفاته إلى أي أحد
باعتباره أستاذاً له، كان قد تتلمذ فعلياً على مؤلفات ملا صدرا، ولا سيما في شرحه
للكافي، وفي كتابه الفلسفي العرفاني مفاتيح الغيب، فضلاً عن الأسفار الأربعة،
فتشرّب صفوتها ولبابها، حتى إذا ما ألّف وكتب احتذى مثالها، وأعاد إنتاجها.
أما
مناقضته لملا صدرا فكانت بذريعة أن ملا صدرا يميل إلى أقوال أشخاص مثل ابن عربي،
وأنه يؤوّل أحاديث الأئمة لتوافق أقوال أهل التصوف والحكماء، في حين أن الإحسائي
لا يسير، كما توهّم، إلا على مذاق أئمة الهدى الاثني عشرية.
مناقضته لملا صدرا فكانت بذريعة أن ملا صدرا يميل إلى أقوال أشخاص مثل ابن عربي،
وأنه يؤوّل أحاديث الأئمة لتوافق أقوال أهل التصوف والحكماء، في حين أن الإحسائي
لا يسير، كما توهّم، إلا على مذاق أئمة الهدى الاثني عشرية.
وتبقى
ملاحظة أخيرة وهي أنه كان يجدر بإقبال، وهو البارع في تتبع سلاسل أسانيد الأفكار
وأنسابها، أن يتلمس الأصل الأفلوطيني لأفكار الشيخية في عملية الخلق، ذلك الأصل
القائم على الفيض المتوالي لدرجات الملكوت، والذي بلوره وكيّفه إسلامياً ابن
سينا حين وصف عملية صدور الكون بحسب المبدأ القائل: (إن الواحد لا يصدر عنه إلا
واحد)، والقائل: (إن الخلق يحدث عن طريق التعقل).
ملاحظة أخيرة وهي أنه كان يجدر بإقبال، وهو البارع في تتبع سلاسل أسانيد الأفكار
وأنسابها، أن يتلمس الأصل الأفلوطيني لأفكار الشيخية في عملية الخلق، ذلك الأصل
القائم على الفيض المتوالي لدرجات الملكوت، والذي بلوره وكيّفه إسلامياً ابن
سينا حين وصف عملية صدور الكون بحسب المبدأ القائل: (إن الواحد لا يصدر عنه إلا
واحد)، والقائل: (إن الخلق يحدث عن طريق التعقل).
وينتقل
إقبال بعد ذلك للحديث عن رؤية البهاء الميتافيزيقية مقارناً بينه وبين بوذا وشوبنهاور،
لأن:”خلاصة النظر المثالي في الهند تتمثل في بوذا، وفي إيران في بهاء الله، وفي
الغرب في شوبنهور“(14). يقول إقبال:”وبعد مقتل علي محمد الشيرازي الباب، قام على
الدعوة أحد كبار حوارييه (بهاء الله) الذي كانوا يطلقون عليه لقب (الوحدة الأولى)،
والذي أعلن نفسه صاحب الدور الجديد، والإمام الغائب الذي بشّر بظهوره الباب، وحرر
مذهب شيخه من الاتجاه الباطني الحروفي، وقدّمه في صورة أكثر اتساقاً واكتمالاً،
فالحقيقة النهائية عنده ليست شخصاً أوذاتاً، وإنما هي جوهر حق خالد نخلع عليه نحن
صفات الحقية والحب. لا لشيء إلا لأن هذه الصفات هي أرفع التصورات المعلومة لنا.
والمبدأ الحي للوجود يتجلى في الكون الخارجي بأن يوجد في داخله وحدات أومراكز
واعية كتلك التي يقول عنها الدكتور (كيتا جرت): “إنها تشكل تأكيداً جديداً لفكرة
المطلق الهيجلي”. وفي كل واحدة من هذه الذرات المتشابهة أو مراكز الوعي يكمن شعاع
من النور المطلق نفسه، ويتمثل كمال الروح في التحقيق التدريجي لكافة الإمكانات
العاطفية والفكرية المتضمنة فيه، وذلك عن طريق التغلغل في الكيان المادي الذي يعطي
للروح تشخصها. وهذا التحقيق التدريجي لإمكانات الروح المختلفة هو الذي يعينها على اكتشاف
حقيقة وجودها العميق، وهو شعاع الحب الخالد الذي استقر في أعماق الضمير. فجوهر
الإنسان إذاً لا يتمثل في العقل أو مجرّد الوعي، وإنما في هذا الشعاع، شعاع الحب
الذي هو مبعث كل فعل نبيل خالص، وفي هذا تتمثل حقيقة الإنسان، وفي هذا الطرح يتمثل
بوضوح التأثر بمذهب الملا صدرا القائل باستغناء الخيال عن البدن.
إقبال بعد ذلك للحديث عن رؤية البهاء الميتافيزيقية مقارناً بينه وبين بوذا وشوبنهاور،
لأن:”خلاصة النظر المثالي في الهند تتمثل في بوذا، وفي إيران في بهاء الله، وفي
الغرب في شوبنهور“(14). يقول إقبال:”وبعد مقتل علي محمد الشيرازي الباب، قام على
الدعوة أحد كبار حوارييه (بهاء الله) الذي كانوا يطلقون عليه لقب (الوحدة الأولى)،
والذي أعلن نفسه صاحب الدور الجديد، والإمام الغائب الذي بشّر بظهوره الباب، وحرر
مذهب شيخه من الاتجاه الباطني الحروفي، وقدّمه في صورة أكثر اتساقاً واكتمالاً،
فالحقيقة النهائية عنده ليست شخصاً أوذاتاً، وإنما هي جوهر حق خالد نخلع عليه نحن
صفات الحقية والحب. لا لشيء إلا لأن هذه الصفات هي أرفع التصورات المعلومة لنا.
والمبدأ الحي للوجود يتجلى في الكون الخارجي بأن يوجد في داخله وحدات أومراكز
واعية كتلك التي يقول عنها الدكتور (كيتا جرت): “إنها تشكل تأكيداً جديداً لفكرة
المطلق الهيجلي”. وفي كل واحدة من هذه الذرات المتشابهة أو مراكز الوعي يكمن شعاع
من النور المطلق نفسه، ويتمثل كمال الروح في التحقيق التدريجي لكافة الإمكانات
العاطفية والفكرية المتضمنة فيه، وذلك عن طريق التغلغل في الكيان المادي الذي يعطي
للروح تشخصها. وهذا التحقيق التدريجي لإمكانات الروح المختلفة هو الذي يعينها على اكتشاف
حقيقة وجودها العميق، وهو شعاع الحب الخالد الذي استقر في أعماق الضمير. فجوهر
الإنسان إذاً لا يتمثل في العقل أو مجرّد الوعي، وإنما في هذا الشعاع، شعاع الحب
الذي هو مبعث كل فعل نبيل خالص، وفي هذا تتمثل حقيقة الإنسان، وفي هذا الطرح يتمثل
بوضوح التأثر بمذهب الملا صدرا القائل باستغناء الخيال عن البدن.
والعقلُ
الذي يحتل مرتبة أعلى من الخيال في سلم التطور ليس شرطاً ضرورياً في نظر الملا
صدرا للبقاء أو الخلود، وفي كل صور الحياة يوجد جزء وحي خالد هو شعاع الحب الخالد
الذي لا يرتبط بالضرورة بالعقل أو الوعي الذاتي، ويبقى بعد فناء البدن.
والخلاص الذي
يتمثل عند بوذا في إنهاك الذرات العقلية بالقضاء على الشهوات إنما يتمثّل في نظر
بهاء الله في اكتشاف جوهر الحب الذي يكمن في مراكز الوعي نفسها.
الذي يحتل مرتبة أعلى من الخيال في سلم التطور ليس شرطاً ضرورياً في نظر الملا
صدرا للبقاء أو الخلود، وفي كل صور الحياة يوجد جزء وحي خالد هو شعاع الحب الخالد
الذي لا يرتبط بالضرورة بالعقل أو الوعي الذاتي، ويبقى بعد فناء البدن.
والخلاص الذي
يتمثل عند بوذا في إنهاك الذرات العقلية بالقضاء على الشهوات إنما يتمثّل في نظر
بهاء الله في اكتشاف جوهر الحب الذي يكمن في مراكز الوعي نفسها.
ولكن
كلاً منهما يقول بأن أفكار الإنسان وخلائقه تبقى بعد الموت مع سائر القوى المماثلة
في العالم الروحي منتظرة فرصة أخرى، أي كياناً بدنياً مناسباً لتحل فيه كي تواصل
عملية الاكتشاف التي قال بها بهاء الله، أو عملية الفناء التي قال بها بوذا. هذا
التصور الخالص للحب عند بهاء الله هو أعلى من تصوره للإرادة. أما شوبنهاور فإنه
يرى الحقيقة متمثلة في الإرادة التي هي مدفوعة إلى أن تحقق ذاتها موضوعياً بدافع
آثم يكمن على الدوام في طبيعتها الخالصة. والحب والإرادة عند كلا المفكرين يوجدان
في كل ذرة من ذرات الحياة، ولكن سبب وجودهما هناك هو المتعة المتمثلة في تحقيق
الذات من ناحية، ومن ناحية أخرى ميول ورغبات شريرة لا يمكن تفسيرها، غير أن
شوبنهاور يفترض عدة أفكار معينة لتبرير هذا التحقق الخارجي لتلك الإرادة الأولى،
على حين لا يقدّم بهاء الله – في حدود علمي – أي تفسير للمبدأ الذي يقوم عليه
تصوره الخاص لتجلي الحب الخالد وتحققه في الكون“(15).
كلاً منهما يقول بأن أفكار الإنسان وخلائقه تبقى بعد الموت مع سائر القوى المماثلة
في العالم الروحي منتظرة فرصة أخرى، أي كياناً بدنياً مناسباً لتحل فيه كي تواصل
عملية الاكتشاف التي قال بها بهاء الله، أو عملية الفناء التي قال بها بوذا. هذا
التصور الخالص للحب عند بهاء الله هو أعلى من تصوره للإرادة. أما شوبنهاور فإنه
يرى الحقيقة متمثلة في الإرادة التي هي مدفوعة إلى أن تحقق ذاتها موضوعياً بدافع
آثم يكمن على الدوام في طبيعتها الخالصة. والحب والإرادة عند كلا المفكرين يوجدان
في كل ذرة من ذرات الحياة، ولكن سبب وجودهما هناك هو المتعة المتمثلة في تحقيق
الذات من ناحية، ومن ناحية أخرى ميول ورغبات شريرة لا يمكن تفسيرها، غير أن
شوبنهاور يفترض عدة أفكار معينة لتبرير هذا التحقق الخارجي لتلك الإرادة الأولى،
على حين لا يقدّم بهاء الله – في حدود علمي – أي تفسير للمبدأ الذي يقوم عليه
تصوره الخاص لتجلي الحب الخالد وتحققه في الكون“(15).
وليس
لنا أمام هذا التلخيص الجميل والتكثيف المبدع سوى ملاحظتين:
الملاحظة
الأولى: كنا نأمل أن يذكر لنا إقبال المصدر الذي استقى منه فكرة أن البهائية ترى
أن أفكار الإنسان وخلائقه تبقى بعد الموت مع سائر القوى المماثلة في العالم الروحي
منتظرة فرصة أخرى، أي كياناً بدنياً مناسباً لتحل فيه، لأن المثبت في مصادر
البهائية ومراجعها إنكارها فكرة التناسخ والتقمص، ورفضها لها، حتى إنّ عباس أفندي
ابن البهاء خصص مقالة كاملة لدحض هذه الفكرة ولإثبات بطلانها.
الملاحظة
الثانية: ما ذكره إقبال حول عدم تفسير بهاء الله للمبدأ الذي يقوم عليه تصوره
لتجلي الحب الخالد وتحققه في الكون هو أمر صحيح، ولكن إقبال المولع بالكشف عن
مصادر الأفكار، وبردها إلى منابعها لم يذكر أن البهاء لم يكن مبتكر هذه الرؤية، بل
كان متتبعاً الطرح السينوي الذي يرى أن السبب في وجود العالم المخلوق هو نتيجة
للعشق المتدفق في شرايين الكون، والصادر عن”الموجود المقدس عن الوقوع تحت
التدبير“، وقد أفرد ابن سينا لبيان ذلك رسالته (رسالة في العشق).
لنا أمام هذا التلخيص الجميل والتكثيف المبدع سوى ملاحظتين:
الملاحظة
الأولى: كنا نأمل أن يذكر لنا إقبال المصدر الذي استقى منه فكرة أن البهائية ترى
أن أفكار الإنسان وخلائقه تبقى بعد الموت مع سائر القوى المماثلة في العالم الروحي
منتظرة فرصة أخرى، أي كياناً بدنياً مناسباً لتحل فيه، لأن المثبت في مصادر
البهائية ومراجعها إنكارها فكرة التناسخ والتقمص، ورفضها لها، حتى إنّ عباس أفندي
ابن البهاء خصص مقالة كاملة لدحض هذه الفكرة ولإثبات بطلانها.
الملاحظة
الثانية: ما ذكره إقبال حول عدم تفسير بهاء الله للمبدأ الذي يقوم عليه تصوره
لتجلي الحب الخالد وتحققه في الكون هو أمر صحيح، ولكن إقبال المولع بالكشف عن
مصادر الأفكار، وبردها إلى منابعها لم يذكر أن البهاء لم يكن مبتكر هذه الرؤية، بل
كان متتبعاً الطرح السينوي الذي يرى أن السبب في وجود العالم المخلوق هو نتيجة
للعشق المتدفق في شرايين الكون، والصادر عن”الموجود المقدس عن الوقوع تحت
التدبير“، وقد أفرد ابن سينا لبيان ذلك رسالته (رسالة في العشق).
ختاماً:
كان إقبال هو
أول مسلم يكشف لنا بقلمه البارع معالم البابية والبهائية، ويقدم خلاصة وافية
حولهما، وقد اتضح لنا اطلاعه العميق عليهما، وقدراته الفذة في التحليل والمقارنة
مع الأفكار البعيدة والقريبة زمنياً للباب والبهاء إن في الشرق أو في الغرب، من
دون أدنى تحيّز أوتحامل على هذه الأفكار أو تلك الشخصيات، التي تعد مارقة في نظر
إقبال نفسه، وفي نظر كل المسلمين، لكن إقبالاً يأبى إلا أن يكون ذلك الأمين في نقله،
والوفي في شرحه، ولا شك في أن الأمانة والوفاء تعرفان للمرء حقه في حياته وتحفظان
حرمته بعد مماته، من أجل ذلك سنظل ننظر لمحمد إقبال بكامل التقدير والاعتبار
والاحترام.
كان إقبال هو
أول مسلم يكشف لنا بقلمه البارع معالم البابية والبهائية، ويقدم خلاصة وافية
حولهما، وقد اتضح لنا اطلاعه العميق عليهما، وقدراته الفذة في التحليل والمقارنة
مع الأفكار البعيدة والقريبة زمنياً للباب والبهاء إن في الشرق أو في الغرب، من
دون أدنى تحيّز أوتحامل على هذه الأفكار أو تلك الشخصيات، التي تعد مارقة في نظر
إقبال نفسه، وفي نظر كل المسلمين، لكن إقبالاً يأبى إلا أن يكون ذلك الأمين في نقله،
والوفي في شرحه، ولا شك في أن الأمانة والوفاء تعرفان للمرء حقه في حياته وتحفظان
حرمته بعد مماته، من أجل ذلك سنظل ننظر لمحمد إقبال بكامل التقدير والاعتبار
والاحترام.
الهوامش:
(1) ترجمت هذه
الرسالة إلى العربية مرتين: الأولى أعدها الدكتور مجيب مصري اعتماداً على ترجمة
فرنسية، فكان هذا مسوّغاً للدكتورين حسن الشافعي ومحمد السعيد جمال الدين
ليترجماها عن أصلها الإنجليزي تحت عنوان:”تطور الفكر الديني في إيران: إسهام في
تاريخ الفلسفة الإسلامية“.
(2) انظر: د.
حسن الشافعي، ود. محمد السعيد جمال الدين،”تطور الفكر الديني في إيران“، ص 8.
(3) انظر: محمد
إقبال،”تطور الفكر الديني في إيران“، ص 134.
(4) لد الشيخ
أحمد بن زين الدين في الإحساء في عام 1166هـ/1752م، وطلب العلم في العراق وفارس،
وظل يتنقّل بينهما إلى أن وافاه الأجل حاجاً قرب المدينة المنورة، فحُمل إليها،
ودفن فيها في عام 1241هـ/1826م.
أسس (الشيخ)
مدرسة فكرية خاصة قوامها مزيج عرفاني فلسفي لاهوتي مستلهم من النصوص والروايات
الشيعية المغالية، فقدّم نظرية غنوصية مغايرة لما هو شائع في أدبيات العرفان
الشيعي، وتبنى نظرية (التفويض) القائلة:”إن الله سبحانه قد فوّض الأئمة بإدارة شؤون
العالم“، وهذا ما قاده إلى تأليه الأئمة، كما أضاف إلى أركان الدين المجمع عليها
لدى الشيعة (التوحيد – النبوة – الإمامة ) ركناً رابعاً هو (الوساطة) بين الخلق
والإمام الغائب.
كان الشيخ إضافة
إلى علمه الغزير واطلاعه المستفيض ومؤلفاته التي نافت على مئة كتاب ورسالة ذا
مجاهدات وأحوال ورؤى وشطحات، وكان مع ذلك شديد الإنكار على المتصوفة، ومعادياً
لهم، أما أبرز شطحاته فكانت دعواه أنه هو (الوسيط) بين الخلق وبين الإمام الغائب.
كانت آراء الشيخ
بالكامل قائمة على التأويل الباطني، واستناداً لذلك تناول مجمل عالم (المعاد)
بنظرة جديدة، فتحدث عن جنتين وجهنمين، الأولى في الدنيا، والثانية في الآخرة، وقرر
أن (الجنة) هي (الولاية) ذاتها، والانتصار للقائم، كما ادعى أن الإنسان لن يبعث
بجسده المعروف يوم القيامة، وإنما سيبعث بجسم لطيف دعاه بالجسم (الهورقليائي) الذي
يتلاءم مع عالم الجنة، واستناداً لهذه الفكرة قرر أن النبي لم يعرج بجسمه البشري،
بل بالجسم الهورقليائي.
أما أهم دعوة له
فكانت تبشيره بقرب ظهور محبوب القلوب الإمام المهدي، بل وضرب موعداً لظهوره قبيل
وفاته لا يتعدى العشرين عاماً، أي في سنة 1260ه.
(5) كان الشيخ
كاظم الرشتي متشبعاً بأفكار الشيخ أحمد وعاملاً على ترسيخها وتطويرها وحلّ الكثير
من مشكلاتها، وكما تعرَّض الشيخ أحمد لسلسلة من المحاكمات والمحاجات العنيفة التي
وصلت إلى حد تكفيره والدعوة لقتله فإن خليفته الرشتي تعرض للمحن ذاتها التي امتدت
لإطلاق النار عليه مرة في النجف الأشرف.
كان الرشتي
عالماً متقناً ومؤلفاً بارعاً، ومن مؤلفاته: رسائل الرشتي، وأصول العقائد، وبيان
مقامات الظاهر والباطن، ودليل المتحيرين، وقد استقطب بالإضافة إلى تلاميذ (الشيخ)
نخبة من التلاميذ الإيرانيين حيث كان يلقي محاضراته عليهم في كربلاء. توفي في
1259ه – 1843م.
(6) انظر: محمد
إقبال،”تطور الفكر الديني في إيران“، ص 135.
(7) انظر: عباس
آمانات،”حركة محمود بسيخاني النقطوية، ودوره المادي – الصوفي العجمي“. بحث في
كتاب: د. فرهاد دفتري،”الإسماعيليون في العصر الوسيط“. تر: سيف الدين القصير.
ط:1، دار المدى: دمشق – بيروت، سنة 1999م، ص 289 وما بعدها. ومما جاء
فيه:”نظر محمود إلى مجمل الحياة الزمنية للعالم على أساس من أربعة أدوار فوقية، كل
دور منها من (16000) سنة تغطي كامل الفترة من بداية خلق العالم وحتى نهايته، ولا
تزال البشرية الآن في الدور الأول من هذه الأدوار الفوقية، الذي يتكون هو نفسه من
دورين متتاليين أقصر زماناً: الثمانية آلاف سنة الأولى، وهو الدور العربي، طبقاً
لاعتقاد محمود، الذي ابتدأ بآدم، واستمر مع ستة أنبياء آخرين واختتم بمحمد. أما
الثمانية آلاف سنة الثانية في الكوزمولوجية النقطوية، أو الدور الفارسي (العجمي)
فقد ابتدأت بمحمود وستستمر بعده مع سبعة ظهورات متتالية مقترنة بما يسمى
بالمبيينين“، ومن هنا فقد ادعى الباب والبهاء أنهما ظهوران إلهيان متتاليان.
(8) المصدر
السابق: ص 304.
(9) المصدر
نفسه، ص 298
(10) وأذكر هنا
استطراداً تلك الزوبعة التي خلّفها الدكتور المصري رشاد خليفة عندما نشر كتيبه في
بداية الثمانينات حول الإعجاز العددي للرقم 19 في القرآن الكريم، ويومها كنّا
طلاباً في المرحلة الإعدادية، فحثنا أساتذتنا ومشايخنا على قراءة معلوماته التي
عُدّت فتحاً مبيناً، وعندما ادعى هذا المؤلف النبوة تنبه الناس إلى أن (البهائية)
هي التي كانت تقدس هذا الرقم، فانفض العلماء والمشايخ عن إعجابهم وانبهارهم، وصدرت
الفتاوى بتكفير رشاد خليفة وهدر دمه، وفي سنة 1990 تم قتله في المسجد الذي كان
يرتاده في مدينة توسان الأمريكية غير أن موضة الإعجاز العددي التي نبّه رشاد الناس
لها ما زالت مستمرة إلى اليوم لدى كثير من دارسي القرآن، وكأن الاتجاه الحروفي
يأبى التلاشي والاندثار.
(11) انظر: محمد
إقبال،”تطور الفكر الديني في إيران“، ص135.
(12) المصدر
نفسه، ص 128.
(13) انظر: سيد
حسين نصر،”ثلاثة حكماء مسلمين“. نقله عن الإنجليزية: صلاح الصاوي، راجع
الترجمة ونقحها: ماجد فخري. دار النهار: بيروت، 1986م، ص194.
(14) انظر: محمد
إقبال،”تطور الفكر الديني في إيران”. ص14
(15) المصدر
السابق، ص137.
(1) ترجمت هذه
الرسالة إلى العربية مرتين: الأولى أعدها الدكتور مجيب مصري اعتماداً على ترجمة
فرنسية، فكان هذا مسوّغاً للدكتورين حسن الشافعي ومحمد السعيد جمال الدين
ليترجماها عن أصلها الإنجليزي تحت عنوان:”تطور الفكر الديني في إيران: إسهام في
تاريخ الفلسفة الإسلامية“.
(2) انظر: د.
حسن الشافعي، ود. محمد السعيد جمال الدين،”تطور الفكر الديني في إيران“، ص 8.
(3) انظر: محمد
إقبال،”تطور الفكر الديني في إيران“، ص 134.
(4) لد الشيخ
أحمد بن زين الدين في الإحساء في عام 1166هـ/1752م، وطلب العلم في العراق وفارس،
وظل يتنقّل بينهما إلى أن وافاه الأجل حاجاً قرب المدينة المنورة، فحُمل إليها،
ودفن فيها في عام 1241هـ/1826م.
أسس (الشيخ)
مدرسة فكرية خاصة قوامها مزيج عرفاني فلسفي لاهوتي مستلهم من النصوص والروايات
الشيعية المغالية، فقدّم نظرية غنوصية مغايرة لما هو شائع في أدبيات العرفان
الشيعي، وتبنى نظرية (التفويض) القائلة:”إن الله سبحانه قد فوّض الأئمة بإدارة شؤون
العالم“، وهذا ما قاده إلى تأليه الأئمة، كما أضاف إلى أركان الدين المجمع عليها
لدى الشيعة (التوحيد – النبوة – الإمامة ) ركناً رابعاً هو (الوساطة) بين الخلق
والإمام الغائب.
كان الشيخ إضافة
إلى علمه الغزير واطلاعه المستفيض ومؤلفاته التي نافت على مئة كتاب ورسالة ذا
مجاهدات وأحوال ورؤى وشطحات، وكان مع ذلك شديد الإنكار على المتصوفة، ومعادياً
لهم، أما أبرز شطحاته فكانت دعواه أنه هو (الوسيط) بين الخلق وبين الإمام الغائب.
كانت آراء الشيخ
بالكامل قائمة على التأويل الباطني، واستناداً لذلك تناول مجمل عالم (المعاد)
بنظرة جديدة، فتحدث عن جنتين وجهنمين، الأولى في الدنيا، والثانية في الآخرة، وقرر
أن (الجنة) هي (الولاية) ذاتها، والانتصار للقائم، كما ادعى أن الإنسان لن يبعث
بجسده المعروف يوم القيامة، وإنما سيبعث بجسم لطيف دعاه بالجسم (الهورقليائي) الذي
يتلاءم مع عالم الجنة، واستناداً لهذه الفكرة قرر أن النبي لم يعرج بجسمه البشري،
بل بالجسم الهورقليائي.
أما أهم دعوة له
فكانت تبشيره بقرب ظهور محبوب القلوب الإمام المهدي، بل وضرب موعداً لظهوره قبيل
وفاته لا يتعدى العشرين عاماً، أي في سنة 1260ه.
(5) كان الشيخ
كاظم الرشتي متشبعاً بأفكار الشيخ أحمد وعاملاً على ترسيخها وتطويرها وحلّ الكثير
من مشكلاتها، وكما تعرَّض الشيخ أحمد لسلسلة من المحاكمات والمحاجات العنيفة التي
وصلت إلى حد تكفيره والدعوة لقتله فإن خليفته الرشتي تعرض للمحن ذاتها التي امتدت
لإطلاق النار عليه مرة في النجف الأشرف.
كان الرشتي
عالماً متقناً ومؤلفاً بارعاً، ومن مؤلفاته: رسائل الرشتي، وأصول العقائد، وبيان
مقامات الظاهر والباطن، ودليل المتحيرين، وقد استقطب بالإضافة إلى تلاميذ (الشيخ)
نخبة من التلاميذ الإيرانيين حيث كان يلقي محاضراته عليهم في كربلاء. توفي في
1259ه – 1843م.
(6) انظر: محمد
إقبال،”تطور الفكر الديني في إيران“، ص 135.
(7) انظر: عباس
آمانات،”حركة محمود بسيخاني النقطوية، ودوره المادي – الصوفي العجمي“. بحث في
كتاب: د. فرهاد دفتري،”الإسماعيليون في العصر الوسيط“. تر: سيف الدين القصير.
ط:1، دار المدى: دمشق – بيروت، سنة 1999م، ص 289 وما بعدها. ومما جاء
فيه:”نظر محمود إلى مجمل الحياة الزمنية للعالم على أساس من أربعة أدوار فوقية، كل
دور منها من (16000) سنة تغطي كامل الفترة من بداية خلق العالم وحتى نهايته، ولا
تزال البشرية الآن في الدور الأول من هذه الأدوار الفوقية، الذي يتكون هو نفسه من
دورين متتاليين أقصر زماناً: الثمانية آلاف سنة الأولى، وهو الدور العربي، طبقاً
لاعتقاد محمود، الذي ابتدأ بآدم، واستمر مع ستة أنبياء آخرين واختتم بمحمد. أما
الثمانية آلاف سنة الثانية في الكوزمولوجية النقطوية، أو الدور الفارسي (العجمي)
فقد ابتدأت بمحمود وستستمر بعده مع سبعة ظهورات متتالية مقترنة بما يسمى
بالمبيينين“، ومن هنا فقد ادعى الباب والبهاء أنهما ظهوران إلهيان متتاليان.
(8) المصدر
السابق: ص 304.
(9) المصدر
نفسه، ص 298
(10) وأذكر هنا
استطراداً تلك الزوبعة التي خلّفها الدكتور المصري رشاد خليفة عندما نشر كتيبه في
بداية الثمانينات حول الإعجاز العددي للرقم 19 في القرآن الكريم، ويومها كنّا
طلاباً في المرحلة الإعدادية، فحثنا أساتذتنا ومشايخنا على قراءة معلوماته التي
عُدّت فتحاً مبيناً، وعندما ادعى هذا المؤلف النبوة تنبه الناس إلى أن (البهائية)
هي التي كانت تقدس هذا الرقم، فانفض العلماء والمشايخ عن إعجابهم وانبهارهم، وصدرت
الفتاوى بتكفير رشاد خليفة وهدر دمه، وفي سنة 1990 تم قتله في المسجد الذي كان
يرتاده في مدينة توسان الأمريكية غير أن موضة الإعجاز العددي التي نبّه رشاد الناس
لها ما زالت مستمرة إلى اليوم لدى كثير من دارسي القرآن، وكأن الاتجاه الحروفي
يأبى التلاشي والاندثار.
(11) انظر: محمد
إقبال،”تطور الفكر الديني في إيران“، ص135.
(12) المصدر
نفسه، ص 128.
(13) انظر: سيد
حسين نصر،”ثلاثة حكماء مسلمين“. نقله عن الإنجليزية: صلاح الصاوي، راجع
الترجمة ونقحها: ماجد فخري. دار النهار: بيروت، 1986م، ص194.
(14) انظر: محمد
إقبال،”تطور الفكر الديني في إيران”. ص14
(15) المصدر
السابق، ص137.
محمد أمير ناشر النعم