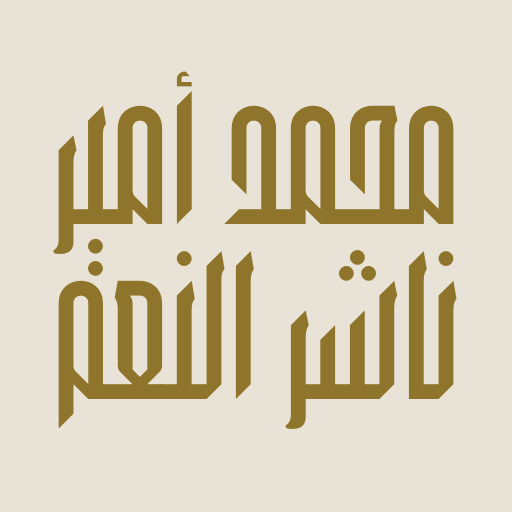تُدَلّي الأَسْطَرة زَنْبيلها
تُدَلّي الأَسْطَرة زَنْبيلهابكل حيادية وعدالة وكرم لكل من شاء أن يغرف منه أو أن يرتمس فيه. تمدُّ المتديّن،
وتغدق على الملحد! تُنعم على السياسي، وتدعم العسكري! تنيل الأديب، وتنفح الشاعر، فلكل
مجتهد منها نصيب! لذا ترانا نرفل بالأساطير! نمشي بها متبخترين، ونجرّ أذيالها
مختالين، بخلاف جميع الكائنات العلوية والسفلية من العالمين.
أدواتها عديدة وأسبابها مختلفة، تُجدل ضفيرتها بالصدق
والكذب، بالحذق والحمق، بالأمانة والخيانة، بالحيلة والفتيلة! من أجل ذلك يُرى
حبلها قصيراً تارة، وطويلاً أخرى، ضعيفاً مرة، قوياً أخرى.
والكذب، بالحذق والحمق، بالأمانة والخيانة، بالحيلة والفتيلة! من أجل ذلك يُرى
حبلها قصيراً تارة، وطويلاً أخرى، ضعيفاً مرة، قوياً أخرى.
ومن جملة المؤسطَرين في ثقافتنا العربية المعاصرة
إسماعيل أدهم (1911 ــ 1940): الذي تربّع على عرش ريادة الإلحاد العربي بعدما كتب، سنة 1937 أول رسالة تعلن الإلحاد بعنوان: (لماذا أنا ملحد)؟
إسماعيل أدهم (1911 ــ 1940): الذي تربّع على عرش ريادة الإلحاد العربي بعدما كتب، سنة 1937 أول رسالة تعلن الإلحاد بعنوان: (لماذا أنا ملحد)؟
انقسم يومها الأدباء
والمفكرون ما بين مؤيد له، ومتعاطف معه، ومدافع عن حقه في إبداء رأيه من أمثال
جميل صدقي الزهاوي، وإسماعيل مظهر، وحسين فوزي، وسامي الكيالي وسواهم، وما بين
معارض له، ومتجانف عنه مثل: محمد فريد وجدي، وعبد المتعال الصعيدي ومصطفى عبد
الرازق وفليكس فارس، واستمرّ هذان الخطان متواترين حتى لحظتنا الراهنة: فئة
تستعيده وتزدهي به، وفئة تستعيذ منه وتحتقره.
والمفكرون ما بين مؤيد له، ومتعاطف معه، ومدافع عن حقه في إبداء رأيه من أمثال
جميل صدقي الزهاوي، وإسماعيل مظهر، وحسين فوزي، وسامي الكيالي وسواهم، وما بين
معارض له، ومتجانف عنه مثل: محمد فريد وجدي، وعبد المتعال الصعيدي ومصطفى عبد
الرازق وفليكس فارس، واستمرّ هذان الخطان متواترين حتى لحظتنا الراهنة: فئة
تستعيده وتزدهي به، وفئة تستعيذ منه وتحتقره.
ردّ عليه أحمد زكي أبو شادي
بمقالة تحت عنوان: (لماذا أنا مؤمن؟)، وكتب محمد فريد وجدي (لماذ هو ملحد؟)،
وساجله الشيخ يوسف الدجوي بسلسلة مقالات تحت عنوان: (حدث جلل لا يمكن الصبر عليه).
بمقالة تحت عنوان: (لماذا أنا مؤمن؟)، وكتب محمد فريد وجدي (لماذ هو ملحد؟)،
وساجله الشيخ يوسف الدجوي بسلسلة مقالات تحت عنوان: (حدث جلل لا يمكن الصبر عليه).
ومن أجل أن نضع القارئ في
صورة موجزة عن حياته القصيرة التي لم تتجاوز التسعة والعشرين عاماً نورد ههنا ترجمة
الزركلي كاملة من كتابه (الأعلام):
صورة موجزة عن حياته القصيرة التي لم تتجاوز التسعة والعشرين عاماً نورد ههنا ترجمة
الزركلي كاملة من كتابه (الأعلام):
“إسماعيل بن أحمد بن
إسماعيل بن إبراهيم باشا: عارف بالرياضيات، له اشتغال بالتاريخ. شعوبي. تركي
الأصل. أمه ألمانية.
إسماعيل بن إبراهيم باشا: عارف بالرياضيات، له اشتغال بالتاريخ. شعوبي. تركي
الأصل. أمه ألمانية.
كان أبوه ضابطاً في الجيش،
وجده معلماً للغة التركية في جامعة برلين. وجدّ أبيه مدير ديوان المدارس المصرية
في عهد محمد علي.
وجده معلماً للغة التركية في جامعة برلين. وجدّ أبيه مدير ديوان المدارس المصرية
في عهد محمد علي.
ولد إسماعيل بالإسكندرية،
وتعلّم بها وبالآستانة، ثم أحرز (الدكتوراه) في العلوم من جامعة موسكو سنة 1931، وعُيّن
مدرّساً للرياضيات في جامعة سان بطرسبرج. وانتُخب عضواً أجنبياً في (أكاديمية)
العلوم السوفييتية، وعهدت إليه جامعة فريبورج بالإشراف على طبع كتاب المستشرق
(سبرنجر) عن حياة (محمد) عليه الصلاة والسلام.
وتعلّم بها وبالآستانة، ثم أحرز (الدكتوراه) في العلوم من جامعة موسكو سنة 1931، وعُيّن
مدرّساً للرياضيات في جامعة سان بطرسبرج. وانتُخب عضواً أجنبياً في (أكاديمية)
العلوم السوفييتية، وعهدت إليه جامعة فريبورج بالإشراف على طبع كتاب المستشرق
(سبرنجر) عن حياة (محمد) عليه الصلاة والسلام.
وانتُخب وكيلاً للمعهد
الروسي للدراسات الإسلامية، وانتقل إلى تركيا فكان مدرّساً للرياضيات في معهد
أتاتورك بأنقرة، وبها نشر كتابه (إسلام تاريخي) بالتركية، وعاد إلى مصر سنة 1936 فنشر رسالة
بالعربية (من مصادر التاريخ الإسلامي) صادرتها الحكومة، و[كتاب] (الزهاوي الشاعر)،
وكتاباً وضعه في (الإلحاد)، وكتب في مجلات مصر والشام مقالات بالعربية منها: (علم
الأنساب عند العرب)، و(نظرية النسبية)، و(خليل مطران الشاعر)، و(طه حسين: درس
وتحليل)، و(عبد الحق حامد) الشاعر التركي.
الروسي للدراسات الإسلامية، وانتقل إلى تركيا فكان مدرّساً للرياضيات في معهد
أتاتورك بأنقرة، وبها نشر كتابه (إسلام تاريخي) بالتركية، وعاد إلى مصر سنة 1936 فنشر رسالة
بالعربية (من مصادر التاريخ الإسلامي) صادرتها الحكومة، و[كتاب] (الزهاوي الشاعر)،
وكتاباً وضعه في (الإلحاد)، وكتب في مجلات مصر والشام مقالات بالعربية منها: (علم
الأنساب عند العرب)، و(نظرية النسبية)، و(خليل مطران الشاعر)، و(طه حسين: درس
وتحليل)، و(عبد الحق حامد) الشاعر التركي.
وكان يعيش من ريع ملك صغير
له في الإسكندرية، وأصيب بالسل فتعجّل الموت، فأغرق نفسه بالإسكندرية
منتحراً”.
له في الإسكندرية، وأصيب بالسل فتعجّل الموت، فأغرق نفسه بالإسكندرية
منتحراً”.
دُبجت بعد موته مقالات
تأبينية عديدة، وفتح سامي الكيالي صفحات مجلته الحلبية (الحديث) خيمة عزاء، وشبَّهوه
بسقراط، ومجدّته الشاعرة السورية وداد السكاكيني تمجيداً غير محدود، ثمّ انطوى ذكر
الرجل إلى سنة 1984 عندما بدأت دار
المعارف بطباعة مؤلفاته الكاملة في ثلاثة مجلدات: (أدباء معاصرون، شعراء معاصرون،
قضايا ومناقشات) بإشراف الدكتور أحمد إبراهيم الهواري، ومع انتشار النت وتشكّل
منتديات الملحدين والعقلانيين والعلمانيين العرب أُعيد اكتشافه، وتمّت أيقنته
وتشييخه شيخاً لا كالشيوخ، يليق به على الحقيقة لا المجاز أن نطلق عليه وصف عالم،
ويشهد لذلك مسرد مؤلفاته التي أثبتها في الصفحة الأخيرة من رسالته (لماذا أنا
ملحد):
تأبينية عديدة، وفتح سامي الكيالي صفحات مجلته الحلبية (الحديث) خيمة عزاء، وشبَّهوه
بسقراط، ومجدّته الشاعرة السورية وداد السكاكيني تمجيداً غير محدود، ثمّ انطوى ذكر
الرجل إلى سنة 1984 عندما بدأت دار
المعارف بطباعة مؤلفاته الكاملة في ثلاثة مجلدات: (أدباء معاصرون، شعراء معاصرون،
قضايا ومناقشات) بإشراف الدكتور أحمد إبراهيم الهواري، ومع انتشار النت وتشكّل
منتديات الملحدين والعقلانيين والعلمانيين العرب أُعيد اكتشافه، وتمّت أيقنته
وتشييخه شيخاً لا كالشيوخ، يليق به على الحقيقة لا المجاز أن نطلق عليه وصف عالم،
ويشهد لذلك مسرد مؤلفاته التي أثبتها في الصفحة الأخيرة من رسالته (لماذا أنا
ملحد):
ــ نظرية النسبية بالألمانية
والروسية في ثلاث مجلدات.
والروسية في ثلاث مجلدات.
ــ الرياضيات والفيزيقا
بالألمانية والروسية في مجلدين.
بالألمانية والروسية في مجلدين.
ــ حياة محمد ونقدات تاريخية
بالألمانية في مجلد.
بالألمانية في مجلد.
ــ تاريخ الإسلام بالتركية
في ثلاث مجلدات.
في ثلاث مجلدات.
ــ من مصادر التاريخ
الإسلامي بالعربية.
الإسلامي بالعربية.
ــ أبو شادي الشاعر
بالإنجليزية.
بالإنجليزية.
ــ الزهاوي الشاعر بالعربية.
ــ التوران في مجرى التاريخ
بالتركية.
بالتركية.
افتتن محبوه ومتبنوه بسيرته
وهو طفل، كأنّه وليٌ ذو كرامات، حين حدّث عن نفسه أنّه قرأ وهو في الثامنة من
العمر لمعظم كبار الأدباء الفرنسيين من أمثال: موليير، وبلزاك، وفيكتور هيغو،
وموباسان، والأديب التركي حسين رحمي، والشاعر التركي عبد الحق حامد.
وهو طفل، كأنّه وليٌ ذو كرامات، حين حدّث عن نفسه أنّه قرأ وهو في الثامنة من
العمر لمعظم كبار الأدباء الفرنسيين من أمثال: موليير، وبلزاك، وفيكتور هيغو،
وموباسان، والأديب التركي حسين رحمي، والشاعر التركي عبد الحق حامد.
وأتقن من سن الثامنة وحتى
الثالثة عشرة التركية والألمانية والعربية، وطالع في هذه الفترة كتابي (أصل
الأنواع) و(أصل الإنسان) لتشارلز داروين، وخرج منها مؤمناً بالتطور كافراً
بالغيبيات، مما دفعه في تلك الفترة، كما يحدثنا عن نفسه، لقراءة معظم أعمال
البيلوجي الإنجليزي الشهير توماس هنري هكسلي، والفيلسوف والعالم الألماني أرنست
هيكل، وفي الثالثة عشرة من عمره عكف على قراءة الكتب الفلسفية وعلى رأسها
(التأملات) لديكارت، و(رسالة في الطبيعة البشرية) لديفيد هيوم، و(التنين الجبار)
لتوماس هوبز، و(نقد العقل الخالص) لكانط، وكتابات باروخ إسبينوزا عن الدين الطبيعي
التي جعلته ينكر عقيدة الخلود والنبوة والمعجزات والجنة والنار، ودفعته للإيمان
بما دعاه بالأخلاق العقلية.
الثالثة عشرة التركية والألمانية والعربية، وطالع في هذه الفترة كتابي (أصل
الأنواع) و(أصل الإنسان) لتشارلز داروين، وخرج منها مؤمناً بالتطور كافراً
بالغيبيات، مما دفعه في تلك الفترة، كما يحدثنا عن نفسه، لقراءة معظم أعمال
البيلوجي الإنجليزي الشهير توماس هنري هكسلي، والفيلسوف والعالم الألماني أرنست
هيكل، وفي الثالثة عشرة من عمره عكف على قراءة الكتب الفلسفية وعلى رأسها
(التأملات) لديكارت، و(رسالة في الطبيعة البشرية) لديفيد هيوم، و(التنين الجبار)
لتوماس هوبز، و(نقد العقل الخالص) لكانط، وكتابات باروخ إسبينوزا عن الدين الطبيعي
التي جعلته ينكر عقيدة الخلود والنبوة والمعجزات والجنة والنار، ودفعته للإيمان
بما دعاه بالأخلاق العقلية.
ويقول عن نفسه أيضاً: “لقد فرغت من دراسة هندسة
أوقليدس وأنا ابن الثانية عشر، وقرأت لبوانكاره وكلاين ولوباجفسكي مؤلفاتهم وأنا
ابن الرابعة عشرة”.
أوقليدس وأنا ابن الثانية عشر، وقرأت لبوانكاره وكلاين ولوباجفسكي مؤلفاتهم وأنا
ابن الرابعة عشرة”.
ولن يكون لكرامات البداية من
غاية سوى النبوغ العزيز، والتفوق الهائل، يحدثنا أنّه غادر عام 1927 مصر إلى
إسطنبول ليتم دراسته الثانوية، فحصل عام 1931 على درجة البكالوريوس، ثم غادر في السنة نفسها إلى موسكو، ونال
درجة الدكتوراه في الرياضيات البحتة عام 1933، ودكتوراه ثانية في (ميكانيكا حركة الغازات وحسابات الاحتمال) عام
1934، وفي عام 1935 أصبح عضو
أكاديمية العلوم الروسية، ووكيل المعهد الروسي للدراسات الإسلامية، وأستاذ التاريخ
الإسلامي بجامعة الأستانة، وفي هذه الحقبة ألقى العديد من المحاضرات في الطبيعة
بجامعة فيينا وبرلين وميونخ وعمل أستاذاً للرياضيات في معهد أتاتورك في أنقرة،
ودعته كلية اللاهوت بجامعة فريبورغ السويسرية لمراجعة كتاب المستشرق سبرنجر عن
حياة محمد عليه الصلاة والسلام.
غاية سوى النبوغ العزيز، والتفوق الهائل، يحدثنا أنّه غادر عام 1927 مصر إلى
إسطنبول ليتم دراسته الثانوية، فحصل عام 1931 على درجة البكالوريوس، ثم غادر في السنة نفسها إلى موسكو، ونال
درجة الدكتوراه في الرياضيات البحتة عام 1933، ودكتوراه ثانية في (ميكانيكا حركة الغازات وحسابات الاحتمال) عام
1934، وفي عام 1935 أصبح عضو
أكاديمية العلوم الروسية، ووكيل المعهد الروسي للدراسات الإسلامية، وأستاذ التاريخ
الإسلامي بجامعة الأستانة، وفي هذه الحقبة ألقى العديد من المحاضرات في الطبيعة
بجامعة فيينا وبرلين وميونخ وعمل أستاذاً للرياضيات في معهد أتاتورك في أنقرة،
ودعته كلية اللاهوت بجامعة فريبورغ السويسرية لمراجعة كتاب المستشرق سبرنجر عن
حياة محمد عليه الصلاة والسلام.
كما مُنح الدكتوراه الفخرية
في الأدب والتاريخ الإسلامي والدراسات العربية من جامعة موسكو، وعمل كذلك أستاذاً
للرياضيات البحتة بجامعة سان بترسبرغ.
في الأدب والتاريخ الإسلامي والدراسات العربية من جامعة موسكو، وعمل كذلك أستاذاً
للرياضيات البحتة بجامعة سان بترسبرغ.
ويحدثنا عن نفسه كذلك أنّه
في عام 1936 عاد إلى مصر
موفداً من كلية الآداب التركية التابعة لجامعة الأستانة لدراسة الحياة الاجتماعية
والأدبية في البلدان العربية واختار الإسكندرية مقراً له.
في عام 1936 عاد إلى مصر
موفداً من كلية الآداب التركية التابعة لجامعة الأستانة لدراسة الحياة الاجتماعية
والأدبية في البلدان العربية واختار الإسكندرية مقراً له.
يقول عن دراسته للتاريخ
الإسلامي: “ولقد أكببتُ مدة من الزمن ليست باليسيرة على تاريخ الإسلام،
فدقّقتُ معظم المصادر العربية والتركية والفارسية مخطوطة ومطبوعة في دور الكتب
بمختلف أمصار أوروبا وآسيا وإفريقيا، وراجعت جلّ ما كتبه المستشرقون بالألمانية
والروسية والإيطالية والإنكليزية والفرنسية وطابقت ما ذهبوا إليه على مصادرها
الشرقية للتأكد من صحة ما ذهبوا إليه”.
الإسلامي: “ولقد أكببتُ مدة من الزمن ليست باليسيرة على تاريخ الإسلام،
فدقّقتُ معظم المصادر العربية والتركية والفارسية مخطوطة ومطبوعة في دور الكتب
بمختلف أمصار أوروبا وآسيا وإفريقيا، وراجعت جلّ ما كتبه المستشرقون بالألمانية
والروسية والإيطالية والإنكليزية والفرنسية وطابقت ما ذهبوا إليه على مصادرها
الشرقية للتأكد من صحة ما ذهبوا إليه”.
وقد نشر بعد هذه الدراسة سنة
1936 أولى رسائله
العربية (من مصادر التاريخ الإسلامي) تحدث فيها عن رواية الحديث الشريف: نشأتها
وحلقات تطورها حتى القرن الثالث الهجري، وقرر أنّ أكثر الأحاديث والأسانيد منحولة،
غير أنّ الأزهر وقف من هذه الرسالة موقفاً عدائياً، وطالب شيخ الأزهر المراغي
بمصادرتها، فانصرف عن نشر كتابه (حياة محمد ونشأة الإسلام) الذي وضعه بالتركية،
واكتفى بنشره في أوروبا.
1936 أولى رسائله
العربية (من مصادر التاريخ الإسلامي) تحدث فيها عن رواية الحديث الشريف: نشأتها
وحلقات تطورها حتى القرن الثالث الهجري، وقرر أنّ أكثر الأحاديث والأسانيد منحولة،
غير أنّ الأزهر وقف من هذه الرسالة موقفاً عدائياً، وطالب شيخ الأزهر المراغي
بمصادرتها، فانصرف عن نشر كتابه (حياة محمد ونشأة الإسلام) الذي وضعه بالتركية،
واكتفى بنشره في أوروبا.
هل هذه الصورة الحقيقية لإسماعيل أدهم؟ أم أنّ له
صورة أخرى مغايرة وصادمة لم يُكشف عنها بتفصيل في اللغة العربية حتى هذه اللحظة؟
صورة أخرى مغايرة وصادمة لم يُكشف عنها بتفصيل في اللغة العربية حتى هذه اللحظة؟
هذا ما سنورده في مقالنا التالي.
محمد أمير ناشر النعم