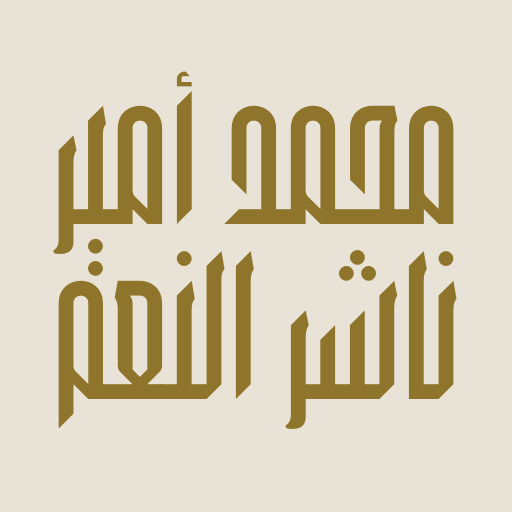وأقصد بالتبسيط هنا انتزاع صورة واحدة
من صوره المتعدِّدة والمركّبة، وتجميد تجلٍّ واحد من تجلياته الكثيرة، وتقديمهما
بوصفهما المحدِّد لهويته والشارح لبنيته، وتجاهل جميع الوجوه والصور والتجليات الأخرى،
وعدم الالتفات إليها، والدلالة عليها.
من صوره المتعدِّدة والمركّبة، وتجميد تجلٍّ واحد من تجلياته الكثيرة، وتقديمهما
بوصفهما المحدِّد لهويته والشارح لبنيته، وتجاهل جميع الوجوه والصور والتجليات الأخرى،
وعدم الالتفات إليها، والدلالة عليها.
يحدِّد توماس باور في كتابه (ثقافة
الالتباس: نحو تاريخ آخر للإسلام) أشكال التعدد الحضاري في الإسلام بما يلي:
الالتباس: نحو تاريخ آخر للإسلام) أشكال التعدد الحضاري في الإسلام بما يلي:
1 ــ قبول تعددية الخطاب.
2 ــ قبول تفسيرات مختلفة.
3 ــ النصوص والأفعال والأماكن متعددة
المعنى.
المعنى.
4 ــ انعكاس التعدد والتدرب على
التعدد.
التعدد.
والمطلع على دراسة باور سيدرك من أول
وهلة أنّه عالج هذه الأشكال واستفاض في شرحها والتدليل عليها من خلال التراث السنّي،
وهذا ما يضعنا وجهاً لوجه أمام جريرة انتزاع صورة واحدة من هذا التراث، وتقديمها
ممثلاً له وناطقاً باسمه وملخّصاً لوجوده!
وهلة أنّه عالج هذه الأشكال واستفاض في شرحها والتدليل عليها من خلال التراث السنّي،
وهذا ما يضعنا وجهاً لوجه أمام جريرة انتزاع صورة واحدة من هذا التراث، وتقديمها
ممثلاً له وناطقاً باسمه وملخّصاً لوجوده!
وكيلا نبقى في مضمار الكلام العام
والمطلق سنعالج مسألة تُقدَّم عنواناً من عناوين الإسلام السنّي ونبيّن ما فيها من
استهتار! ألا وهي مسألة (الخروج على الحاكم)، من خلال كتابين تراثيين يحملان الاسم
نفسه، ويقفان على طرفي النقيض من المسألة التي نحن بصددها. وهذا من غرائب
الاتفاقات التي تقتضي منّا عدم التسرّع في عنونة مذهب ما بعنوان معين قائم على
إطلاق الأوصاف والأحكام بتبسيط واختزال وتنميط!
والمطلق سنعالج مسألة تُقدَّم عنواناً من عناوين الإسلام السنّي ونبيّن ما فيها من
استهتار! ألا وهي مسألة (الخروج على الحاكم)، من خلال كتابين تراثيين يحملان الاسم
نفسه، ويقفان على طرفي النقيض من المسألة التي نحن بصددها. وهذا من غرائب
الاتفاقات التي تقتضي منّا عدم التسرّع في عنونة مذهب ما بعنوان معين قائم على
إطلاق الأوصاف والأحكام بتبسيط واختزال وتنميط!
كتابان يحملان العنوان نفسه، ويدافعان
عن فكرتين متقابلتين بل متناقضتين:
عن فكرتين متقابلتين بل متناقضتين:
الأولى: تمنع الخروج على الحاكم، وتعدُّ كلّ خارج عليه باغياً
ومفتئتاً، وتجدُّ وتجتهد في تجميل الحاكم وتسويغ جرائمه ولو وصلت إلى عنان السماء،
وتتذرع لذلك بالنصوص وأقوال الفقهاء، ونقد الروايات التاريخية التي تذكر الحكام
بما يشين ويقبح.
ومفتئتاً، وتجدُّ وتجتهد في تجميل الحاكم وتسويغ جرائمه ولو وصلت إلى عنان السماء،
وتتذرع لذلك بالنصوص وأقوال الفقهاء، ونقد الروايات التاريخية التي تذكر الحكام
بما يشين ويقبح.
والثانية: لا ترى بأساً بهذا الخروج، وتستدعي أيضاً النصوص
وأقوال الفقهاء ومواقفهم، ولا تأنف من ذكر عورات الحاكم وسلقه بما فيه من أوصاف
وأفعال.
وأقوال الفقهاء ومواقفهم، ولا تأنف من ذكر عورات الحاكم وسلقه بما فيه من أوصاف
وأفعال.
اسم الكتاب الأول (العواصم من
القواصم) لأبي بكر ابن العربي (468 ــ 543) هــ.
القواصم) لأبي بكر ابن العربي (468 ــ 543) هــ.
واسم الكتاب الثاني (العواصم
والقواصم) لابن الوزير اليمني (775 ــ 840) هــ.
والقواصم) لابن الوزير اليمني (775 ــ 840) هــ.
والمقصود بـ (القواصم) في هذا العنوان
الافتراءات والأكاذيب والمطاعن والشكوك التي يوجهها مناوئو المذهب السني إليه،
وبــ (العواصم) الردود والدفوع والمعالجات التي تعصم من هذه الافتراءات القاصمة
المدمّرة، فتكشف زيفها وتجعلها هباءً.
الافتراءات والأكاذيب والمطاعن والشكوك التي يوجهها مناوئو المذهب السني إليه،
وبــ (العواصم) الردود والدفوع والمعالجات التي تعصم من هذه الافتراءات القاصمة
المدمّرة، فتكشف زيفها وتجعلها هباءً.
يتضمّن كتاب ابن الوزير جميع (القواصم)
الواردة في كتاب ابن عربي، ويزيد عليها قواصم أخرى تتعلق بالشُّبهات والمطاعن التي
ترد على أئمة الحديث، وفقهاء السنة، ومقولات الكلام الأساسية للمذهب الأشعري إلخ،
ولكنّ تختلف معالجة (العواصم) بين الكتابين اختلافاً جذرياً. وأخمّن أنّ ابن الوزير
تعمد أن يسمي كتابه اسماً مشابهاً لكتاب ابن العربي من أجل أن يتيح المقارنة بين
معالجتين مختلفتين إلى حدّ التناقض في الدفاع عن الموقف السنّي، والرؤية السنيّة.
الواردة في كتاب ابن عربي، ويزيد عليها قواصم أخرى تتعلق بالشُّبهات والمطاعن التي
ترد على أئمة الحديث، وفقهاء السنة، ومقولات الكلام الأساسية للمذهب الأشعري إلخ،
ولكنّ تختلف معالجة (العواصم) بين الكتابين اختلافاً جذرياً. وأخمّن أنّ ابن الوزير
تعمد أن يسمي كتابه اسماً مشابهاً لكتاب ابن العربي من أجل أن يتيح المقارنة بين
معالجتين مختلفتين إلى حدّ التناقض في الدفاع عن الموقف السنّي، والرؤية السنيّة.
يناقش ابن العربي في كتابه ما شجر بين
الصحابة فيذكر المآخذ على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويتحدث عن خروج
طلحة والزبير والسيدة عائشة إلى البصرة، وحرب الجمل، ويتناول قتال الإمام علي
ومعاوية، وقصة التحكيم، وبيعة الحسن وصلحه مع معاوية، ومقتل الحسين في أيام يزيد.
الصحابة فيذكر المآخذ على الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويتحدث عن خروج
طلحة والزبير والسيدة عائشة إلى البصرة، وحرب الجمل، ويتناول قتال الإمام علي
ومعاوية، وقصة التحكيم، وبيعة الحسن وصلحه مع معاوية، ومقتل الحسين في أيام يزيد.
تقوم معالجة ابن العربي المالكي على
إستراتيجيات محدّدة تلخّصها كلمات (التسويغ) و(المكابرة) و(الإنكار) و(التجميل)
و(النكاية)، وبكامل الجرأة والقحة يقول: “وما وقع من روايات في كتب التاريخ
ــ عدا ما ذكرنا ــ فلا تلتفتوا إلى حرف منها فإنّها كلها باطلة”، فهو فقط
مصدر الخبر الموثوق، ومنبع السردية الحقّة.
إستراتيجيات محدّدة تلخّصها كلمات (التسويغ) و(المكابرة) و(الإنكار) و(التجميل)
و(النكاية)، وبكامل الجرأة والقحة يقول: “وما وقع من روايات في كتب التاريخ
ــ عدا ما ذكرنا ــ فلا تلتفتوا إلى حرف منها فإنّها كلها باطلة”، فهو فقط
مصدر الخبر الموثوق، ومنبع السردية الحقّة.
يُعدّد مآخذ الثوار على الخليفة الثالث
عثمان بن عفان، رضي الله عنه، ثمّ يُفنّدها ويقول إنّها إما مكذوبة عليه، وإما لم
تفهم على وجهها الصحيح، وفي أثناء ذلك يجمّل مروان بن الحكم، ويعدّه “رجلاً
عدلاً من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين”، ويناقش مسألة
أخذه خمس غنائم إفريقيا، فيكذّبها ويقول إنّها لا تصح، ثم يعود ويسوّغها، على فرض
صحتها، فيقول: “قد ذهب مالك وجماعة إلى أنّ الإمام يرى رأيه في الخمس، وينفذ
فيه ما أدّاه إليه اجتهاده، وأنَّ إعطاءه لواحد جائز”. ويجمّل كذلك الوليد بن
عقبة، ويرى أنّ حدّه في الخمر لا يعيبه ولا يقدح في عدالته، فــ “ليست الذنوب
مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة”، ويسلّم بخروج أصحاب الجمل إلى البصرة،
ولكنّه لا يعلم لماذا خرجوا؟ لأنّه “لم يصح فيه نقل، ولا يوثق فيه بأحد، لأنّ
الثقة لم ينقله، وكلام المتعصب غير مقبول، وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في
الإسلام واستنقاص الصحابة”.
عثمان بن عفان، رضي الله عنه، ثمّ يُفنّدها ويقول إنّها إما مكذوبة عليه، وإما لم
تفهم على وجهها الصحيح، وفي أثناء ذلك يجمّل مروان بن الحكم، ويعدّه “رجلاً
عدلاً من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين”، ويناقش مسألة
أخذه خمس غنائم إفريقيا، فيكذّبها ويقول إنّها لا تصح، ثم يعود ويسوّغها، على فرض
صحتها، فيقول: “قد ذهب مالك وجماعة إلى أنّ الإمام يرى رأيه في الخمس، وينفذ
فيه ما أدّاه إليه اجتهاده، وأنَّ إعطاءه لواحد جائز”. ويجمّل كذلك الوليد بن
عقبة، ويرى أنّ حدّه في الخمر لا يعيبه ولا يقدح في عدالته، فــ “ليست الذنوب
مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة”، ويسلّم بخروج أصحاب الجمل إلى البصرة،
ولكنّه لا يعلم لماذا خرجوا؟ لأنّه “لم يصح فيه نقل، ولا يوثق فيه بأحد، لأنّ
الثقة لم ينقله، وكلام المتعصب غير مقبول، وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في
الإسلام واستنقاص الصحابة”.
وفي قتال علي ومعاوية يرى أنّهما معاً
على حق، ولكنّ طائفة علي أدنى إلى الحق، لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا عن
الخوارج فقال: “تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق”، ويعلّق على هذا الحديث
فيقول: “فبيّن أنّ كل طائفة منهما تتعلق بالحق، لكن طائفة علي أدنى
إليه”.
على حق، ولكنّ طائفة علي أدنى إلى الحق، لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا عن
الخوارج فقال: “تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق”، ويعلّق على هذا الحديث
فيقول: “فبيّن أنّ كل طائفة منهما تتعلق بالحق، لكن طائفة علي أدنى
إليه”.
وفي قصة التحكيم يكذّب خبر التحكيم،
ويحدّثنا بعد ذلك عن مزايا معاوية وسيرته الممتازة، وأهلية يزيد للولاية، فيستشهد
بتسليم ابن عمر، رضي الله عنهما، لإمرة يزيد، ويذكر أنّ الفقيه الليث بن سعد سمّى
يزيد (أمير المؤمنين). وأخيراً يقول تلك الكلمة التي سارت بها الركبان وتداولتها
الألسنة والأقلام: (إنّ الحسين قُتل بشرع جده)! في تأكيد منّه على منع الخروج على
الحاكم، ولو بلغ في العسف والظلم مبلغ يزيد بن معاوية.
ويحدّثنا بعد ذلك عن مزايا معاوية وسيرته الممتازة، وأهلية يزيد للولاية، فيستشهد
بتسليم ابن عمر، رضي الله عنهما، لإمرة يزيد، ويذكر أنّ الفقيه الليث بن سعد سمّى
يزيد (أمير المؤمنين). وأخيراً يقول تلك الكلمة التي سارت بها الركبان وتداولتها
الألسنة والأقلام: (إنّ الحسين قُتل بشرع جده)! في تأكيد منّه على منع الخروج على
الحاكم، ولو بلغ في العسف والظلم مبلغ يزيد بن معاوية.
وسوف نرى أن طائفة معتداً بها في
المذهب السني ستكرِّر هذا المعنى وتؤكده وتضعه في إطار نظرية الأحكام السلطانية،
ولن نطيل ههنا بذكر أسمائهم وسرد أقوالهم لئلا نخرج عن حدّ المقال ومجاله.
المذهب السني ستكرِّر هذا المعنى وتؤكده وتضعه في إطار نظرية الأحكام السلطانية،
ولن نطيل ههنا بذكر أسمائهم وسرد أقوالهم لئلا نخرج عن حدّ المقال ومجاله.
لكنّنا سنقع في نفس المجال والدائرة
على نوع آخر من المعالجة قدمّها لنا العلامة المجتهد المطلق ابن الوزير اليمني في
كتابه (العواصم والقواصم) المطبوع في تسعة مجلدات، والذي اختصره فيما بعد في مجلد
واحد بعنوان: (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم).
على نوع آخر من المعالجة قدمّها لنا العلامة المجتهد المطلق ابن الوزير اليمني في
كتابه (العواصم والقواصم) المطبوع في تسعة مجلدات، والذي اختصره فيما بعد في مجلد
واحد بعنوان: (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم).
نشأ محمد بن إبراهيم الوزير في اليمن
في بيئة زيدية، وتدرّج في مراتب العلم، وكان من المؤمَّل أن يغدو من كبار مجتهدي
الزيدية، ولكنّه حين بلغ مرتبة الاجتهاد أعلن انتماءه لمدرسة أهل الحديث السنّية،
فصدم محيطه وأساتذته ومعارفه، وكتب أحد أهم أساتذته وهو جمال الدين علي بن محمد
(ت: 873 هــ) رسالةً
“محبّرة مشتملة على الزواجر والعظات والتنبيه بالكلم الموقظات زعم صاحبها
أنّه من الناصحين المحبين، وأنّه أدى به ما عليه من حق الأقربين”.
في بيئة زيدية، وتدرّج في مراتب العلم، وكان من المؤمَّل أن يغدو من كبار مجتهدي
الزيدية، ولكنّه حين بلغ مرتبة الاجتهاد أعلن انتماءه لمدرسة أهل الحديث السنّية،
فصدم محيطه وأساتذته ومعارفه، وكتب أحد أهم أساتذته وهو جمال الدين علي بن محمد
(ت: 873 هــ) رسالةً
“محبّرة مشتملة على الزواجر والعظات والتنبيه بالكلم الموقظات زعم صاحبها
أنّه من الناصحين المحبين، وأنّه أدى به ما عليه من حق الأقربين”.
أراد هذا الأستاذ أن يبيّن لتلميذه بالأمس
وقرينه اليوم مكامن الخطل في المذهب السنّي، والمطاعن التي تدفع المرء لتحاشي هذا
المذهب في نصٍّ قصير محكم لا يتجاوز عدة صفحات، فردّ عليه الإمام ابن الوزير بكتاب
تجاوز الأربعة آلاف صفحة، ليكشف عن اطلاع وتدقيق قلّ نظيره في التراث الإسلامي،
وفي ذلك يقول: “فربما أوردت عليه في بعض المسائل أكثر من مئتي إشكال على مقدار
نصف ورقة من كتابه”.
وقرينه اليوم مكامن الخطل في المذهب السنّي، والمطاعن التي تدفع المرء لتحاشي هذا
المذهب في نصٍّ قصير محكم لا يتجاوز عدة صفحات، فردّ عليه الإمام ابن الوزير بكتاب
تجاوز الأربعة آلاف صفحة، ليكشف عن اطلاع وتدقيق قلّ نظيره في التراث الإسلامي،
وفي ذلك يقول: “فربما أوردت عليه في بعض المسائل أكثر من مئتي إشكال على مقدار
نصف ورقة من كتابه”.
ومن جملة المطاعن التي يوردها السيد الأستاذ
على فقهاء أهل السنة أنّهم يجيزون إمامة الجائر، ويحرّمون الخروج عليه! وهنا ينبري
الإمام المجتهد ابن الوزير في المجلد الثامن ليبيّن قصور هذه النظرة، وعدم إحاطتها
بعوالم فقهاء أهل السنة واتجاهاتهم، ويدلّل على كلّ كلمة من كلماته بسرد أقوال
الفقهاء ووقائع التاريخ التي تؤيد ما يحكيه ويقرره:
على فقهاء أهل السنة أنّهم يجيزون إمامة الجائر، ويحرّمون الخروج عليه! وهنا ينبري
الإمام المجتهد ابن الوزير في المجلد الثامن ليبيّن قصور هذه النظرة، وعدم إحاطتها
بعوالم فقهاء أهل السنة واتجاهاتهم، ويدلّل على كلّ كلمة من كلماته بسرد أقوال
الفقهاء ووقائع التاريخ التي تؤيد ما يحكيه ويقرره:
1 ــ فالفقهاء لا يقولون إنّ الخارج
على إمام الجور باغٍ ولا آثم.
على إمام الجور باغٍ ولا آثم.
2 ــ إنّ منع الخروج على الظلمة استُثني
منه مَنْ فحش ظلمه وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد والحجّاج، ويقدّم ههنا أعظم
شهادة لأهل السنة على البراءة من تصويب يزيد، ويسرد أقوال أئمتهم في هذه البراءة،
حتى المشهورين بالتعصب للأمويين كالإمام ابن حزم.
منه مَنْ فحش ظلمه وعظمت المفسدة بولايته، مثل: يزيد والحجّاج، ويقدّم ههنا أعظم
شهادة لأهل السنة على البراءة من تصويب يزيد، ويسرد أقوال أئمتهم في هذه البراءة،
حتى المشهورين بالتعصب للأمويين كالإمام ابن حزم.
3 ــ يؤكّد أنّ الفقهاء من أهل السنة
لم يخالفوا فقهاء الزيدية في شرائط الإمامة التي زعم المعترض والناقد السيد جمال
الدين أنّهم خالفوا فيها.
لم يخالفوا فقهاء الزيدية في شرائط الإمامة التي زعم المعترض والناقد السيد جمال
الدين أنّهم خالفوا فيها.
4 ــ يدلِّل على أنّ الفقهاء من أهل
السنة وإن قالوا بصحة أخذ الولاية في المصالح من أئمة الجور فإنّهم لم يجعلوهم مثل
أئمة العدل مطلقاً في جميع الأمور.
السنة وإن قالوا بصحة أخذ الولاية في المصالح من أئمة الجور فإنّهم لم يجعلوهم مثل
أئمة العدل مطلقاً في جميع الأمور.
5 ــ يثبت أنّه من الخطأ الجسيم الظنّ
بأنّ الفقهاء يصوِّبون أئمة الجور في قتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس.
بأنّ الفقهاء يصوِّبون أئمة الجور في قتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس.
ضمن هذه المعطيات يعيد صياغة (العواصم)
التي تدفع عن المذهب السني تهم التناقض، وعدم الاتساق، وضبابية الرؤية الأخلاقية،
بمعالجات تحاول النأي بنفسها عن إستراتيجيات ابن العربي في (عواصمه) وردوده، وهكذا
سنراه يعالج الوقائع والأحداث والشخصيات معالجة هي على النقيض من معالجة ابن
العربي، فلن يجمّل شخصية تحوم حولها إشارات الاستفهام، ولن يسوّغ لها، وسيكشف لنا
أنّ هذا الموقف هو موقف سني أصيل له أنصاره وممثلوه، وفي هذا الإطار سيعيد تقييم
الشخصيات نفسها التي تناولها ابن العربي بطريقة مختلفة ومغايرة، كمروان بن الحكم،
والوليد بن عقبة، ويزيد بن معاوية.
التي تدفع عن المذهب السني تهم التناقض، وعدم الاتساق، وضبابية الرؤية الأخلاقية،
بمعالجات تحاول النأي بنفسها عن إستراتيجيات ابن العربي في (عواصمه) وردوده، وهكذا
سنراه يعالج الوقائع والأحداث والشخصيات معالجة هي على النقيض من معالجة ابن
العربي، فلن يجمّل شخصية تحوم حولها إشارات الاستفهام، ولن يسوّغ لها، وسيكشف لنا
أنّ هذا الموقف هو موقف سني أصيل له أنصاره وممثلوه، وفي هذا الإطار سيعيد تقييم
الشخصيات نفسها التي تناولها ابن العربي بطريقة مختلفة ومغايرة، كمروان بن الحكم،
والوليد بن عقبة، ويزيد بن معاوية.
إنّ هذين الكتابين المتوافقين في
الاسم، المختلفين في المعالجة والموقف يضعاننا أمام كمية الحيف الهائلة عندما
ننساق اليوم في مجرى التبسيط والتنميط، فنقول بكلّ استخفاف: إنّ المذهب السني يقول
كذا، أو إنّ أهل السنة يقرِّرون كذا.
الاسم، المختلفين في المعالجة والموقف يضعاننا أمام كمية الحيف الهائلة عندما
ننساق اليوم في مجرى التبسيط والتنميط، فنقول بكلّ استخفاف: إنّ المذهب السني يقول
كذا، أو إنّ أهل السنة يقرِّرون كذا.
إنّ تبسيط الإسلام السني وتنميطه اليوم
يستند إلى هوس معاصر في استخلاص سمات الفِرق والمذاهب بل والعقول: (العقل العربي)،
و(العقل الإسلامي)، و(العقل السني) إلخ، وتقديم هذه السمات في قوالب تأسر هذه
الفرق والمذاهب، وتسجنها في مقولات معيّنة، وعناوين جاهزة تغدو المحدِّد والمعرِّف
والراسم، وتقضي على كلّ أشكال التعدد والتنوع، وهذا في حدِّ ذاته، وفق شرح زيجموند
باومان، أحد أهمّ تناقضات الحداثة التي تعلي من شأن التعدّد وتنوع المعنى، ثم لا
تألو جهداً في الحدّ منهما والقضاء عليهما.
يستند إلى هوس معاصر في استخلاص سمات الفِرق والمذاهب بل والعقول: (العقل العربي)،
و(العقل الإسلامي)، و(العقل السني) إلخ، وتقديم هذه السمات في قوالب تأسر هذه
الفرق والمذاهب، وتسجنها في مقولات معيّنة، وعناوين جاهزة تغدو المحدِّد والمعرِّف
والراسم، وتقضي على كلّ أشكال التعدد والتنوع، وهذا في حدِّ ذاته، وفق شرح زيجموند
باومان، أحد أهمّ تناقضات الحداثة التي تعلي من شأن التعدّد وتنوع المعنى، ثم لا
تألو جهداً في الحدّ منهما والقضاء عليهما.
محمد أمير ناشر النعم
المصدر:
https://www.syria.tv/content/تبسيط-الإسلام-السني-وتنميطه