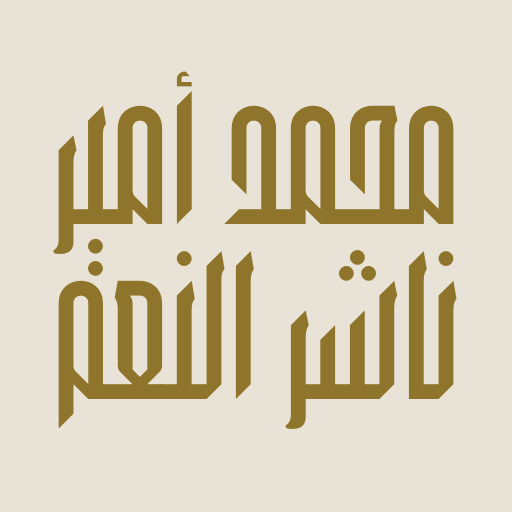يقول
يقولغابرييل غارثيا ماركيز: “لا يخفى على أحدٍ كم كان من الممكن أن تكون ذاكرة
الأطفال خطرة إذا أرادوا أن يتذكروا”.
هل
كان يقصد أنّ ذاكرة الأطفال خطرة على الشخص نفسه؟ أم عائلته؟ أم جيرانه؟ أم
أقربائه؟ أم أنه قصد أنها ستكون خطرة على الشعب نفسه؟ أم الوطن؟ أم على الديكتاتور
حين يحكم الوطن بالمذربَّة، والشعب بالمقرعة.
كان يقصد أنّ ذاكرة الأطفال خطرة على الشخص نفسه؟ أم عائلته؟ أم جيرانه؟ أم
أقربائه؟ أم أنه قصد أنها ستكون خطرة على الشعب نفسه؟ أم الوطن؟ أم على الديكتاتور
حين يحكم الوطن بالمذربَّة، والشعب بالمقرعة.
في
سنة 1982. سأغدو في الصف السادس الابتدائي، وسأدعوه فيما بعد بــ (عام
السَّوق إلى المسيرات). مسيرات التأييد لقائد المسيرة، المسيرة التي لم نكن نعرف
هدفها ولا غايتها، ومسيرات الولاء للقائد الرمز، الرمز الذي لم نكن ندرك جميع
أبعاده في سني عمرنا الأولى.
سنة 1982. سأغدو في الصف السادس الابتدائي، وسأدعوه فيما بعد بــ (عام
السَّوق إلى المسيرات). مسيرات التأييد لقائد المسيرة، المسيرة التي لم نكن نعرف
هدفها ولا غايتها، ومسيرات الولاء للقائد الرمز، الرمز الذي لم نكن ندرك جميع
أبعاده في سني عمرنا الأولى.
قبل
يوم من كل مسيرة كان الأساتذة والموجه والمدير الواحد تلو الآخر يذكروننا بضرورة
المجيء في اليوم التالي: غداً مسيرة. غداً مسيرة! يا ويل من يغيب.
يوم من كل مسيرة كان الأساتذة والموجه والمدير الواحد تلو الآخر يذكروننا بضرورة
المجيء في اليوم التالي: غداً مسيرة. غداً مسيرة! يا ويل من يغيب.
كانت
وجوهنا الصغيرة، وعيوننا الصغيرة، وأفواهنا الصغيرة، وأنوفنا الصغيرة، وأدمغتنا
الصغيرة تميّز تماماً بين الأستاذ الذي يقول لنا: الويل لمن يغيب، شفقةً علينا،
وقلبه علينا، وعاطفته معنا، لأنه هو نفسه يهدِّد نفسه ويقوِّمها لئلا يخطو خطوة
واحدة تستفزّ الغضب الحزبي، أو تستنفر الحنق الأمني، هذا الغضب الذي يقذف بالمرء
في غياهب المجهول، أو يمحوه من صفحة الوجود ، وبين الأستاذ الذي كان يهدِّدنا
بالويل إن غبنا، وملامحه وقسماته تخبرنا أنَّه ينظر إلينا بوصفنا أعداء مستقبليين
محتملين، لأنَّه من بين أهلنا وأقربائنا ومعارفنا ينبثق أعداء الثورة. أعداء
الحزب. أعداء الطائفة، وهذا، بحدِّ ذاته، احتمال قوي لننبثق نحن أيضاً في قادم
الأيام أعداءً ومناوئين.
وجوهنا الصغيرة، وعيوننا الصغيرة، وأفواهنا الصغيرة، وأنوفنا الصغيرة، وأدمغتنا
الصغيرة تميّز تماماً بين الأستاذ الذي يقول لنا: الويل لمن يغيب، شفقةً علينا،
وقلبه علينا، وعاطفته معنا، لأنه هو نفسه يهدِّد نفسه ويقوِّمها لئلا يخطو خطوة
واحدة تستفزّ الغضب الحزبي، أو تستنفر الحنق الأمني، هذا الغضب الذي يقذف بالمرء
في غياهب المجهول، أو يمحوه من صفحة الوجود ، وبين الأستاذ الذي كان يهدِّدنا
بالويل إن غبنا، وملامحه وقسماته تخبرنا أنَّه ينظر إلينا بوصفنا أعداء مستقبليين
محتملين، لأنَّه من بين أهلنا وأقربائنا ومعارفنا ينبثق أعداء الثورة. أعداء
الحزب. أعداء الطائفة، وهذا، بحدِّ ذاته، احتمال قوي لننبثق نحن أيضاً في قادم
الأيام أعداءً ومناوئين.
قبل
يوم من كل مسيرة كان الأساتذة والموجه والمدير الواحد تلو الآخر يذكروننا بضرورة
المجيء في اليوم التالي: غداً مسيرة. غداً مسيرة! يا ويل من يغيب.
يوم من كل مسيرة كان الأساتذة والموجه والمدير الواحد تلو الآخر يذكروننا بضرورة
المجيء في اليوم التالي: غداً مسيرة. غداً مسيرة! يا ويل من يغيب.
كان
وعينا المتبرعم الذي يتفتّح في تلك الأيام يُسقى في كل مكان بماء واحد هو الخوف
والتخويف، في البيت، والحي، والشارع، والمدرسة، والقبو، والسطح. القريب والصديق
يخوِّفانك لأنهما يخافان عليك، والبعيد والعدو يخوِّفانك لأنهما يخافان منك.
وعينا المتبرعم الذي يتفتّح في تلك الأيام يُسقى في كل مكان بماء واحد هو الخوف
والتخويف، في البيت، والحي، والشارع، والمدرسة، والقبو، والسطح. القريب والصديق
يخوِّفانك لأنهما يخافان عليك، والبعيد والعدو يخوِّفانك لأنهما يخافان منك.
 وكنّا
وكنّانأتي في اليوم التالي، في منشطنا ومكرهنا، للمشاركة في المسيرة بمناسبة عيد
استيلاء الحزب على السلطة في 8/ آذار، أو مناسبة عيد المولد، مولد الحزب
في 7/ نيسان، أو مناسبة عيد الجلاء في 17/ نيسان، أو مناسبة عيد العمال
في 1/ أيار، أو مناسبة عيد الشهداء في 6/ أيار، أو مناسبة عيد الانتصار
في حرب تشرين التحرير في 6 /تشرين الأول، أو مناسبة عيد استيلاء قائد
المسيرة على مقاليد البلاد والعباد في 16/ تشرين الثاني.
في
البرد القارس، كانت أكفُّنا تُصطَلَم، وفي الحرّ اللاهب كانت أقدامنا تُشوى، وفي
كلا الطقسين كانت أجسادنا تُنهك، وكانت المسافة التي نقطعها إلى ساحة سعد الله
الجابري لا تتجاوز ستة كيلو مترات، لكنها كانت تبدو لنا، في تلك السنّ الصغيرة،
أكثر من ستين كيلو مترا! مسافة لا نهائية، فكلما مشينا إلى قصدنا طالت بنا الطريق،
ورحب الأمد والمدى. بعض المسيرات كانت تنتهي في منتصف الطريق في
ملاعب 7 نيسان. كان ملعباً واحداً، ولكنه كان يُسمى ملاعب، وكانت هذه
المسيرة عندئذٍ أكثر تعباً وإرهاقاً، لأننا سنُحشر في مدرجات الملعب، وسنجلس على المدرَّج
الحجري عدة ساعات قبل أن تبدأ مباراة كرة القدم بين فريقين لا على التعيين، وسط
ضوضاء كونية من مكبرات الصوت التي تقذفنا بموسيقا وأغان لا تستطيع تمييز نغماتها
ولا كلماتها من هول صخبها، ويصحبها عصف الطبول والدربكات التي يحملها أربابها
فيقرعونها بلا كلل ولا ملل.
البرد القارس، كانت أكفُّنا تُصطَلَم، وفي الحرّ اللاهب كانت أقدامنا تُشوى، وفي
كلا الطقسين كانت أجسادنا تُنهك، وكانت المسافة التي نقطعها إلى ساحة سعد الله
الجابري لا تتجاوز ستة كيلو مترات، لكنها كانت تبدو لنا، في تلك السنّ الصغيرة،
أكثر من ستين كيلو مترا! مسافة لا نهائية، فكلما مشينا إلى قصدنا طالت بنا الطريق،
ورحب الأمد والمدى. بعض المسيرات كانت تنتهي في منتصف الطريق في
ملاعب 7 نيسان. كان ملعباً واحداً، ولكنه كان يُسمى ملاعب، وكانت هذه
المسيرة عندئذٍ أكثر تعباً وإرهاقاً، لأننا سنُحشر في مدرجات الملعب، وسنجلس على المدرَّج
الحجري عدة ساعات قبل أن تبدأ مباراة كرة القدم بين فريقين لا على التعيين، وسط
ضوضاء كونية من مكبرات الصوت التي تقذفنا بموسيقا وأغان لا تستطيع تمييز نغماتها
ولا كلماتها من هول صخبها، ويصحبها عصف الطبول والدربكات التي يحملها أربابها
فيقرعونها بلا كلل ولا ملل.
في
البرد القارس، كانت أكفُّنا تُصطَلَم، وفي الحرّ اللاهب كانت أقدامنا تُشوى، وفي
كلا الطقسين كانت أجسادنا تُنهك قبل المسيرة كانت توزَّع علينا الصور
واللافتات والأعلام، وفي تلك السنّ بالضبط ميزت بين علم الوطن وعلم الحزب، من
خلال حادثة جرت لأحد أقربائنا الشباب من العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية الذي
جاءنا متخشِّعاً، وحدّث أمي هامساً عن هواجسه المتزايدة في أنَّه سيُعتقل، فقد
نادى المنادي في الورشة التي يشتغل فيها بأن تجمّعوا أمام الشاحنة من أجل الذهاب
إلى المسيرة. وأمام الشاحنة وُضعت على الطاولة الحديدية الصور والأعلام واللافتات،
وكان على كل عامل وموظف أن يحمل قطعة من هذه القطع. اختار قريبي أن يحمل علماً،
فتناوله ومشى خطوتين، ثم عنّ على باله أن يفتحه، فوجده علم الحزب، وكان يظنُّه علم
الوطن، فرفع ببصره إلى السماء وراح يصفِّر، وهو يلف العلم، ثم أعاده إلى الطاولة،
وأخذ علماً آخر من أعلام الوطن، وفي هذه اللحظة التي ظنّ فيها أنه يقوم بحركته من
دون أن ينتبه إليه أحد، وجد عينين رماديتين مزروعتين في وجهٍ كحليٍّ، أو أقرب إلى
الكحلي ترمقانه من وراء نظارة، وتعلوهما قبعة فرو روسية من تلك القبَّعات التي
كنَّا نشتريها من سوق الألبسة المستعملة. كانوا يعرفون أنَّ قريبي شيوعي، وها قد
أتاهم الدليل مهرولاً بأنَّه عدوٌّ للحزب، وأنَّه رفض أن يحمل علمه، وفضَّل عليه
علم الوطن! ومن أجل ذلك استكنَّ الرعب بين ضلوع هذا الشاب المبتئس، وباتت الهواجس
تتمشَّى في عقله، بل في عظامه، وظلَّ يعيش لأكثر من سنة، وهو تحت ضغط الاعتقاد
أنَّه قاب قوسين أو أدنى من الاعتقال، لعلمه علم اليقين أنّ هذا الحزب لا يغفر ولا
يتسامح، ولا يميّز بين الصغائر والكبائر، وأنَّه يحاسب على احتمال القصد والنيَّة
كأنهما التوخي والعمد.
البرد القارس، كانت أكفُّنا تُصطَلَم، وفي الحرّ اللاهب كانت أقدامنا تُشوى، وفي
كلا الطقسين كانت أجسادنا تُنهك قبل المسيرة كانت توزَّع علينا الصور
واللافتات والأعلام، وفي تلك السنّ بالضبط ميزت بين علم الوطن وعلم الحزب، من
خلال حادثة جرت لأحد أقربائنا الشباب من العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية الذي
جاءنا متخشِّعاً، وحدّث أمي هامساً عن هواجسه المتزايدة في أنَّه سيُعتقل، فقد
نادى المنادي في الورشة التي يشتغل فيها بأن تجمّعوا أمام الشاحنة من أجل الذهاب
إلى المسيرة. وأمام الشاحنة وُضعت على الطاولة الحديدية الصور والأعلام واللافتات،
وكان على كل عامل وموظف أن يحمل قطعة من هذه القطع. اختار قريبي أن يحمل علماً،
فتناوله ومشى خطوتين، ثم عنّ على باله أن يفتحه، فوجده علم الحزب، وكان يظنُّه علم
الوطن، فرفع ببصره إلى السماء وراح يصفِّر، وهو يلف العلم، ثم أعاده إلى الطاولة،
وأخذ علماً آخر من أعلام الوطن، وفي هذه اللحظة التي ظنّ فيها أنه يقوم بحركته من
دون أن ينتبه إليه أحد، وجد عينين رماديتين مزروعتين في وجهٍ كحليٍّ، أو أقرب إلى
الكحلي ترمقانه من وراء نظارة، وتعلوهما قبعة فرو روسية من تلك القبَّعات التي
كنَّا نشتريها من سوق الألبسة المستعملة. كانوا يعرفون أنَّ قريبي شيوعي، وها قد
أتاهم الدليل مهرولاً بأنَّه عدوٌّ للحزب، وأنَّه رفض أن يحمل علمه، وفضَّل عليه
علم الوطن! ومن أجل ذلك استكنَّ الرعب بين ضلوع هذا الشاب المبتئس، وباتت الهواجس
تتمشَّى في عقله، بل في عظامه، وظلَّ يعيش لأكثر من سنة، وهو تحت ضغط الاعتقاد
أنَّه قاب قوسين أو أدنى من الاعتقال، لعلمه علم اليقين أنّ هذا الحزب لا يغفر ولا
يتسامح، ولا يميّز بين الصغائر والكبائر، وأنَّه يحاسب على احتمال القصد والنيَّة
كأنهما التوخي والعمد.
من
يومها حرصت كلَّ الحرص على أن أختار علم الوطن، وأن أكون حذِراً كلَّ الحذر من
العيون الرمادية المزروعة في وجوه كحلية، أو أقرب إلى اللون الكحلي.
يومها حرصت كلَّ الحرص على أن أختار علم الوطن، وأن أكون حذِراً كلَّ الحذر من
العيون الرمادية المزروعة في وجوه كحلية، أو أقرب إلى اللون الكحلي.
كنّا
نصل إلى الساحة وقد وضعنا أيدينا على خواصرنا من شدة التعب، وكانت تطالعنا صورة
ضخمة للأب القائد على كامل واجهة مبنى البريد، فنشعر بالتضاؤل، والامّحاق، أمام
هول حجمها، وشراسة الملامح الصقرية لصاحبها. كانت الحشود قادمة من المعامل
والمؤسسات والمدارس والمعاهد والجامعات والجوامع، ومن أعضاء الاتحادات والنقابات
والنوادي والجمعيات!
نصل إلى الساحة وقد وضعنا أيدينا على خواصرنا من شدة التعب، وكانت تطالعنا صورة
ضخمة للأب القائد على كامل واجهة مبنى البريد، فنشعر بالتضاؤل، والامّحاق، أمام
هول حجمها، وشراسة الملامح الصقرية لصاحبها. كانت الحشود قادمة من المعامل
والمؤسسات والمدارس والمعاهد والجامعات والجوامع، ومن أعضاء الاتحادات والنقابات
والنوادي والجمعيات!
يقول
فيكتور هيغو: “الشعب في نظر الديكتاتور حذاءٌ شديد الضيق، ويجب توسيعه
بالمسيرات”
فيكتور هيغو: “الشعب في نظر الديكتاتور حذاءٌ شديد الضيق، ويجب توسيعه
بالمسيرات”
كان
عمرنا الصغير لا يُخطِئ تغامز الطلاب الأكبر سناً، وهم يرمقون الأيدي المتشابكة
المستنيمة للطلبة والطالبات، وللأساتذة والآنسات، وللعاملين والعاملات، وللحرفيين
والحرفيات، وهم يدبكون ويصيحون ويتمايلون ويتزاحمون، وكنت أتفرَّس في الوجوه فأرى
وجوهاً ضاحكة، وأفواهاً مقهقهة، وأرى في الوقت نفسه وجوهاً مكفهرَّة مرهَقة،
وأفواهاً مزمومة مطبقة. كان الهتاف الهادر الذي يجرح الحناجر (بالروح بالدم نفديك
يا حافظ)، و(حيِّدوا نحن البعثية حيِّدوا…… وحافظ أسد بعد ألله منعبدوا)،
و(حلَّك يا ألله حلَّك….. حافظ يبرك محلك) و(إلى الأبد. إلى الأبد. يا حافظ
الأسد) يجعلني مُذَلاً مهاناً، فأبكي بكاءً مُرّاً مكتوماً، وكنت أتساءل في سري:
ألا يعلمون أنَّ حافظ الأسد هو عدوي الذي انتشل مني ابنَيْ خالتي الأحبّ إلى قلبي،
فأودعهما سجن تدمر، وأنَّه هو المسؤول الأول عن انفجار الشريان الأبهر لخالتي نجاح
التي توفيت قهراً وحسرة على وحيدها بُعيد اعتقاله واغتياله. وكنت أنظر إلى اللوحة
القماشية الهائلة حين يموّجها الهواء فأجد بعض العزاء في تشوِّه ملامح القائد
الخالد، وكأنَّ لقوةً أصابته، أو فالجاً نصفياً ضربه، أو كأنَّ لكمة صعقت إحدى
عينيه فعورتها، وأزاحتها عن مكانها. وأتذكر، حينئذٍ، دعاء زوج خالتي: “إلهي!
بيّضْ عينيه، وسوِّد وجهه”. فأتبسم أولاً، ثم أضحك ثانياً، ثم أرقص وأدبك مع
الراقصين والدابكين، بكامل النشوة والسعادة.، ولكن بسبب مختلف، وعلة مغايرة، وفي
هذا بعض عزاء وسلوى، لطفل جريح ومكلوم!
عمرنا الصغير لا يُخطِئ تغامز الطلاب الأكبر سناً، وهم يرمقون الأيدي المتشابكة
المستنيمة للطلبة والطالبات، وللأساتذة والآنسات، وللعاملين والعاملات، وللحرفيين
والحرفيات، وهم يدبكون ويصيحون ويتمايلون ويتزاحمون، وكنت أتفرَّس في الوجوه فأرى
وجوهاً ضاحكة، وأفواهاً مقهقهة، وأرى في الوقت نفسه وجوهاً مكفهرَّة مرهَقة،
وأفواهاً مزمومة مطبقة. كان الهتاف الهادر الذي يجرح الحناجر (بالروح بالدم نفديك
يا حافظ)، و(حيِّدوا نحن البعثية حيِّدوا…… وحافظ أسد بعد ألله منعبدوا)،
و(حلَّك يا ألله حلَّك….. حافظ يبرك محلك) و(إلى الأبد. إلى الأبد. يا حافظ
الأسد) يجعلني مُذَلاً مهاناً، فأبكي بكاءً مُرّاً مكتوماً، وكنت أتساءل في سري:
ألا يعلمون أنَّ حافظ الأسد هو عدوي الذي انتشل مني ابنَيْ خالتي الأحبّ إلى قلبي،
فأودعهما سجن تدمر، وأنَّه هو المسؤول الأول عن انفجار الشريان الأبهر لخالتي نجاح
التي توفيت قهراً وحسرة على وحيدها بُعيد اعتقاله واغتياله. وكنت أنظر إلى اللوحة
القماشية الهائلة حين يموّجها الهواء فأجد بعض العزاء في تشوِّه ملامح القائد
الخالد، وكأنَّ لقوةً أصابته، أو فالجاً نصفياً ضربه، أو كأنَّ لكمة صعقت إحدى
عينيه فعورتها، وأزاحتها عن مكانها. وأتذكر، حينئذٍ، دعاء زوج خالتي: “إلهي!
بيّضْ عينيه، وسوِّد وجهه”. فأتبسم أولاً، ثم أضحك ثانياً، ثم أرقص وأدبك مع
الراقصين والدابكين، بكامل النشوة والسعادة.، ولكن بسبب مختلف، وعلة مغايرة، وفي
هذا بعض عزاء وسلوى، لطفل جريح ومكلوم!
يقول
فيكتور هيغو: “الشعب في نظر الديكتاتور حذاءٌ شديد الضيق، ويجب توسيعه
بالمسيرات”. وفعلاً ما زال شطر الشعب السوري اليوم القابع تحت سلطة الأسد
يتوسَّع إلى الآن في الطرق والشوارع والساحات، وما زلنا ننتظر انتفاضه أو امتناعه،
كما انتفض الشطر الآخر وتحرَّر، أو سار في طريق التحرُّر.
فيكتور هيغو: “الشعب في نظر الديكتاتور حذاءٌ شديد الضيق، ويجب توسيعه
بالمسيرات”. وفعلاً ما زال شطر الشعب السوري اليوم القابع تحت سلطة الأسد
يتوسَّع إلى الآن في الطرق والشوارع والساحات، وما زلنا ننتظر انتفاضه أو امتناعه،
كما انتفض الشطر الآخر وتحرَّر، أو سار في طريق التحرُّر.
موقع تلفزيون سوريا