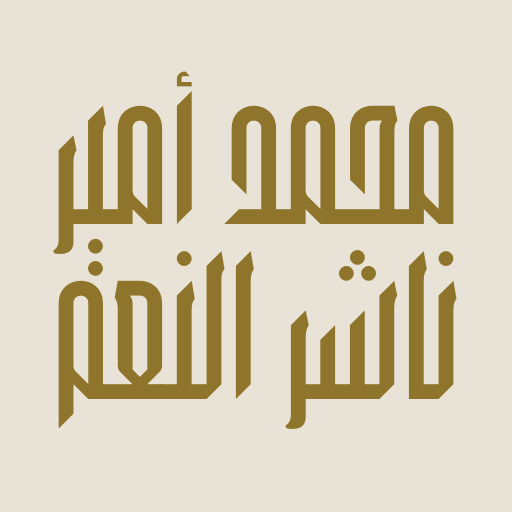درّست التربية الإسلامية في عدة مدارس، في ثانوية المتنبي، ثم في إعدادية طارق بن زياد، ثم في الثانوية الشرعية في إعزاز، ثم في الثانوية الشرعية (الخسروية)، وأخيرا في مدرسة (قادمون) في إسطنبول، وعلى مدار هذه السنوات العديدة لم أصفع سوى طالبين:
أما الأول: فكان طالب بكالوريا ادبي في سنة 1992 في أول سنة تدريس لي في مدرسة المتنبي.
لاحظ ذلك الطالب ان الفارق العمري بيني وبين الطلاب ما بين سنتين إلى أربع سنوات، فحفزه ذلك لأول سؤال:
— أستاذ؟؟ أنت بعمرنا؟ أم نحن أكبر منك ؟
وبدأت الحصة، وبدأت تعليقاته التي غدا من خلالها يتسلق جبل الميوعة، وكان كلما علّق على كلامي ارتقى في ذلك الجبل أكثر، واطردت تعليقاته إلى أن رأيته وقد استوى على ذروة ذلك الجبل، ووقف على قمة شاهقة من قممه، فما عاد يصل إليه صوت الأستاذ، ولا معنى كلامه، فرأيت أن صفعةً قوية ملائمة محكمة قمينة أن تطيح به من تلك القمة التي قطعت عنه أوكسجين الفهم والتعقل، وأن تعيده إلى أرض الطلاب الطبيعية العادية، فكانت تلك الصفعة فعلاً كعنوان كتاب ابن القيم (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)، ويومها لم يرف لي جفن من تأنيب ضمير، ولم يخالجني أدنى توجس من تلك الصفعة.
وأما الثاني: فكان طالباً في الصف السادس الابتدائي في مدرسة قادمون في إسطنبول، وأشاعت صفعتي المخمسة في تلك اللحظة جواً من الرهبة والوجوم في نفوس الطلاب، ثم اشاعت في اللحظة الثانية حزناَ وإحباطاً وتأنيب ضمير في نفسي!! أوَ يعقل أن اضرب طفلاً في الصف السادس؟؟ إنها منقصة لا تُغتفر! كيف أفقد تماسكي؟ وكيف تخونني حكمتي فأعالج الموقف بهذه الطريقة البدائية؟ وكيف أخلق جوا من الرهبة والوجوم في صفي؟ صفي الذي يجب أن يكون واحة متعة ، وروضة بهجة؟ ؟ أما في اللحظة الثالثة فقد ارتسمت في مخيلتي صورة أهله وقد جاؤوا في اليوم التالي متنمرين متذمرين محتجين على قسوة أستاذ الديانة الذي صفع وحيدهم بلا رأفة ولا شفقة.
أنهيت دوامي، وفي الطريق إلى البيت كانت صورة الأبوين المتخيلة تلوح لي بين الفينة والأخرى، وأتخيل ذلك الشعاع المزري الذي سيخرج من عيونهما ليجتاحني، وهما يبثان الإدارة الاتهام والشكوى. وحُق لهما ذلك فقد جعل الله لهما سلطاناً نصيراً، بما اقترفته وجنيته، وعادت بي الذكرى قبل سنتين إلى لقائي بأستاذ ابني الذي كانت جريرته دون جنايتي، يوم ذهبت إلى المدرسة، وطلبت من المدير أن يجمعني مع معلمه، لأن في فمي شكاية يجب أن أبثها! حاول المدير أن يعرف شكواي، ولكني رفضت إخباره إلا في حضور المعلم…. وعندما جاء المعلم سألته سؤالاً واحداً فقط:
— هل شاهدت جحشاً في حياتك عيناه زرقاوان؟ استغرب المدير والمعلم من سؤالي! ولكنني أعدت السؤال:
— هل شاهدت يا أستاذ في حياتك جحشاً عيناه زرقاوان ؟
أجابني الاستاذ: لا.
فقلت له: إن عيني ابني محمود زرقاوان، وأنت ناديته بلفظ الجحش مرتين البارحة!! وقمت مغادراً وسط ضحك المدير، وذهول الأستاذ.
ولما وصلت إلى البيت سألت نفسي: هل يتوجب علي أن أقلق من اللقاء المرتقب في اليوم التالي ؟
وكان الجواب: إطلاقاً.
فقد تمرّست على مدار السنوات السابقة أن أبني جُدر حماية تقيني جميع صنوف القلق مهما اشتد، ولو بلغ درجة الإعصار، جدراً من المكابرة والترفع واللامبالاة والسخرية والاستهزاء، ولكن في هذه المرة كان جداري هو (الاعتراف)، وبمجرد أن مرت هذه الكلمة على خاطري سكبت على رأسي وقلبي دلواً من الراحة والاطمئنان. نعم عندما سيأتي الاهل غداً. سأستحضر روحانية المسيح الوديعة، ونفسيته المتطامنة. لن أكابر، ولن ألفّق، ولن أسوِّغ. لقد صفعت ابنكم الحبيب، فآلمته وآلمتكم، ولكنني ألمت نفسي أيضاً. أما بقية الكلام فسأتركه للارتجال. يكفي أنني بنيت إستراتيجية اللقاء.
.
.
دلفت في اليوم الثاني إلى المدرسة، وأنا أتوقع أن أرى الأبوين أمامي على بابها، ولكن مضى الاجتماع الصباحي، ثم الحصة الأولى، فالثانية، فالفرصة، فالحصة الثالثة، ولم يأت أحد، وكنت خلال هذه الفترة قد وطّنت نفسي على أن يقرع الآذن الباب، ويطلبني للإدارة، ولكن هذا ما لم يحدث.
دق جرس الحصة الرابعة، وكانت ساعة فراغ لي، فخرجت من الصف ميمماً وجهي شطر غرفة المدرسين، ومن بعيد شاهدت ذلك الطالب يدخل غرفة الإدارة مع والديه. جلست في الغرفة أنتظر أن ينادى عليّ لمقابلة الأهل، ومرت الدقائق تلو الدقائق ولم يحصل ذلك، وبعد ربع ساعة دخل زميلي الأستاذ عزمي مدرس الديانة للمرحلة الثانوية، وكان لطيفاً سمحاً جمع طيبة أهالي حمص كلهم في إهابه. دخل وهو يحوقل ويحسبل، ويقول: يا أخي والله العظيم لم أصفع الولد!! صدقاً لم أصفعه!!
سألته: خير يا أستاذ ؟ خير؟
— يا أستاذ أمير البارحة غاب أستاذ العلوم عن طلاب الصف السادس، فطلب الموجه مني على سبيل الموانة أن أغطي الحصة. واليوم جاء أبوا الطالب حناوي يدّعيان أنني صفعت ابنهما صفعة لئيمة تركت أثرها على وجهه طوال البارحة.
أمسكت ضحكتي التي تفجرت في داخلي، وحجزتها بسد من الضبط والتحكم، وقلت له برزانة جليدية:
— الله يسامحك يا أستاذ! أعرفك لطيفا مع الطلاب! لم اعهدك عنيفا معهم يوما!!
فأجابني وقد زاد انفعاله، وتهدّج صوته:
— يا أستاذ لم أصفعه! لم أصفعه. وإن كان هذا الولد يستأهل الفلقة، وليس الصفع فقط. لقد أقسمت لهم في الإدارة أنني لم أصفعه.
— حسبنا الله ونعم الوكيل. إن أستاذ الديانة مضطهد دائما!! لماذا لم يتهموا أستاذ الإنكليزي؟ أو أستاذ الرياضيات، أو أستاذ الفيزياء!!؟؟ لماذا يتهمون أستاذ الديانة؟ حقاً إنك تشعر بأن هنالك مؤامرة دائمة على أستاذ الديانة. مؤامرة حيكت في الوطن، وتلاحقنا ذيولها في الشتات والمهجر.
— فعلا يا أستاذ! تصور أنّ والده قال لي: إن ابني لا يكذب!! لقد جعلني انتفض وأغضب، حتى إني رفعت إصبعي في وجهه قائلا: عيب عليك أن تقول لي هذا الكلام، وكأنني أنا من يكذب!!
— وبماذا أجاب الأب؟
— خفف من نبرته ، واعتذر مني، وقال لي إنه لم يقصد ذلك.
لقد تضارب في نفس تلك اللحظة يقينان ثابتان. يقين الأبوين اللذين شاهدا آثار الصفعة على خد ابنهما ، ويقين الأستاذ الذي يعرف أنه لم يصفع الولد، ولكن في مثل هذه الحالة من التصادم الثقيل وجهاً لوجه فإن كلا اليقينين يتزعزعان.
أما الوالدان فبدأا يشكان في احتمالات أخرى، كأن يكون ابنهما قد وقع في مشاجرة، ثم نسب الصفعة إلى الأستاذ مثلاً.
وأما الأستاذ فبدأ يراجع ذاكرته: هل يُعقل أنه ضربه على رقبته ضربة خفيفة، فضخّمها الولد وجعلها صفعة تطاير شررها؟
سألته: هل ذهب الوالدان ؟
— نعم ذهبا.
وعندئذ لم أشأ أن أطيل حيرة الأستاذ أكثر من ذلك، فنهضت، وأمسكت يده، وقلت له: إلى الإدارة معي.
وفي الإدارة بدلا من أن أدخل كالمسيح متطامناً كما كنت أنوي دخلت كغوّار الطوشة، وأعلنت لهم أن الأستاذ عزمي بريء من هذه الصفعة براءة نظامنا من الفهم والإنسانية، وأنني أنا الصافع الباتع، ووسط جلبة ضحك الحضور وقعقعتها قال لي المدير: لقد صرف الله عنك لقاء الأبوين، و حقاً تنطبق عليك آية: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا)، وهنا خرج الأستاذ عزمي من ذهوله مستنكراً أن يدافع الله عن الذين آمنوا بأن يلبسها لمؤمنين آخرين، وقال: إذا كان الله يدافع عن الذين آمنوا فإيش أنا ؟ من الذين كفروا؟ ؟ فقلت له: بل أنت من جماعة (اشدكم بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل) وأنت أمثلنا.
وتحول ذلك اليوم الذي كنت أحضّر فيه نفسي لأعصب على رأسي خرقةً تقيني وهج حرارة شمس السين والجيم التي ساتعرض لها في صحراء تلك المقابلة، فإذا بي اسبح في بحيرة استوائية صافية مستمتعا بالوقوف انا ومعظم الأساتذة تحت شلال من الضحك بهيج منعش.
محمد أمير ناشر النعم