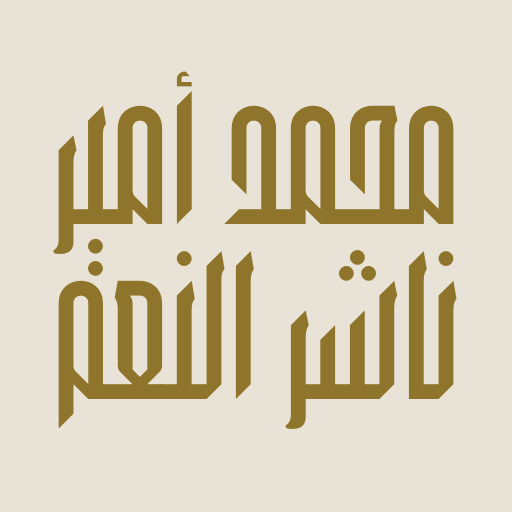قطع الرؤوس على
سبيل الروتين:
سبيل الروتين:
كانت المشانق والمقاصل
الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تُنصب لأتفه سبب، وأخرق ذريعة حيث
وصل التشدّد في تنفيذ عقوبة الإعدام إلى درجة رفْض اللورد المستشار الإنكليزي
إلينبورو سنة 1813 إلغاءها لسرقة ما يصل إلى خمسة شلنات!
فارتاع لذلك بعض الأدباء والمفكرين، وحاذروا أن تتكاثر تلك الأعواد، وأن تتحوّل
إلى غابة سرطانية تعمّ أرجاء القارّة، فبادروا بفؤوسهم الفكرية والبلاغية يصرمونها
ويجتثونها.
الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تُنصب لأتفه سبب، وأخرق ذريعة حيث
وصل التشدّد في تنفيذ عقوبة الإعدام إلى درجة رفْض اللورد المستشار الإنكليزي
إلينبورو سنة 1813 إلغاءها لسرقة ما يصل إلى خمسة شلنات!
فارتاع لذلك بعض الأدباء والمفكرين، وحاذروا أن تتكاثر تلك الأعواد، وأن تتحوّل
إلى غابة سرطانية تعمّ أرجاء القارّة، فبادروا بفؤوسهم الفكرية والبلاغية يصرمونها
ويجتثونها.
المؤسِّس سيزاري
بيكاريا:
بيكاريا:
وكان أول
الداعين لإلغاء هذه العقوبة الإيطالي سيزاري
بيكاريا (1738 ــ 1794) الأب
المؤسّس للقانون الجنائي، وصاحب مقولة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ
قانوني”، الذي كتب بالإيطالية أطروحته المؤسّسة عن (الجرائم والعقوبات) سنة 1764، واحتج
بكامل الضراوة على:
الداعين لإلغاء هذه العقوبة الإيطالي سيزاري
بيكاريا (1738 ــ 1794) الأب
المؤسّس للقانون الجنائي، وصاحب مقولة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ
قانوني”، الذي كتب بالإيطالية أطروحته المؤسّسة عن (الجرائم والعقوبات) سنة 1764، واحتج
بكامل الضراوة على:
ــ التعذيب للحصول على
اعترافات.
اعترافات.
ــ والاتهامات السرّية.
ــ والسلطة التقديرية
التعسفية للقاضي، إذ ينبغي عليه تطبيق القانون لا صنعه.
التعسفية للقاضي، إذ ينبغي عليه تطبيق القانون لا صنعه.
ــ وعدم المساواة في إصدار
الأحكام.
الأحكام.
ــ واستخدام الصلات الشخصية
للحصول على عقوبة أخف.
للحصول على عقوبة أخف.
ــ واستخدام عقوبة الإعدام
في جرائم خطيرة وأخرى بسيطة.
في جرائم خطيرة وأخرى بسيطة.
وأدان صراحةً في تلك
الأطروحة التي كتبها وهو لم يتجاوز السادسة والعشرين، عقوبة الإعدام لسببين:
الأطروحة التي كتبها وهو لم يتجاوز السادسة والعشرين، عقوبة الإعدام لسببين:
أولاً: لأن الدولة لا تملك الحق في إزهاق
الأرواح.
الأرواح.
ثانياً: لأن عقوبة الإعدام ليست مفيدة أو
ضرورية.
ضرورية.
لكنّ دعوته لإلغاء هذه
العقوبة لم تكن موطأة الأكناف على الإطلاق، فقد عاصر دعاةً ومؤيدين لها يكفي النطق
بذكر أسمائهم ليقف الإنسان في وجل وتهيّب من معارضتهم فضلاً عن مقارعتهم. فأما جان
جاك روسّو فرأى في الجريمة نوعاً من إعلان الحرب ضد الوطن الأم والجنس البشري،
لذلك وجب معاقبة المجرم، وفي أقصى الحالات معاقبته بالموت. وأما كانط فقرّر أنّ
عقوبة الإعدام هي التكفير المناسب الوحيد عن القتل: “إذا قَتل فيجب أن
يموت”، وأما لوك فقال: “يجب أن نعامل المجرمين كالحيوانات
المفترسة”، وكذلك رأى هيجل أنّ عقوبة الإعدام هي الكفّارة الوحيدة للقتل. غير
أنّ سيزاري بيكاريا لم يكن أقل صلادة من هؤلاء! فجادل في الغاية من هذه العقوبة:
العقوبة لم تكن موطأة الأكناف على الإطلاق، فقد عاصر دعاةً ومؤيدين لها يكفي النطق
بذكر أسمائهم ليقف الإنسان في وجل وتهيّب من معارضتهم فضلاً عن مقارعتهم. فأما جان
جاك روسّو فرأى في الجريمة نوعاً من إعلان الحرب ضد الوطن الأم والجنس البشري،
لذلك وجب معاقبة المجرم، وفي أقصى الحالات معاقبته بالموت. وأما كانط فقرّر أنّ
عقوبة الإعدام هي التكفير المناسب الوحيد عن القتل: “إذا قَتل فيجب أن
يموت”، وأما لوك فقال: “يجب أن نعامل المجرمين كالحيوانات
المفترسة”، وكذلك رأى هيجل أنّ عقوبة الإعدام هي الكفّارة الوحيدة للقتل. غير
أنّ سيزاري بيكاريا لم يكن أقل صلادة من هؤلاء! فجادل في الغاية من هذه العقوبة:
ــ هل هي (الثأر والانتقام)؟
حيث يؤكد النهج الانتقامي على أنّ العقوبة يجب أن تكون مساوية للضرر الذي يحدث إما
حرفياً بطريقة (العين بالعين)، وإما مجازياً على سبيل أشكال بديلة من التعويض.
حيث يؤكد النهج الانتقامي على أنّ العقوبة يجب أن تكون مساوية للضرر الذي يحدث إما
حرفياً بطريقة (العين بالعين)، وإما مجازياً على سبيل أشكال بديلة من التعويض.
ــ أم هي (النفع) الذي يمثّل
الدفاعَ عن العقد الاجتماعي لضمان تحفيز الجميع على الالتزام به؟ ومن هنا وجب أن
تكون طريقة العقوبة المختارة تخدم المصلحة العامة خدمة حقيقية.
الدفاعَ عن العقد الاجتماعي لضمان تحفيز الجميع على الالتزام به؟ ومن هنا وجب أن
تكون طريقة العقوبة المختارة تخدم المصلحة العامة خدمة حقيقية.
إنّ الغاية من العقوبة بحسب
بيكاريا هي النفع لا الانتقام، ولا يكون ذلك إلا إذا غدا العقاب مأتى لإصلاح
المجرم، ووسيلة لجعله عاجزاً عن تكرار جريمته، ومدعاةً لردع الآخرين عن ارتكابها.
وفي عقوبة الإعدام ينتفي صلاح المجرم، لأنَّنا نقتله، ولا يتحقق ردع الآخرين، لبعد
المسافة بين الجريمة وتنفيذ العقوبة بسبب طول المحاكمات ودرجات التقاضي.
بيكاريا هي النفع لا الانتقام، ولا يكون ذلك إلا إذا غدا العقاب مأتى لإصلاح
المجرم، ووسيلة لجعله عاجزاً عن تكرار جريمته، ومدعاةً لردع الآخرين عن ارتكابها.
وفي عقوبة الإعدام ينتفي صلاح المجرم، لأنَّنا نقتله، ولا يتحقق ردع الآخرين، لبعد
المسافة بين الجريمة وتنفيذ العقوبة بسبب طول المحاكمات ودرجات التقاضي.
ويبرهن على ذلك بنظرية الفهم الترابطي،
فعندما تتبع العقوبة جريمة ما بسرعة، فإن فكرتَي (الجريمة) و (العقوبة) تكونان
أكثر ارتباطًا في ذهن الشخص.
أما إذا طال الأمد عليهما فإنّ الارتباط يضعف ويذوي، وهكذا تفقد
العقوبة قوة دلالتها على الردع والوزْع.
فعندما تتبع العقوبة جريمة ما بسرعة، فإن فكرتَي (الجريمة) و (العقوبة) تكونان
أكثر ارتباطًا في ذهن الشخص.
أما إذا طال الأمد عليهما فإنّ الارتباط يضعف ويذوي، وهكذا تفقد
العقوبة قوة دلالتها على الردع والوزْع.
ترك بيكاريا أثراً عميقاً في
الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، وترك أثراً أكبر في دوقية توسكانا
الكبرى في إيطاليا التي كانت أول حاضرة في أوروبا تلغي عقوبة الإعدام، وترك أثراً
عظيماً في المفكرين المعاصرين واللاحقين، وعلى رأسهم فولتير الذي كتب تعليقات على
الترجمة الفرنسية لكتابه (الجرائم والعقوبات) بعد سنتين من نشره بلغته الأم، ومع
الأسف فإنّ هذا الكتاب العظيم لم يُترجم للعربية.
الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، وترك أثراً أكبر في دوقية توسكانا
الكبرى في إيطاليا التي كانت أول حاضرة في أوروبا تلغي عقوبة الإعدام، وترك أثراً
عظيماً في المفكرين المعاصرين واللاحقين، وعلى رأسهم فولتير الذي كتب تعليقات على
الترجمة الفرنسية لكتابه (الجرائم والعقوبات) بعد سنتين من نشره بلغته الأم، ومع
الأسف فإنّ هذا الكتاب العظيم لم يُترجم للعربية.
المجالد فيكتور
هيغو:
هيغو:
أما إسهام فيكتور هيغو (1802 ــ 1885) في تحطيب
المشانق وتحطيمها فكان أشمل وأوسع بالقياس إلى بيكاريا، وإلى بقية زملائه من الشعراء
والأدباء الذين نادوا بإلغاء هذه العقوبة. فقد شاءت المقادير أن يعبر فيكتور هيغو
عام 1828 ميدان المقصلة، ليشاهد إجراء الاستعدادات النهائية لإعدامٍ هناك. شاهد
الجلاد يقوم بتجربة أداء استعداداً ليوم الغد، فأثّر هذا المشهد في نفسه أبلغ
التأثير، وانكبّ في صباح اليوم التالي على طاولته وشرع يكتب روايته المونودرامية (آخر
يوم لمحكوم بالإعدام) التي ستظهر سنة 1829، وسوف يسجّل فيها على لسان هذا المحكوم، وهو ينتظر في زنزانته
نهايته المرعبة، ملاحظاته وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه، وسيستثير تعاطفنا إلى أبعد
مدى حين يحدّثنا عن أمه وزوجته وطفلته الصغيرة الحلوة الوردية اللون الضعيفة
البنيان: “سوف يكون هنالك بعد موتي ثلاث نساء: واحدة منهنّ بغير ابن،
والثانية بغير زوج، والثالثة بلا أب. ثلاث أرامل باسم القانون“. وحتى لا
يخدش هيغو هذا التعاطف فإنه يُبهم اسم الرجل، ولا يذكر قضيته التي حُكم من أجلها.
المشانق وتحطيمها فكان أشمل وأوسع بالقياس إلى بيكاريا، وإلى بقية زملائه من الشعراء
والأدباء الذين نادوا بإلغاء هذه العقوبة. فقد شاءت المقادير أن يعبر فيكتور هيغو
عام 1828 ميدان المقصلة، ليشاهد إجراء الاستعدادات النهائية لإعدامٍ هناك. شاهد
الجلاد يقوم بتجربة أداء استعداداً ليوم الغد، فأثّر هذا المشهد في نفسه أبلغ
التأثير، وانكبّ في صباح اليوم التالي على طاولته وشرع يكتب روايته المونودرامية (آخر
يوم لمحكوم بالإعدام) التي ستظهر سنة 1829، وسوف يسجّل فيها على لسان هذا المحكوم، وهو ينتظر في زنزانته
نهايته المرعبة، ملاحظاته وأفكاره ومشاعره وأحاسيسه، وسيستثير تعاطفنا إلى أبعد
مدى حين يحدّثنا عن أمه وزوجته وطفلته الصغيرة الحلوة الوردية اللون الضعيفة
البنيان: “سوف يكون هنالك بعد موتي ثلاث نساء: واحدة منهنّ بغير ابن،
والثانية بغير زوج، والثالثة بلا أب. ثلاث أرامل باسم القانون“. وحتى لا
يخدش هيغو هذا التعاطف فإنه يُبهم اسم الرجل، ولا يذكر قضيته التي حُكم من أجلها.
وستغدو هذه الرواية من أهم نصوص الدعوة لإلغاء هذه العقوبة. وستُحدث ضجة في
أوروبا، وسيبدأ الناس يفكرون جدياً في فظاعتها، وفي مراسيمها الشنيعة. يقول
المحكوم بالإعدام: “فلأكتب مذكراتي! فقد تجعلهم قراءة هذه المذكرات أقل
تسرّعاً، وتحملهم على شيء من التروي في المستقبل عندما يكون الأمر متعلقاً بإسقاط
رأس يفكر” (1).
أوروبا، وسيبدأ الناس يفكرون جدياً في فظاعتها، وفي مراسيمها الشنيعة. يقول
المحكوم بالإعدام: “فلأكتب مذكراتي! فقد تجعلهم قراءة هذه المذكرات أقل
تسرّعاً، وتحملهم على شيء من التروي في المستقبل عندما يكون الأمر متعلقاً بإسقاط
رأس يفكر” (1).
غير أنّ هيغو لم يكن ليكتفي بمجرد استثارة العواطف، وتأجيج المشاعر، ففي
طبعة لاحقة للرواية يكتب مقدمة ضافية، فيناقش ويحاجج، ويدحض ويفنّد. يضع حجج مؤيدي
العقوبة وداعميها على طاولة التشريح، ويُعمل مبضعه بكل إتقان وحصافة:
طبعة لاحقة للرواية يكتب مقدمة ضافية، فيناقش ويحاجج، ويدحض ويفنّد. يضع حجج مؤيدي
العقوبة وداعميها على طاولة التشريح، ويُعمل مبضعه بكل إتقان وحصافة:
الحجة الأولى: من الضروري أن
نبتر من المجتمع عضواً قد أساء إليه من قبل، وقد يسيء إليه بعد ذلك.
نبتر من المجتمع عضواً قد أساء إليه من قبل، وقد يسيء إليه بعد ذلك.
والجواب: إذا كان الأمر مقصوراً على
ذلك فالسجن يكفي، فلماذا الموت إذن؟ ليس ثمة ما يدعو إلى الجلاد فالسجان يكفي.
ذلك فالسجن يكفي، فلماذا الموت إذن؟ ليس ثمة ما يدعو إلى الجلاد فالسجان يكفي.
الحجة الثانية: إنّ المجتمع
يجب أن يثأر لنفسه، وأن يعاقب المجرم.
يجب أن يثأر لنفسه، وأن يعاقب المجرم.
والجواب: كلا! لا هذا ولا ذاك. فالثأر
شيء فردي خاص، وأما العقاب فبيد الله، والمجتمع بين اثنين: بين (الثأر) وهو شأن
شخصي جداً، وهو أقلّ من المجتمع، لأنّه أمر فردي، وبين (العقاب) وهو فوق المجتمع،
لأنّه بيد الله. الأول صغير للغاية، والثاني كبير للغاية، وكلاهما لا يلائمان
المجتمع، ومن واجب المجتمع ألا يعاقب لينتقم، بل أن يعاقب ليصلح ويصل إلى ما هو
أحسن.
شيء فردي خاص، وأما العقاب فبيد الله، والمجتمع بين اثنين: بين (الثأر) وهو شأن
شخصي جداً، وهو أقلّ من المجتمع، لأنّه أمر فردي، وبين (العقاب) وهو فوق المجتمع،
لأنّه بيد الله. الأول صغير للغاية، والثاني كبير للغاية، وكلاهما لا يلائمان
المجتمع، ومن واجب المجتمع ألا يعاقب لينتقم، بل أن يعاقب ليصلح ويصل إلى ما هو
أحسن.
الحجة الثالثة: وهي أكثر
الحجج استخداماً وتواتراً على ألسنة ممثّلي الاتهام في (النيابات العامة). يجب أن
يُضرب المثل الرادع، ويجب الإرهاب بمنظر المصير الذي ينتظر المجرمين، ونلقي به
الخوف في قلوب الذين يميلون إلى محاكاتهم.
الحجج استخداماً وتواتراً على ألسنة ممثّلي الاتهام في (النيابات العامة). يجب أن
يُضرب المثل الرادع، ويجب الإرهاب بمنظر المصير الذي ينتظر المجرمين، ونلقي به
الخوف في قلوب الذين يميلون إلى محاكاتهم.
والجواب: إننا ننكر أنّ هنالك مثلاً
وعبرة في العقوبة، وننكر أنّ منظر التعذيب والقتل يأتي بالنتيجة المرجوّة منه، فهو
بدلاً من أن يهذّب الشعب يضعف من روحه المعنوية، ويقتل لديه كل شعور، وبالتالي كل
فضيلة.
وعبرة في العقوبة، وننكر أنّ منظر التعذيب والقتل يأتي بالنتيجة المرجوّة منه، فهو
بدلاً من أن يهذّب الشعب يضعف من روحه المعنوية، ويقتل لديه كل شعور، وبالتالي كل
فضيلة.
ويسوق هيغو لدحض الحجة الأخيرة هذه الواقعة من بين ألف واقعة مماثلة:
“منذ عشرة أيام فقط، في يوم 5 مارس الماضي، يوم المهرجان حدث في مدينة (سان بول) عقب إعدام رجل
يدعى (لويس كامي) مباشرة، وكان قد ارتكب جريمة حريق، حدث أن جاء نفر من الملثّمين
ليرقصوا حول المشنقة، وهي لا تزال ساخنة، وكان ذلك في يوم من أيام الأعياد
المسيحية! فاضربوا المثل إذاً التماساً للعبرة”!
“منذ عشرة أيام فقط، في يوم 5 مارس الماضي، يوم المهرجان حدث في مدينة (سان بول) عقب إعدام رجل
يدعى (لويس كامي) مباشرة، وكان قد ارتكب جريمة حريق، حدث أن جاء نفر من الملثّمين
ليرقصوا حول المشنقة، وهي لا تزال ساخنة، وكان ذلك في يوم من أيام الأعياد
المسيحية! فاضربوا المثل إذاً التماساً للعبرة”!
لقد كانت هذه الرواية أول
عمل نثري يكتبه هيغو، وكان في سنٍّ مماثلة لسيزاري بيكاريا حين كتب (الجرائم
والعقوبات)، وقد أمدّه بالصيت والجرأة والأهلية ليخاطب الملوك والحكومات
والبرلمانات ويدعوهم للعفو عن أناس هم قاب قوسين أو أدنى من المشنقة، وأن يحقق
نتائج طيبة، وأن ينادي بإلغاء هذه العقوبة بالكلية من مواد القانون، وأن تستجيب
دول عديدة.
عمل نثري يكتبه هيغو، وكان في سنٍّ مماثلة لسيزاري بيكاريا حين كتب (الجرائم
والعقوبات)، وقد أمدّه بالصيت والجرأة والأهلية ليخاطب الملوك والحكومات
والبرلمانات ويدعوهم للعفو عن أناس هم قاب قوسين أو أدنى من المشنقة، وأن يحقق
نتائج طيبة، وأن ينادي بإلغاء هذه العقوبة بالكلية من مواد القانون، وأن تستجيب
دول عديدة.
كانت هذه الخطابات والنداءات
من أهم أعماله في منفاه الطويل الذي قارب على العشرين سنة في الطرف المقابل لفرنسا
من بحر المانش، وقد حفظ لنا كتابه (رسائل وأحاديث من المنفى) العديد منها، ويحسن ههنا
أن نقرأ تلك الرسالة التي حرّرها سنة 1862 إلى ملك بلجيكا إثر نشر الصحف البلجيكية قصيدة نُسبت إليه موجّهة
إلى ملك البلجيكيين يُلتمس بها العفو عن تسعة من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية
اشتُهرت باسم (شارلروا).
من أهم أعماله في منفاه الطويل الذي قارب على العشرين سنة في الطرف المقابل لفرنسا
من بحر المانش، وقد حفظ لنا كتابه (رسائل وأحاديث من المنفى) العديد منها، ويحسن ههنا
أن نقرأ تلك الرسالة التي حرّرها سنة 1862 إلى ملك بلجيكا إثر نشر الصحف البلجيكية قصيدة نُسبت إليه موجّهة
إلى ملك البلجيكيين يُلتمس بها العفو عن تسعة من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية
اشتُهرت باسم (شارلروا).
“سيدي! اليوم أتاني أحد
الأصدقاء بصحف تحوي أشعاراً جميلة تتضمن التماساً بالعفو عن تسعةٍ من المحكوم
عليهم بالإعدام، ورأيت توقيعي بأسفل هذه الأشعار! هذه الأشعار ليست أشعاري، وأياً
كان مؤلف هذه الأشعار فإنّي أشكره، فعندما يتعلق الأمر بإنقاذ رؤوس آدمية أرى من
الخير أن يستخدم الناس اسمي”. ثم يستفيض هيغو في تبيان شرور حكم الإعدام إلى
أن ينهي رسالته بقوله: ” تستطيع بلجيكا وهي الشعب الصغير الذي لا يكاد يكون
له وجود، تستطيع إذا أرادت بإلغائها عقوبة الإعدام أن تصبح زعيمة الأمم […].
إنّني أؤدّي واجباً بتحرير هذا الخطاب، فكن يا سيدي عوناً لي، وأعرني دعايتك من
أجل هذه المصلحة الجليلة”. ويحدثنا التاريخ أنّ هذه الرسالة أنقذت سبعة رؤوس
من التسعة.
الأصدقاء بصحف تحوي أشعاراً جميلة تتضمن التماساً بالعفو عن تسعةٍ من المحكوم
عليهم بالإعدام، ورأيت توقيعي بأسفل هذه الأشعار! هذه الأشعار ليست أشعاري، وأياً
كان مؤلف هذه الأشعار فإنّي أشكره، فعندما يتعلق الأمر بإنقاذ رؤوس آدمية أرى من
الخير أن يستخدم الناس اسمي”. ثم يستفيض هيغو في تبيان شرور حكم الإعدام إلى
أن ينهي رسالته بقوله: ” تستطيع بلجيكا وهي الشعب الصغير الذي لا يكاد يكون
له وجود، تستطيع إذا أرادت بإلغائها عقوبة الإعدام أن تصبح زعيمة الأمم […].
إنّني أؤدّي واجباً بتحرير هذا الخطاب، فكن يا سيدي عوناً لي، وأعرني دعايتك من
أجل هذه المصلحة الجليلة”. ويحدثنا التاريخ أنّ هذه الرسالة أنقذت سبعة رؤوس
من التسعة.
ما زالت الدعوة
مستمرة:
مستمرة:
إنها مسيرة حقوقية قانونية
مطردة يدعمها الأدب والفكر والشعر والفلسفة وما زال حطابو المشنقة حتى الوقت
الراهن يحتطبون ويقطعون، ولعلّ من أبرزهم بول ريكور الذي قدّم محاضرة في جنيف سنة 1957 بعنوان
(الدولة والعنف) تحدث فيها عن التداخل غير المستقر بينهما، وتناول عقوبة الإعدام
بوصفها في الجوهر أول كسر كبير في أخلاقيات الحب، وبوصفها نشازاً في الأفق المسيحي
الذي يدعو للمحبة ويحظر القتل.
مطردة يدعمها الأدب والفكر والشعر والفلسفة وما زال حطابو المشنقة حتى الوقت
الراهن يحتطبون ويقطعون، ولعلّ من أبرزهم بول ريكور الذي قدّم محاضرة في جنيف سنة 1957 بعنوان
(الدولة والعنف) تحدث فيها عن التداخل غير المستقر بينهما، وتناول عقوبة الإعدام
بوصفها في الجوهر أول كسر كبير في أخلاقيات الحب، وبوصفها نشازاً في الأفق المسيحي
الذي يدعو للمحبة ويحظر القتل.
سأتجاوز الحديث عن شخصيات
أخرى ومؤسسات ومنظمات دولية تسعى لإلغاء هذه العقوبة، وسأشير أخيراً إلى الكتاب
الصادر سنة 2016 بعنوان: (Der Weg zum Schafott: Dichter gegen die Todesstrafe) أي: (الطريق إلى المشنقة: شعراء ضد عقوبة
الإعدام)، الذي ضمّ بين دفتيه تعريفاً بإسهام ستة أدباء ومفكرين أوربيين من القرن
التاسع عشر في الدعوة إلى إلغاء عقوبة
الإعدام، وهم فيكتور هيغو وتشارلز ديكنز وويليام ثاكري وسيزاري بيكاريا
وفيودور دوستويفسكي وليو تولستوي؟
أخرى ومؤسسات ومنظمات دولية تسعى لإلغاء هذه العقوبة، وسأشير أخيراً إلى الكتاب
الصادر سنة 2016 بعنوان: (Der Weg zum Schafott: Dichter gegen die Todesstrafe) أي: (الطريق إلى المشنقة: شعراء ضد عقوبة
الإعدام)، الذي ضمّ بين دفتيه تعريفاً بإسهام ستة أدباء ومفكرين أوربيين من القرن
التاسع عشر في الدعوة إلى إلغاء عقوبة
الإعدام، وهم فيكتور هيغو وتشارلز ديكنز وويليام ثاكري وسيزاري بيكاريا
وفيودور دوستويفسكي وليو تولستوي؟
وقد نتساءل: ما الذي يدفع
محرّراً أو ناشراً ألمانياً ليقدّم هذا الكتاب؟ هل هو
مجرد عرض تأريخ أدبي في مسألة معيّنة؟ أم تسليط الضوء على نصوص يجهلها القارئ
الألماني؟ أم لتثبيت المكتسب القانوني والمنجز الحقوقي في عقل القارئ الأوروبي
وضميره ووجدانه؟
محرّراً أو ناشراً ألمانياً ليقدّم هذا الكتاب؟ هل هو
مجرد عرض تأريخ أدبي في مسألة معيّنة؟ أم تسليط الضوء على نصوص يجهلها القارئ
الألماني؟ أم لتثبيت المكتسب القانوني والمنجز الحقوقي في عقل القارئ الأوروبي
وضميره ووجدانه؟
إذا كانت كلّ
هذه الاحتمالات واردة بالقياس إلى القارئ الألماني خصوصاً، والقارئ الغربي عموماً
فإنّ حاجتنا نحن العرب لنعرف شيئاً من ذلك أمسّ وأولى. ولا سيما أن معظمنا ما زال
يعاند ويجادل الداعين إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ويقدّم الأدلة والبراهين التي
عولجت وأُجيب عنها منذ قرنين من الزمان.
هذه الاحتمالات واردة بالقياس إلى القارئ الألماني خصوصاً، والقارئ الغربي عموماً
فإنّ حاجتنا نحن العرب لنعرف شيئاً من ذلك أمسّ وأولى. ولا سيما أن معظمنا ما زال
يعاند ويجادل الداعين إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ويقدّم الأدلة والبراهين التي
عولجت وأُجيب عنها منذ قرنين من الزمان.
يقول هيغو:“إذا قُورنت كل المشانق في أوقات الأزمات السياسية
فإنّ المشنقة السياسية تكون أبشعها، وأكثرها شؤماً وأوفرها سمّاً، وأجدرها
بالإزالة على الإطلاق”.
فإنّ المشنقة السياسية تكون أبشعها، وأكثرها شؤماً وأوفرها سمّاً، وأجدرها
بالإزالة على الإطلاق”.
وإنها الكلمة الأكثر التصاقاً بنا اليوم، والأكثر تعبيراً عمّا نعانيه ونكابده.
(1) ومن غريب
المصادفات أن مترجم هذا النص إلى العربية جرجيس فتح الله حُكم بالإعدام أيام
الانقلاب البعثي في العراق سنة 1963، فذاق شعور المحكوم بالإعدام، ثم تداركته يد الألطاف فعُفي عنه.
المصادفات أن مترجم هذا النص إلى العربية جرجيس فتح الله حُكم بالإعدام أيام
الانقلاب البعثي في العراق سنة 1963، فذاق شعور المحكوم بالإعدام، ثم تداركته يد الألطاف فعُفي عنه.
محمد أمير ناشر النعم
المصدر: https://www.syria.tv/content/حطّابو-المشانق